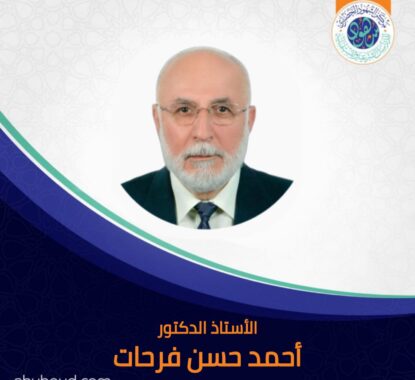بقلم أ.د. أحمد حسن فرحات(*)
سنن تاريخية:
أول ما يلاحظه الباحث في صيغة ” سُنَّة الله” القرآنية – أنها تُذْكَر وكأنها خاصَّة بسنن التاريخ، والمقصود بذلك، أنها لم تستعمل في القرآن إلا في هذا المجال، وهذا لا يعني عدم وجود سنن غيرها، ومن ثم تقترن غالباً بالإشارة إلى الأمم السابقة، كما في الآيات التالية:
﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [النساء: 26]، (سُنَّة الله)
﴿سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۚ﴾
﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ﴾ [الإسراء: 77]
﴿(سُنَّة الله) الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ [الفتح: 23]
﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ﴾ [آل عمران: 137]
﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الكهف: 55]
﴿وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الحجر: 13]
﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: 38]
﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ [فاطر: 43]
﴿سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ [غافر: 85])
وإنما قصَّ الله تعالى علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا، فنشبِّه حالنا بحالهم، ونقيس أواخر الأمم، بأوائلها، فيكون للمؤمن من المتأخرين: شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين، كما قال تعالى لما قصَّ قصة يوسف مفصلة، وأجمل قصص الأنبياء، ثم قال:
﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾ [يوسف: 111]
أي: هذه القصص المذكورة في الكتاب: ليست بمنزلة ما يفترى من القصص المكذوبة، كنحو ما يذكر في الحروب من السير المكذوبة.
وقال تعالى لما ذكر قصة فرعون: ﴿فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلۡأٓخِرَةِ وَٱلۡأُولَىٰٓ٢٥ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَة لِّمَن يَخۡشَىٰٓ﴾ -النازعات:25-26-
وقال في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع أعدائه ببدر وغيرها:
﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ -آل عمران: 13- وقال سبحانه: في شان بني النضير:
﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ -الحشر: 2-
فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا- من هذه الأمَّة، وممن قبلها من الأمم- وذكر في غير موضع: أن سنته تعالى في ذلك سُنَّة مطردة، وعادة مستمرة… وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المتأخرين، كدأب الكافرين من المستقدمين، فينبغي للعقلاء أن يعتبروا ب ” سُنَّة الله” وأيامه في عباده، ودأب الأمم وعاداتهم ([1]).
سنن التاريخ شاملة لسنن الاجتماع:
لقد قلنا إن “سُنَّة الله”- في القرآن- تكاد تكون موقوفة الاستعمال على سنن التاريخ، بناءً على ما قدمناه من الآيات الشاهدة على ذلك. ومن ثَمَّ فلابدَّ لنا من بيان
مقصو دنا- بسنن التاريخ- وأنها شاملة لسنن الاجتماع، ذلك أن سنن التاريخ مبنية على سنن الاجتماع، ومن ثم فلا يمكن الفصل بينهما.
وإذا كانت نتائج الأحداث تجري طبقاً لسنن معيَّنة، فلأن الأحداث أيضاً تجري طبقاً لسنن معيَّنة، ومن ثم فنحن نستفيد من سنن التاريخ، لنصنع الأحداث وفقاً للنتائج التي شهدناها – من النتائج المترتبة على أحداث سابقة – وعلى هذا فالتاريخ ليس خاصاً بالماضي، وإنما هو يشمل الحاضر، والمستقبل، بمعنى – أن سننه تنطبق على الحاضر والمستقبل- كما تنطبق على الماضي، لكن لما كان الإنسان الذي يعيش في الحاضر، لم يشهد الحاضر إلا شهوداً جزئياً، وفي مرحلة زمنية قصيرة، لا تكفي لترتب النتائج على الأسباب- وكذلك المستقبل بالنسبة لمن يعيش في الحاضر، فإنه غيب – لذلك كله كان توجيه القرآن النظر إلى تاريخ الأمم السابقة، وإلى الأحداث التي عاصرها المسلمون الأولون، والتي ترتبت فيها النتائج على الأسباب.
وهذا يعني أن القرآن الكريم: يقيم للتاريخ- بمعناه الواسع- اعتباراً كبيراً، فهو حصيلة التجارب الإنسانية الطويلة، ومختبر الباحثين والمحللين الذي ينبغي أن تتوجه إليه العناية، لاستفادة الدروس والعبر، واكتشاف السنن التي تحكم سير الأمم، في تطورها، وبيان دروب نموها وازدهارها، ومنحنيات انحطاطها واندثارها.
سنن الأنبياء والمتابعين لهم من أهل الإيمان:
ومن سنن التاريخ- التي حظيت في القرآن الكريم بعناية خاصَّة-: سنن الأنبياء ومن تابعهم من أهل الإيمان، ذلك أن- فترات الأنبياء التاريخية- تمثل الذرى، والقمم، التي جعلها الله سبحانه قدوة للبشرية كلها. ومن ثَمَّ قال تعالى:
﴿يريدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ -النساء: 26-.
وقد قال الطبري في تفسير هذه الآية: ” وليسددكم سنن الذين من قبلكم من أهل الإيمان بالله وأنبيائه، ومناهجهم”. ([2])
كذلك فإن سنن الأنبياء السابقين، يمكن أن تكون سنناً للأنبياء اللاحقين، ومن ثم فقد قصَّ الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآ له وسلم أخبار من سبقه من الأنبياء، ثم قال له:
﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَ ا هُمُ اقْتَدِهْ﴾ -الأنعام: 90-
كما خصَّ بعض سنن الأنبياء بالذكر، نظراً لأهميتها بالنسبة للظروف التي مرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هذه السنن: رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما فرض الله تعالى له.
وذلك حينما تحرَّج النبي صلى الله عليه وآ له وسلم من إظهار ما فرض الله له من زواج زينب، وأخفاه في نفسه، خشية مقالة الناس:
﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ -الأحزاب: 37- ([3])
فبيَّن الله تعالى في هذه الآية: أن- من سُنَّة الله في الرسل- أن لم يجعل عليهم حرجاً فيما فرض الله لهم، وأنَّ ما فرضه الله تعالى له من الزواج بزوجة متبناه “زيد” هو من هذا القبيل، وأنَّه ليس بدعاً من الرسل. وأن على الرسل دائماً أن يبلغوا رسالات الله، ولا يخشوا أحداً إلا الله، وأن عليه أن يسير على طريقتهم وسنتهم، وذلك في قوله تعالى:
﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ -الأحزاب: 38-39-
ويرى ابن تيمية أنه لم يقل هنا ” ولن تجد لسنتنا تبديلا” لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ([4]).
ولأن هذه سُنَّة شرعية، لا تُرى بالمشاهدة، بل تعلم بالوحي، بخلاف نصره للمؤمنين، وعقوبته للمنذرين، فإنه أمر مشاهد، فلن يوجد مُنْتَقِضاً.([5]).
ويلاحظ أن (سُنَّة الله) – في هذه الآية –وقوله: ﴿سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ -النساء: 26- في الآية السابقة -:
يراد بهما ما أشار إليه الراغب من معنى “سُنَّة الله”، وأنها تطلق على طريق طاعته تعالى، كما أشار إلى أن طاعته المتمثلة بفروع الشرائع، وإن اختلفت صورها، فالغرض المقصود منها، لا يختلف ولا يتبدل، وهو: تطهير النفس وترشيحها للوصول إلى ثواب الله تعالى وجواره”.
وبناءً على هذا فطريقة الطاعة هذه مرعيَّة، في كل ما شرعه الله سبحانه للأنبياء وأممهم- وإن اختلفت صورها وفروعها- علماً بأن الآية التي نتحدث عنها هنا، جاءت خاصَّة بالأنبياء، بدلالة قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ الأحزاب [38، 39]
سُنَّة الله تعالى في تعريض الرسل للاستفزاز:
ومن السنن التي يذكرها القرآن الكريم: تعريض الرسل للاستفزاز- من قبل أعدائهم- وذلك في معرض حديثه عن محاولة المشركين: استفزاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَسۡتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ لِيُخۡرِجُوكَ مِنۡهَاۖ وَإِذٗا لَّا يَلۡبَثُونَ خِلَٰفَكَ إِلَّا قَلِيلٗا٧٦ سُنَّةَ مَن قَدۡ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِن رُّسُلِنَاۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحۡوِيلًا﴾ الإسراء [76، 77]
وقد اختلف العلماء في معنى الاستفزاز – هنا -:
فقال الزجّاج حاكياً: إنَّ استفزازهم: ما أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله. والأرض – على هذا -: الدنيا ([6]) –
وروي مثل ذلك عن الحسن ([7])
وقال أبو حيان: والظاهر أن الآية تدل على مقاربة استفزازه لأن يخرجوه، فما وقع الاستفزاز ولا إخراجهم إياه المعلل به الاستفزاز.
ثم جاء في القرآن:
﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ﴾ -محمد: 13-
أي: أخرجك أهلها. وفي الحديث: “يا ليتني فيها جذعاً إذ يُخرجك قومك. قال أو مخرجي هم!!” – الحديث -.
فدلَّ ذلك على أنهم أخرجوه، لكن الإخراج الذي هو علة للاستفزاز لم يقع، فلا تعارض بين الآيتين والحديث ([8])
ولا شك أن القول الأول أولى بالقبول، لأنه لا يحتاج إلى كل هذا التكلف الذي يحاول فيه أبو حيان الجمع بين النصوص، والذي ألجأه إلى ذلك قوله بأن الاستفزاز، هو الإخراج، ولو أخذ بالقول الأول لكان له فيه عن كل ذلك غناء.
ويشهد للقول الأول قوله تعالى في شأن فرعون وبني إسرائيل:
﴿فَأَرَادَ أَن يَسۡتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ فَأَغۡرَقۡنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ جَمِيعٗا . وَقُلۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِۦ لِبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱسۡكُنُواْ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ ٱلۡأٓخِرَةِ جِئۡنَا بِكُمۡ لَفِيفٗا﴾. الإسراء [103، 104].
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما- هنا – الاستفزاز: بالاستئصال، كما فسره غيره بالخروج، إلا أن الخروج قد حصل، وذلك باجتيازهم البحر، وكان ذلك مطلب موسى عليه السلام: “أرسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم”، في حين تتحدث الآية عن إرادة الاستفزاز، وأن الغرق حال دون حصوله. مما يجعل تفسير الاستفزاز بالقتل والاستئصال متعيناً.
وليست محاولة الاستفزاز هذه خاصَّة- برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أو بموسى عليه السلام- وإنما هي محاولة عامَّة تعرَّض لها جميع الرسل- صلوات الله عليهم – وكما يُفهم من قوله تعالى:
﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ -الإسراء: 77-
ومما يوضح ذلك أيضاً قوله تعالى:
﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ -غافر: 5-.
وقد قال ابن الجوزي في تفسيره لكلمة “يأخذوه”، وفيه قولان:
أحدهما: ليقتلوه – قاله ابن عباس وقتادة.
والثاني: ليحبسوه ويعذبوه- حكاه ابن قتيبة ([9])
إلا أننا نرجّح هنا أيضاً قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي يفسر “الأخذ” بالقتل، كما رجحناه سابقاً حينما فسر ” الاستفزاز” بالاستئصال. ومما يقوي ذلك قوله تعالى في نفس الآية عن الكافرين:
﴿فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ [غافر: 5]
وهنا لا يحتمل (الأخذ) إلا معنى واحداً وهو (الإهلاك).
وهكذا نرى أن من سُنَّة الله في رسله: أن يعرضهم لاستفزاز أقوامهم، فَيحاولون قتلهم. ولكنهم لا يلبثون بعد ذلك إلا قليلاً، فيأخذهم سبحانه أخذ عزيز مقتدر
سُنَّة الله في إهلاك المكذبين:
يذكر القرآن الكريم أخبار الأمم السابقة، ومواقفها من رسلها وأنبيائها، حيث يستجيب لهؤلاء الرسل والأنبياء طائفة من الناس، في حين تقف في وجه الرسل والأنبياء طوائف أخر كافرة برسالاتهم مكذبة لهم، وقد قص الله سبحانه علينا قصصهم لنعتبر بها، ولما في الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتنا، وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول، وكانا مشتركين في المقتضى للحكم. فلولا أنَّ في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل – فرعون ومن قبله – لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط، ولكن الأمر كما قال تعالى:
﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ -فصلت: 43- وكما قال تعالى:
﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ -الذاريات: 52-
وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ -البقرة: 118- وقال تعالى: ﴿يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ -التوبة: 30-
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” لتسلكن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: اليهود والنصارى؟ قال فمن” ؟!- وكلا الحديثين في الصحيحين- ([10]).
ومن هنا نجد في القرآن الكريم دعوة صارخة إلى السير في الأرض ([11]) والنظر في آثار الأمم السابقة المكذبة والتي تشهد بصحة هذه السنن وثباتها، وذلك كما في قوله تعالى:
﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ -آل عمران: 137-.
ويشرح القرآن الكريم في آيات ومواضيع أخر: عاقبة هؤلاء المكذبين، وسُنَّة الله تعالى في إهلاكهم، وذلك كما في قوله تعالى:
﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي شِيَعِ ٱلۡأَوَّلِينَ . وَمَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ١١ كَذَٰلِكَ نَسۡلُكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ. لَا يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَقَدۡ خَلَتۡ سُنَّةُ ٱلۡأَوَّلِين﴾ الحجر [10-12]
وواضح أن هذه الآية: تهدد مشركي العرب، بأن تنفذ فيهم سُنَّة الأولين، الذين كذّبوا رسلهم فأهلكهم الله، ولقد أقسم العرب المشركون أيماناً مغلظة على أن يكونوا أهدى من اليهود والنصارى- فيما لو جاءهم رسول من عند الله- وها هو الرسول قد جاءهم، ولكنهم بدلاً من أن يستجيبوا له، إذا هم ينفرون استكباراً ومكراً. فعليهم أن ينتظروا إذن سُنَّة الأولين:
﴿وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ لَئِن جَآءَهُمۡ نَذِيرٞ لَّيَكُونُنَّ أَهۡدَىٰ مِنۡ إِحۡدَى ٱلۡأُمَمِۖ فَلَمَّا جَآءَهُمۡ نَذِيرٞ مَّا زَادَهُمۡ إِلَّا نُفُورًا . ٱسۡتِكۡبَارٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَكۡرَ ٱلسَّيِّيِٕۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلۡمَكۡرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهۡلِهِۦۚ فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلۡأَوَّلِينَۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗاۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحۡوِيلًا٤٣﴾ فاطر [42، 43]
كما أن هناك أية تغريهم بغفران ما سبق منهم- من كفر وتكذيب وحرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- فيما لو آمنوا به، وتركوا محاربته-وتهددهم بأن تسري عليهم سُنَّة الأولين إن عادوا للكفر والمحاربة:
﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: 38].
وسُنَّة الله تعالى في أخذ المكذبين: قد تكون بعذاب مباشر من الله سبحانه، كما يذكر لنا القرآن الكريم عن كثير من الأمم السابقة كعاد وثمود وقوم لوط، وقد تكون بقتال المؤمنين لهم وانتصارهم عليهم- كما حدث لمشركي العرب وغيرهم- وقد جُمع النوعان في قوله تعالى:
﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ [الكهف: 55].
قال ابن الجوزي في تفسيره ([12]):
فإن قيل: إذا كان المراد بسُنَّة الأولين العذاب، فما فائدة التكرار بقوله:
﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾؟ فالجواب: أنَّ سُنَّة الأولين أفادت عذاباً مبهماً، يمكن أن يتراخى وقته، وتختلف أنواعه. واتيان العذاب قبلاً: أفاد القتل يوم بدر. قال مقاتل: سُنَّة الأولين عذاب الأمم السابقة، أو يأتيهم العذاب قبلاً: أي عياناً قتلاً بالسيف يوم بدر.
كما أن هناك آية تطلب إلى المشركين أن يسيروا في الأرض، ويعتبروا بمصائر الأمم التي كانت أكثر منهم وأشد قوة، والتي لم تؤمن حتى رأت العذاب، وأن ذلك الإيمان لم يفدها شيئاً، وأن ما جرى لهذه الأمم: إنما هو “سُنَّة الله في عباده”:
﴿أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِنۡهُمۡ وَأَشَدَّ قُوَّةٗ وَءَاثَارٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ فَمَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ . فَلَمَّا جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ . فَلَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥ وَكَفَرۡنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشۡرِكِينَ . فَلَمۡ يَكُ يَنفَعُهُمۡ إِيمَٰنُهُمۡ لَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَاۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ فِي عِبَادِهِۦۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾. غافر [82-85]
سُنَّة الله تعالى في النصر:
أما “سُنَّة الله”- في نصر أوليائه على اعدائه في القتال- فقد وردت في قوله تعالى:﴿وَلَوۡ قَٰتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوُاْ ٱلۡأَدۡبَٰرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا . سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا﴾- الفتح [21، 22]
والآيتان تبينان نتائج القتال فيما لو حدث هذا القتال يوم الحديبية، بين المؤمنين، والمشركين.
وكذلك يقول القران الكريم عن أهل الكتاب:
﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ -آل عمران: 111-.
ويقول عن المنافقين وتأييدهم لأهل الكتاب:
﴿لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ -الحشر: 12- ويقول عن المنافقين أيضاً:
﴿۞لَّئِن لَّمۡ يَنتَهِ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ وَٱلۡمُرۡجِفُونَ فِي ٱلۡمَدِينَةِ لَنُغۡرِيَنَّكَ بِهِمۡ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلٗا . مَّلۡعُونِينَۖ أَيۡنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقۡتِيلٗا . سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا﴾. الأحزاب [60-62]
ويرى ابن تيمية أنَّ السُنَّة- في هذه الآية- تتضمن أن كل من جاور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متى أظهر مخالفته مكّن الله تعالى الرسول من إخراجه، كما أصاب من قبلهم من أهل الكتاب، فإن الله أخرجهم.
فإن لم ينته من مخالفته- هؤلاء المذكورون في الآية- بل أظهروا الكفر كما أظهره أولئك أخرجناهم كما أخرجناهم بخلاف ما إذا كتموه.
ثم يقول ابن تيمية: وهذه- في أهل العهد والمنافقين- وقد يقال: هي لهم مع المؤمنين أبداً” ([13]) يريد بذلك: أن هذه الآية نزلت في أهل العهد من اليهود الذين وادعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي المنافقين الذين كانوا يجاورونه في المدينة، ثم يستدرك ابن تيمية فيقول:
وقد يقال: هي لهم مع المؤمنين أبداً، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. وبذلك تكون هذه السُنَّة ماضية أبداً في المنافقين وأهل العهد- المجاورين للمؤمنين- في كل زمان ومكان.
ويقول ابن تيمية تعليقاً على هذه الآية في الفتاوى:
وهذه الآية أنزلها الله تعالى قبل الأحزاب، وظهور الإسلام وذل المنافقين، فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك – قبل بدر وبعدهاـ وقبل أحد وبعدها – فأخفوا النفاق وكتموه، فلهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وبهذا يجيب من يقتل الزنادقة ويقول: إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم ولكن إذا أظهروها قتلوا بهذه الآية بقوله:
﴿مَّلۡعُونِينَۖ أَيۡنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقۡتِيلٗا . سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا﴾ الأحزاب [61، 62]
قال قتادة: ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق فأوعدهم الله بهذه الآية، فلما أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه:
“سُنَّة الله في الذين خلوا من قبل”، يقول: هكذا سُنَّة الله فيهم إذا أظهروا النفاق.
قال مقاتل بن حبان قوله: (سُنَّة الله في الذين خلوا من قبل، يعني كما قتل أهل بدر وأسروا)
وقد بيَّن أبو جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي الحكمة من قوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب: 38-39] عقيب قوله: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ﴾ في كتابه: ملاك التأويل، خلاصتها: إن الرسول صلى الله عليه و آ له وسلم حين تكلم المنافقون في شأن زواجه من زينب رضي الله عنها وقالوا تزوج امرأة ابنه أدركه الحياء صلى الله عليه و آ له وسلم وخشي مقالتهم، فقيل له: لا تخش أحداً، فإنك إنما جريت في ذلك كله، على ما بيَّن الله لك من الشرع الذي جعله سبحانه سبيلك ودينك الذ ي تدعو إليه، وطريق من تقدمك من الرسل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، فالله تعالى أحق أن تخشاه أنت يا محمد، ولا تصغ إلى أحد، ولا تستحي منه، فإنك على صراط مستقيم، فقد وضح ما أخفاه في نفسه، وهذا الذي أبداه تعالى ألا ترى أنه سبحانه قد وعد أن يبدي ما أخفاه صلى الله عليه وآ له وسلم في نفسه، فهل ترى في تلك القصة خلاف ما نطق به كتابه من قوله تعالى:
﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: 37] وكانت زينب رضي الله عنها تفخر بهذا وتقول لأزوج النبي صلى الله عليه وآ له وسلم: زوجكن أهلوكن، وزوجني الله من فوق سبع سموات، فهذا إخباره سبحانه وما أبداه مما أخفاه نبيه صلى الله عليه و آ له وسلم في نفسه، وما سوى هذا فاختلاق..) ([14])
(*) أستاذ التفسير وعلوم القرآن في عدد من الجامعات، وهذا المقال استكمال لدراسة طويلة نوالي نشرها في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى.
(1) جامع الرسائل: 50.
(2) الرد على المنطقيين: 390 وما بعدها.
(3) البحر المحيط: 6/66.
(4) زاد المسير: 5/70.
(5) البحر المحيط: 6/66.
(6) زاد المسير: 7/207.
7) الفتاوى لابن تيمية: 14/321، وما بعدها.
(8) يراجع في ظلال القرآن 7/124-134 تعقيباً على قوله تعالى: قل سيروا في الأرض.
(9) زاد المسير: 5/158.
(10) جامع الرسائل: 51 بشيء من التصرف في التقديم والتأخير نتيجة لاضطراب ترتيب الناسخ.
(11) الفتاوى: 13/20.
(12) الفتاوى لابن تيمية: 28/425، وما بعدها باختصار.
(13) الطبري: 5/26-27.
(14) انظر: ملاك التأويل ص:949-952.