بقلم أ.د. أحمد حسن فرحات(*)
سُنَّة الله تعالى في النصر:
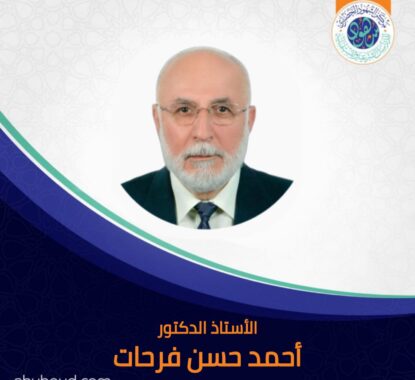
أما “سُنَّة الله”- في نصر أوليائه على اعدائه في القتال- فقد وردت في قوله تعالى:
﴿وَلَوۡ قَٰتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوُاْ ٱلۡأَدۡبَٰرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا٢٢ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا﴾- الفتح [21، 22]
والآيتان تبينان نتائج القتال فيما لو حدث هذا القتال يوم الحديبية، بين المؤمنين، والمشركين.
وكذلك يقول القران الكريم عن أهل الكتاب:
﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ -آل عمران: 111-.
ويقول عن المنافقين وتأييدهم لأهل الكتاب:
﴿لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ -الحشر: 12- ويقول عن المنافقين أيضاً:
﴿۞لَّئِن لَّمۡ يَنتَهِ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ وَٱلۡمُرۡجِفُونَ فِي ٱلۡمَدِينَةِ لَنُغۡرِيَنَّكَ بِهِمۡ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلٗا٦٠ مَّلۡعُونِينَۖ أَيۡنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقۡتِيلٗا٦١ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا٦٢﴾ الأحزاب [60-62]
ويرى ابن تيمية أنَّ السُنَّة- في هذه الآية- تتضمن أن كل من جاور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متى أظهر مخالفته مكّن الله تعالى الرسول من إخراجه، كما أصاب من قبلهم من أهل الكتاب، فإن الله أخرجهم.
فإن لم ينته من مخالفته- هؤلاء المذكورون في الآية- بل أظهروا الكفر كما أظهره أولئك أخرجناهم كما أخرجناهم بخلاف ما إذا كتموه.
ثم يقول ابن تيمية: وهذه- في أهل العهد والمنافقين- وقد يقال: هي لهم مع المؤمنين أبداً” ([1]) يريد بذلك: أن هذه الآية نزلت في أهل العهد من اليهود الذين وادعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي المنافقين الذين كانوا يجاورونه في المدينة، ثم يستدرك ابن تيمية فيقول:
وقد يقال: هي لهم مع المؤمنين أبداً، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. وبذلك تكون هذه السُنَّة ماضية أبداً في المنافقين وأهل العهد- المجاورين للمؤمنين- في كل زمان ومكان.
ويقول ابن تيمية تعليقاً على هذه الآية في الفتاوى: وهذه الآية أنزلها الله تعالى قبل الأحزاب، وظهور الإسلام وذل المنافقين، فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك – قبل بدر وبعدهاـ وقبل أحد وبعدها – فأخفوا النفاق وكتموه، فلهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وبهذا يجيب من يقتل الزنادقة ويقول: إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم ولكن إذا أظهروها قتلوا بهذه الآية بقوله: ﴿مَّلۡعُونِينَۖ أَيۡنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقۡتِيلٗا٦١ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا٦٢﴾ الأحزاب [61، 62]، قال قتادة: ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق فأوعدهم الله بهذه الآية، فلما أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه: “سُنَّة الله في الذين خلوا من قبل”، يقول: هكذا سُنَّة الله فيهم إذا أظهروا النفاق.
قال مقاتل بن حبان قوله: (سُنَّة الله في الذين خلوا من قبل، يعني كما قتل أهل بدر وأسروا) ([2])
ثبات السنن الإلهية:
من خلال النصوص المتقدمة نرى كثيراً منها ينتهي بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ كما نجد نصين من تلك النصوص ينتهي أحدهما بقوله تعالى:
﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ -الإسراء: 77- وينتهي الأخر بقوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ -فاطر: 43-.
وأول ما يلفت الانتباه: تخصيص هاتين الآيتين من دون بقية الآيات، بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ -الإسراء: 77- وإذا نظرنا في سياق الآية الأولى: نرى أنَّ سياقها في شأن الرسل – صلوات الله عليهم- حيث تضاف السُنَّة إليهم: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ -الإسراء: 77-
فهو أمر لابدَّ أن يتعرض له كل رسول، وأنت من جملتهم، ولا يمكن تحويل ذلك عنهم.
ويرى ابن تيمية أن المراد بالتبديل: أن تبدل بخلافه. وأن المراد بالتحويل: أن تحول من محل إلى محل. وذلك مثل استفزازه من الأرض ليخرجوه، فإنهم لا يلبثون خلقه إلا قليلاً. ولا تتحول هذه السُنَّة- بأن يكون هو المخرج، وهم اللابثون- بل متى أخرجوه خرجوا خلفه. ولو مكث لكان هذا استصحاب حال، بخلاف ظهور الكفار، فإنَّه كان تبديلاً لظهور المؤمنين، بظهور الكفار، إذ كان لابدَّ من أحدهما.
وأما أهل المكر السيء والكفار: فلابدَّ لهم من العقوبة، لا يبدلون بها غيرها، ولا تتحول عنهم إلى المؤمنين، وهو وعيد لأهل المكر السيء، أنه لا يحيق إلا بأهله، ولن يتبدلوا به خيراً- يتضمن نفياً، وإثباتاً- فلهذا نفى عنه التبديل والتحويل. ([3])
وكثيراً ما يستدل الكتاب والمفكرون بمثل هذه الآيات على ثبات السنن الإلهية وحتميتها، وعدم تخلفها، علماً بأنهم يتوسعون في مدلول كلمة “السنن” حتى تشمل القوانين الطبيعية والكونية، في حين يستعملها القرآن الكريم خاصَّة بسنن التاريخ، كما بيَّنا ذلك من قبل.
فإلى أي حد تصح فكرة السنن وحتميتها، وإلى أي مدى يمكن التوسع في مفهوم السنن؟ وما هو موقف العلماء والمفكرين من ذلك؟
هذا ما سنعالجه في الصفحات التالية:
التوسع في إطلاق “سُنَّة الله”:
يرى المعلم عبد الحميد الفراهي الهندي: أن أول من استعمل كلمة “سُنَّة الله”- بالمعنى الشامل لطبائع الخلق كلها- هم أصحاب رسائل إخوان الصفاء، ثم تابعهم على ذلك صاحب كتاب “حجة الله البالغة” ([4]) ولي الدين الدهلوي.
كما يذكر ابن تيمية ([5]) أن السهروردي المقتول: ذهب إلى أن العالم لا يتغير، بل لا تزال الشمس تطلع، وتغرب، لأنها عادة الله. وأنه احتج على ذلك بالآيات السابقة، التي تنص على أن سُنَّة الله غير قابلة للتغير والتبديل.
تعليل الفراهي للقائلين بأن الطبائع من سُنَّة الله وردوده عليهم:
وقد علل الفراهي ما ذهب إليه القائلون: بأن طبائع الخلق من سُنَّة الله، وأنها ثابتة بعدة ظنون:
– فقد ظنوا أن التبديل في الخلق محال، لقول الله تعالى: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: 30].
– وظنوا أن قوله تعالى ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 62].
– وظنوا أن طبائع الخلق كلها تدخل تحت “سُنَّة الله”.
– وظنوا أن (طبائع الخلق) ثابتة لما علموا من التجربة: أنَّ الأشياء لا تتحول عن آثارها.
وقد رد الفراهي هذه الظنون، وبيَّن بطلانها واحدة، واحدة، فقال:
– ظنوا أن التبديل في الخلق محال لقوله تعالى:
﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ وهذا ظن باطل مشاهدة، فإن الخلق يتبدل.
وكذلك باطل نصا ًكما جاء في القرآن ﴿وَلَآ مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾
-النساء: 119- وكما جاء في الحديث: “لعن الله الواشمة والمستوشمة المغيرات
خلق الله”، ثم سياق الكلام للنهي عن التبديل. فلو كان محالاً لم يكن محلاً للنهي. وإنما هو كقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ -البقرة: 197-
ثم يقول في رد الظن الثاني: – وظنوا أنه كقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ -الفتح: 23-. وهذا ظن باطل، فإن قوله تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ -الروم: 30- ظاهر في أن المراد من الفطرة هنا: هي فطرة الإنسان التي ينبغي أن لا يجروا خلافها. وإذاً هي الدين القيم.
وأما سُنَّة الله: فهي الطريق المرعية في أفعال الله تعالى، هي طريق العدل والرحمة. وههنا هي نصر أنبيائه، وقمع الظالمين: إذا بلغوا آجالهم”.
ثم يقول في رد الظن الثالث: وظنوا أن المراد من سُنَّة الله: طبائع الخلق كلها. فالنار مثلاً: لابدَّ أن تحرق الإنسان. فعادات المخلوقات غير متبدلة، وعلى هذا أنكروا المعجزات، وغرهم أقوال من سمى هذه الطبائع: سُنَّة الله، وأول من استعمل كلمة “سُنَّة الله”- في هذا المعنى- هم أصحاب رسائل اخوان الصفاء وتبعهم صاحب “حجة الله البالغة”. وتأويل القرآن إنما يصح حسب استعماله ([6]).
ثم يقول الفراهي في رد الظن الرابع: “الأشياء إما هي منفعلات: فلابدَّ أنها تحت إرادة، فتصرفها عن آثارها إن شاءت. وإما هي فاعلات – فهن أنفسهن ذوات إرادة – فإن شئن صرفن فعلهن عن شيء. فلا إشكال في خرق عادات الأشياء.
ولكنهم لما رأوا أن الأشياء لا تتحول عن آثارها أيقنوا بأنها خالية من الإرادة، فلابدَّ لهم أن يوقنوا بأنها تحت إرادة مريد. فإن قالوا إنَّ هذا المريد جعل الآثار لازمة، كما علمنا من التجربة، قلنا: إن التجربة لا تثبت اللزوم، إنما تثبت العموم” ([7]).
وبمثل هذه الردود القوية على تلك الظنون الباطلة، تتهاوي تلك المقولة التي تجعل “طبائع الخلق” من سُنَّة الله، التي لا تتغير ولا تتبدل.
رد ابن تيمية على السهروردي وأمثاله:
أما ابن تيمية فقد عرض لاحتجاج السهروردي وأمثاله- من المتفلسفة- بآيات السنن على صحة ما ذهبوا إليه: من اعتبار العادات الطبيعية، من سنن الله الثابتة، وأبطل مزاعمهم، واعتبر احتجاجهم بالقرآن نوعاً من تحريف الكلم عن مواضعه. وأن القرآن يصرح بنقيض مذهبهم، في جميع المواضع ودلل على ذلك وبيَّنه من وجوه متعددة:
– أحدها: أن يقال: العادات الطبيعية ليس للرب فيها سُنَّة لازمة، فإنه قد عرف بالدلائل اليقينية أن الشمس، والقمر، والكواكب: مخلوقة بعد أن لم تكن. فهذا تبديل وقع. وقد قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ﴾ -إبراهيم: 48-([8]) وأيضاً فقد عرف انتقاض عامة العادات. فالعادة في بني آدم: ألا يخلقوا إلا من أبوين. وقد خلق المسيح من أم، وحواء من أب، وآدم من غير أم ولا أب. وإحياء الموتى متواتر مرات متعددة، وكذلك تكثير الطعام والشراب لغير واحد من الأنبياء، والصالحين، عليهم السلام.
– وأيضاً فعندكم تغيرات وقعت في العالم كالطوفانات الكبار، التي فيها تغيير العادة. ثم يقول: وهذا خلاف عادته التي وعد بها، وأخبر أنها لا تتغير: كنصرة أوليائه، وإهانة أعدائه. فإن هذا عُلِمَ بخبره، وحكمته.
أما خبره: فإنه أخبر بذلك ووعد به، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد تعالى.
وأما حكمته: فهذا يوافق طرق جميع طوائف أهل الملل الذين يقولون: مقتضى حكمته: أن يكون العاقبة والنصر لأوليائه سبحانه، دون اعدائه – كما قد بسط ذلك في مواضع-.
ثم يؤكد ابن تيمية عدم امتناع تبديل وتحويل الأمور الطبيعية: سواء قلنا بوقوعها بمحض المشيئة، أو بحسب الحكمة والمشيئة، فيقول:
(وأما الأمور الطبيعية فإما أن تقع بمحض المشيئة- على قول- وإما أن تقع بحسب الحكمة والمشيئة- على قول-.
وعلى كلا التقدير ين: فتبديلها وتحويلها ليس ممتنعاً- كما في نسخ الشرائع، وتبديل آية بآية- فإنه إن علّق الآية بمحض المشيئة، فهو يفعل ما يشاء. وإن علّقها بالحكمة مع المشيئة، فالحكمة تقتضي تبديل بعض ما في العالم، كما وقع كتير من ذلك في الماضي، وسيقع في المستقبل.
فعلم أن هذه السنن دينيات، لا طبيعيات”. ([9])
هل يمكن تعميم السُنَّة لتشمل الطبيعيات؟
ثم بيَّن ابن تيمية أن قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ -الأحزاب: 62- يشهد لراي الجمهور القائلين بالحكمة، وأنه يمكن أن يعم كل سُنَّة له في خلقه وأمره- في الطبيعيات، والدينيات- لكن الشأن أن تعرف سنته، وأنها إذا نقضت فإنما تنقض- لاختصاص تلك الحال بوصف امتازت به عن غيره- فلم تكن سنته مع ذلك الاختصاص. وإنما تكون سنته مع عدمه.
وكأن ابن تيمية يريد بهذا: أنه لو سلم بالعموم في قوله: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ لكان الجواب ما ذكره من أن التغيير الذي حدث لا يكون داخلاً في السُنَّة، وإنما يكون خارجاً عنها. ولكن الأولى ألا نجعلها عامة، لأنَّ سياق الآيات يمنع من ذلك، وعلى كل: فلننظر إلى وجهة نظر ابن تيمية كما يوضحها فيما يلي:
ولكن في قوله تعالى ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ حجة للجمهور القائلين بالحكمة. فإن أصحاب المشيئة المجردة: يجوزون نقض كل عادة، ولكن يقولون: إنما نعلم ما يكون بالخبر.
وقوله تعالى: دليل على أنَّ هذا من مقتضى حكمته سبحانه، وأنه يقضي في الأمور المتماثلة بقضاء متماثل، لا بقضاء مخالف. فإذا كان قد نصر المؤمنين، لأنهم مؤمنون كان هذا موجباً لنصرهم حيث وجد هذا الوصف، بخلاف ما إذا عصوا، ونقضوا إيمانهم كيوم أحد. فإن الذنب كان لهم، ولهذا قال: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ تعم كل سُنَّة له، وهو يَعُمُّ سنته في خلقه وأمره في الطبيعيات، والدينيات. لكن الشأن أن تعرف سنته.
وحقيقة هذا أنه إذا نقض العادة، فإنما ذلك لاختصاص، فسنته مع عدمه. كما تقول: إذا خصَّت العلة لفوات شرط، أو وجود مانع، وكما نقول في الاستحسان الصحيح: هو تخصيص بعض أفراد العام بحكم يختص به لامتيازه عن نظائره بوصف يختص به”.
والسُنَّة: هي العادة في الأشياء المتماثلة… فإنه سبحانه إذا حكم في الأمور المتماثلة بحكم، فإن ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا يتحول. بل هو سبحانه لا يفرق بين المتماثِلَين، وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التماثل.
وهذا القول أشبه بأصول الجمهور- القائلين بالحكمة في الخلق، والأمر-. وأنه سبحانه يسوي بين المتماثلين، ويفرق بين المخْتلِفَين، كما دلَّ القرآن على هذا في مواضع، كقوله تعالى ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [القلم: 35].
ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لنا، ولولا القياس واطراد فعله وسننه، لم يصح الاعتبار بها. والاعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكمَ نظيره، كالأمثال المضروبة في القرآن، وهي كثيرة” ([10]).
القول الراجح في نظر ابن تيمية:
سبق أن بينّا رأيَ اين تيمية في أن السنن الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل: هي ما أخبر الله الله به في كتابه – من نصر أوليائه، وخذلان أعدائه- أو هي بتعبير آخر: ما يمكن أن نسميه بسنن التاريخ والاجتماع، وأن ثبات السُنَّة الطبيعية – لا يمكن الاستدلال عليه من خلال الآيات النافية للتبديل والتحويل في السُنَّة الإلهية- كما ذهب إلى ذلك السهروردي وغيره.
غير أنَّ الفقرة السابقة من قول ابن تيمية: أجازت تعميم السُنَّة الثابتة بحيث تكون شاملة للسنن الطبيعية بنوع من التأويل، وقلنا بأن الأولى عدم اللجوء إلى هذا التأويل، لأن مورد الآيات كان أصلاً في غير السنن الطبيعية، ولعل هذا الرأي الراجح في ما نقل عن ابن تيمية- في كثير من المواطن- ويمكن تأكيد ذلك بما ذكره ابن تيمية في كتابه “الرد على المنطقيين” حيث جاء فيه:
“…وقد أراد بعض الملاحدة كالسهروردي المقتول في كتابه “المبدأ والمعاد” الذي سماه “الألواح العمادية”: أن يجعل له دليلاً من القرآن والسُنَّة على إلحاده، فاستدل بهذه الآية: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾
على أنَّ العالم لا يتغير، بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب، لأنها عادة الله. فيقال له: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة، بالجملة.
وقد أخبر في غير موضع أنه سبحانه لم يخلق العالَمَ عبثاً وباطلاً، بل لأجل الجزاء. فكان هذا من سنته الجُمْلِيَّة، وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة. كما أخبر به من نصر أوليائه وعقوبة أعدائه.
فبعث الناس للجزاء هو من هذه السُنَّة، التي هي عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه، ونصرهم على الأعداء. فهذه هي التي أخبر أنه لن يوجد لها تبديلا ولا تحويلا، كما قال: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ -فاطر: 43-
وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعل، وارادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة، فتسوي بين المتماثلات، ولن يوجد لهذه السُنَّة تبديل ولا تحويل: وهو إكرام أهل ولايته وطاعته، ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين.
فهذه السُنَّة تقتضيها حكمته سبحانه، فلا انتقاض لها بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره، فذاك تغييره من الحكمة أيضاً…” ([11]).
ولا شك بأن مثل هذا النص يقطع بمراد ابن تيمية، إذ يجعل محاولة السهروردي تعميم ثبات السنن الإلهية – والاستدلال على ذلك بالقرآن والسُنَّة – استدلالاً على إلحاده. فهو إذن لا يمكن أن يقبل بمثل هذا الإلحاد، الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه.
(*) أستاذ التفسير وعلوم القرآن في عدد من الجامعات، وهذا المقال استكمال لدراسة طويلة نوالي نشرها في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى.
(1) جامع الرسائل: 51 بشيء من التصرف في التقديم والتأخير نتيجة لاضطراب ترتيب الناسخ.
(4) ولدى رجوعنا إلى كتاب حجة الله البالغة وجدناه يقول:
(اعْلَم أَن بعض أَفعَال الله يَتَرَتَّب على القوى المودعة فِي الْعَالم بِوَجْه من وُجُوه الترتب، شهد بذلك النَّقْل وَالْعقل قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إن الله خلق آدم من قَبْضَة قبضهَا من جَمِيع الأَرْض، فجَاء بَنو آدم على قدر الأَرْض، مِنْهُم الْأَحْمَر والأبيض وَالْأسود، وَبَين ذَلِك، والسهل والحزن، والخبيث وَالطّيب، وَسَأَلَهُ عبد الله بن سَلام مَا ينْزع الْوَلَد إِلَى أَبِيه أَو إِلَى أمه؟ فَقَالَ: إِذا سبق مَاء الرجل مَاء الْمَرْأَة نزع الْوَلَد وَإِذا سبق مَاء الْمَرْأَة مَاء الرجل نزعت “.
وَلَا أرى أحدا يشك فِي أَن الإماتة تستند إِلَى الضَّرْب بِالسَّيْفِ أَو أكل السم، وَأَن خلق الْوَلَد فِي الرَّحِم يكون عقيب صب الْمَنِيّ، وَأَن خلق الْحُبُوب وَالْأَشْجَار يكون عقيب الْبذر وَالْغَرْس والسقي= =وَلأَجل هَذِه الِاسْتِطَاعَة جَاءَ التَّكْلِيف، وَأمرُوا، ونهوا، وجوزوا بِمَا عمِلُوا، فَتلك القوى مِنْهَا خَواص العناصر وطبائعها، وَمِنْهَا الْأَحْكَام الَّتِي أودعها الله فِي كل صُورَة نوعية، وَمِنْهَا أَحْوَال عَالم الْمِثَال والوجود الْمقْضِي بِهِ هُنَالك قبل الْوُجُود الأرضي، وَمِنْهَا أدعية الْمَلأ الْأَعْلَى بِجهْد هممهم لمن هذب نَفسه، أَو سعى فِي إصْلَاح النَّاس، وعَلى من خَالف ذَلِك، وَمِنْهَا الشَّرَائِع الْمَكْتُوبَة على بني آدم وَتحقّق الْإِيجَاب وَالتَّحْرِيم فَإِنَّهَا سَبَب ثَوَاب الْمُطِيع وعقاب العَاصِي، وَمِنْهَا أَن يقْضِي الله تَعَالَى بِشَيْء، فيجر ذَلِك الشَّيْء شَيْئا آخر لِأَنَّهُ لَازمه فِي سنة الله، وخرم نظام اللُّزُوم غير مرضِي، وَالْأَصْل فِيهِ قَول رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِذا قضى الله لعبد أَن يَمُوت بِأَرْض جعل لَهُ إِلَيْهَا حَاجَة ” فَكل ذَلِك نطقت بِهِ الْأَخْبَار، وأوجبته ضَرُورَة الْعقل.
وَاعْلَم أَنه إِذا تَعَارَضَت الْأَسْبَاب الَّتِي يَتَرَتَّب عَلَيْهَا الْقَضَاء بِحَسب جري الْعَادة، وَلم يُمكن وجود مقتضياتها أجمع – وَكَانَت الْحِكْمَة حِينَئِذٍ مُرَاعَاة أقرب الْأَشْيَاء إِلَى الْخَيْر الْمُطلق وَهَذَا هُوَ الْمعبر عَنهُ بالميزان فِي قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” بِيَدِهِ الْمِيزَان يرفع الْقسْط وَيخْفِضهُ ” وبالشأن فِي قَوْله تَعَالَى: {كل يَوْم هُوَ فِي شَأْن}. ثمَّ التَّرْجِيح يكون تَارَة بِحَال الْأَسْبَاب أَيهَا أقوى، وَتارَة بِحَال الْآثَار المترتبة أَيهَا أَنْفَع، وبتقديم بَاب الْخلق على بَاب التَّدْبِير وَنَحْو ذَلِك من الْوُجُوه، فَنحْن أَن قصر علمنَا عَن إحاطة الْأَسْبَاب وَمَعْرِفَة الأحق عَن تعارضها نعلم قطعا أَنه لَا يُوجد شَيْء إِلَّا وَهُوَ أَحَق بِأَن يُوجد، وَمن أَيقَن بِمَا ذكرنَا استراح عَن اشكالات كَثِيرَة) )حجة الله البالغة: 1/11 ط دار المعرفة.
(5) يراجع كلام ابن تيمية في جامع الرسائل: 52 والرد على المنطقيين: 390-391 ويراجع كلام الفراهي في القائد إلى عيون العقائد: 165.




