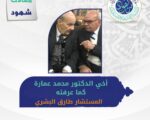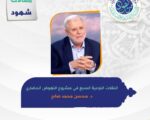بقلم الأستاذ/ أحمد كاسر الحاجي(*)

قال تعالى: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [ الأحزاب: 62]، آيةٌ موجزة، لكنها تختصر فلسفةَ التاريخ وتفضُّ روحَ الحضارة، وتضربُ بمِعول الوحي في عمق حركة الكون والإنسان. فصعودُ الحضارات لا يُولد من عشوائيّة، وسقوطُها لا يُعزى إلى المصادفة؛ بل كلٌّ منهما نتيجةُ التزامٍ أو إخلالٍ بسننٍ ربانيّةٍ لا تُحابِي، ولا تتخلّى عن عدلها الأزليّ. وهذا الناموسٍ الربّانيٍّ محايدٍ يُعطي على قدر الأخذ ويمنعُ بقدر التخلّف عن الأسباب.
الاستخلافُ: مرتكَزُ الرُّؤية الحضاريّة
منذ اللحظةِ الأولى أُعلن مشروع الإنسان ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾[ البقرة: 30] فما الخليفة إلا حاملٌ للرسالة، ومؤتمنٌ على الفكرة، وباني العمران. فوجودُه تكليفٌ عُمرانيّ، لا وجوديّةً عبثيّة. وهنا تلتقي السننيّةُ القرآنيّةُ المنطلقة من العلم والمعرفة مع فكرة العصبيّة عند ابن خلدون لكن العصبية للفكرة الفاعلة، كما يقرر مالك بن نبي بأنّ الحضارةَ هي تحويلُ القيمِ إلى فاعليّةٍ اجتماعيّة. فتتحول الطاقة الأخلاقيّة إلى مسار حضاريّ حَيّ، وتكفّ عجلة التاريخ عن أن تكون سيّدة على الإنسان، لتصبح ميدانًا لصنعه، وساحةً لحضوره. فيتحوّلُ التاريخُ من متحكّم إلى محكوم ومن صانع إلى مصنوع!
السَّعيُ والجزاءُ: صرامة القانون الحضاري
قال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم:٣٩ -٤١] -سنّةٌ تلغي وَهْمَ “التفوّق الوراثيّ. فالحضارةُ التي توظّفُ العقلَ والوقتَ والمواردَ تنالُ الريادةَ ولو لم تمتلكْ رصيدًا تاريخيًّا، وأمّةٌ تأنَسُ إلى ماضيها من غير تجديدٍ تُقصى ولو امتلكت أنصعَ السِّير. فأوروبا الصناعيّةُ في القرن التاسع عشر مثالٌ لاستثمارِ البحثِ والإدارةِ، بينما تجمّدَ الإبداعُ في جزءٍ كبيرٍ من العالم الإسلاميّ حين جمدت المؤسسات التعلمية، وتحوّلَت إلى أداة من أدوات الاستبداد، وانشغلت بالجزئيات عن المقاصد الكلية العمرانية الحضارية!
التدافُعُ: ديناميّةُ التجدّد وضمانُ المرونة
جعل القرآنُ التدافعَ قانونَ توازنٍ: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾[ البقرة: 251]. لا تُقام الحضارات على الأطلال، ولا تُبنى الدول بالماضي المجيد ما لم يُتَرجم إلى حاضرٍ فاعل.
فالحضارةُ الحيّةُ هي التي تحسنُ إدارةَ الخلاف الداخليّ وتحوّلُ الصراعَ الخارجيّ إلى تنافسٍ مبدعٍ أو تعاونٍ متكامل. فالأندلسُ في ذروة إشراقها شاهدٌ على خصوبة التلاقح الثقافي، وفي شيخوختُها مثالٌ على ما يصنعُه الاستبدادُ من اختناقٍ ونُكوصٍ. فالمرونةُ الحضاريّةُ – بتعبير عماد الدين خليل – هي قدرةُ الأمّة على تجديد أدواتها من غير أن تفقدَ روحها.
فالتدافع يمنع الجمود، ويخلق حافزًا دائمًا للنمو والتطور. فحين تواجه الأمة الإسلامية تحديات فكرية أو سياسية أو ثقافية، ينشأ ردّ فعل حضاري يعيد للأمة وعيها وهُويتها، ويجدّد أدواتها وآلياتها. فالتدافع يُوقظ الأمم، ويجبرها على إعادة النظر في أدواتها ومناهجها، ويمنحها فرصة التجدّد الذاتي، دون أن تمسخ روحها أو تنكر جذورها.
سننُ الأفول: التبدّدُ الداخليّ قبل الضربة الخارجيّة
الانهيار لا يبدأ من طلقة عدو، بل من استقالة الضمير. من لحظةٍ يُستبدل فيها العدل بالمحاباة، والعقل بالشعار، والرسالة باللهو. تلك هي سنّةُ التغييرِ الداخليّ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [ الرعد: 11]. فإذا استُبدلَ العدلُ بالمحسوبيّة، والعلمُ بالشعار، والرسالةُ بالترف، فُعّلت سنّةُ الاستدراج، فتُغدقُ النِّعَم حتى تَعمى البصيرة؛ ثمّ يأتي العقاب قال تعالى: ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾[ سورة القمر: 42] ولذا يقرر أرنولد توينبي: بأن الحضاراتُ تنتحر، لا تُقتل. ويؤكّد المقرئ أبو زيد الإدريسي: بأنّ من جهلَ موقعه من السنن خرج من التاريخ ولو ملك السلاح.
الوعيُّ السننيُّ المعاصر: من التّنظير إلى التّفعيل
*سيف الدين عبد الفتّاح: يجعلُ فقهَ السنن بوّابةَ التحرّر من الاستلاب وبوصلةَ الاستشراف السياسيّ.
*محمد نوباني: يرى أنّ قراءة القرآن قراءةً سننيّةً تُحوِّله من كتابِ تلاوةٍ إلى دليلٍ تشغيليٍّ لبناء المؤسّسات.
*عمر عبيد حسنة: يربطُ العمرانَ بالنسق البيئيّ، مؤكّدًا أنّ اختلال العلاقة مع الكون اختلالٌ لمعادلة الاستخلاف.
*رمضان خميس غريب: يدعو إلى تدريس السننيّة علمًا مؤسّسيًّا لتكوين «عصبيّةٍ معرفيّة» تحولُ الفكرةَ إلى بنية.
*محمد طلابي: يُحذّرُ من «استنساخ الفشل» جرّاءَ غفلةٍ عن سنن التاريخ واستمرارِ دورة الصفر.
*وصفي عاشور أبو زيد: يربط بين فقه السنن و”المقاصد العليا”، ويرى أن فهم السنن هو السبيل لضبط التطبيق العملي للمقاصد الحضارية.
خاتمةٌ: نحو هندسةٍ سننيّةٍ للنهضة
النهضة لا تُصنع في هوامش الصحف، ولا في زخرف الخُطَب. إنها مشروعٌ هندسيّ يقوم على أسس:
*غايةٌ أخلاقيّة تحفظ الاتجاه.
*وعملٌ متقنٌ يضبط الأدوات.
*ونظامٌ عادلٌ يحفظ التوازن.
فمتى تضافرت هذه المفاتيح في الفرد والمؤسسة والدولة، صار الحلم مشروعًا، والصوت صرحًا، والماضي شاهدًا لا قيدًا.
أما من آثر بكاءَ الأطلال، فسوف يبقى رهين الحنين، لأن السنن لا تلتفتُ إلى العاطلين، ولا تمهّد السبيلَ لمن عطّل الأسباب.
هل نُصغي لصوت السنن؟
الفرصة لا تزال قائمة، والباب لا يزال مفتوحًا، والغد لا يزال يُنادي؛ فهل نُبادر قبل أن تُغلق الأقدارُ النوافذ، ويأتي الأمسُ ليرثَ الغد؟
(*) داعية سوري، وباحث في السياسة الشرعية.