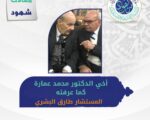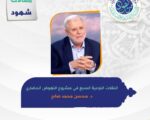بقلم الأستاذ أحمد كاسر الحاجي(*)
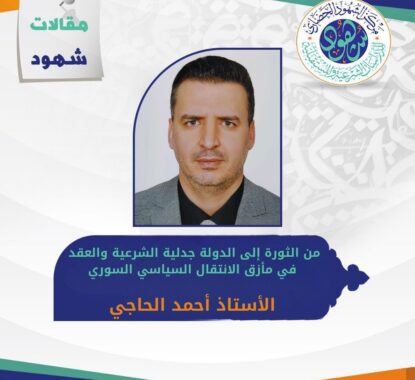
من الاحتجاج إلى التأسيس… تعثر البوصلة وبذور الاستئناف
منذ لحظة انطلاقتها، مثّلت الثورة السورية منعطفًا وجوديًّا لا مجرد حدث سياسي؛ إذ فتحت المجال أمام إعادة التفكير في الدولة، والسلطة، والشرعية، والعمران، ضمن سياق عربي مأزوم يبحث عن ذاته. غير أن ما بدا في ظاهره وعدًا تاريخيًّا بالتحرّر، سرعان ما تحوّل إلى مأزق حضاري مركّب، حيث اصطدم الفعل الثوري بغياب المشروع، وتعثّر الوعي السنني، واختلال الرؤية الجامعة.
فالتحول السياسي، في جوهره، ليس إسقاط رأس هرم أو تبديل نظام، بل هو فعلٌ تأسيسيٌّ حضاري، يتطلب استيعاب قوانين التاريخ، واستحضار مقاصد الشريعة، وتفعيل سنن النهوض والتمكين. وأي محاولة لبناء المستقبل دون هذا الوعي المركب، تتحول إلى مراوحة مأساوية في ذات النقطة التي بدأت منها الصرخة الأولى.
الشرعية السياسية: من القوة إلى القبول الحضاري
في المشهد السوري، انكشفت أزمة الشرعية بوصفها أعمق من مجرد فقدان السيطرة، وأخطر من مجرد غياب الاعتراف الدولي. لقد تآكلت شرعية القوة التقليدية تحت ضغط التحولات الاجتماعية والوعي الشعبي المتصاعد، دون أن تتولد في المقابل شرعية بديلة نابعة من الإرادة الوطنية، ومؤسسة على عقد جامع يعكس روح التعدد ووعي المقاصد.
وهنا لا ينبغي أن يُنظر إلى هذا التعثر كإخفاق نهائي، بل كعلامة على عمق الحاجة إلى مراجعة جذرية تُعيد تحديد العلاقة بين الدولة والمجتمع، بين السلطة والقيم، في ضوء تصور حضاري للشرعية، يجعل من الرضا الشعبي، والشورى الفاعلة، والعدل المؤسسي، أركانًا غير قابلة للتجاوز.
إن ما وصفه ابن خلدون بـ”العصبية الجامعة” ليس سوى التعبير التاريخي عن تلك الرابطة الحية التي تمنح السلطة معناها، وتحول الدولة من جهاز قسري إلى كيان تعبيري عن الإرادة المشتركة للأمة. وكما يقرر المفكر المغربي المقرئ أبو زيد الإدريسي، فإن استعادة الشرعية في المجتمعات المسلمة تبدأ بإحياء التصور العقدي للسلطة، حيث تُعاد صياغة العلاقة بين الأمة والحاكم في إطار من التكليف الأخلاقي، لا الهيمنة السلطوية.
العقد الاجتماعي: رؤية شرعية تتجاوز النموذج الوضعي
تُثار اليوم، بإلحاح متجدد، قضية “العقد الاجتماعي” في المشهد السوري بوصفها مدخلًا نظريًّا لصياغة دولة ما بعد الأزمة، غير أن استيراد المفهوم بصيغته الغربية – كما صاغه روسو ولوك وهوبز – يختزل العلاقة بين الفرد والدولة في اتفاق نفعي مصلحي، منفصل عن المرجعيات القيمية الكبرى.
أما في الرؤية الإسلامية، فإن العقد السياسي يتجاوز ثنائية الحاكم والمحكوم، ليصبح عقدًا شرعيًّا حضاريًّا، تُؤسسه البيعة الراشدة، وتُؤطّره الشورى، وتُثبّته مقاصد العدل والكرامة والعمران. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90] فالحاكم في هذا التصور أجير مؤتمن، لا مالك متغلب، والسلطة وظيفة مقيدة لا مطلقة، والشرعية تُنتزع من رضا الأمة، لا تُمنح بقوة السلاح أو سكوت العوام. ومن هنا فإن سوريا الجديدة لا تحتاج إلى إعادة تقنين دستوري فحسب، بل إلى تجديد جذري للعقد السياسي على أسس من الشفافية، والبيعة الحرة، والشورى الملزمة، والعدالة الشاملة.
المأزق السنني وارتباك المشروع الإصلاحي
في لحظات التحول الكبرى، تصبح السنن الربانية مفتاح الفهم، ومركز الرؤية، ومعيار الفعل. لكن الثورة السورية، وهي تقترب من لحظة التأسيس، افتقدت المشروع الإصلاحي المؤسسي المتكامل، فانزلقت – في غياب الرؤية الجامعة – إلى مسارات متضادة، تأرجحت بين الانفعال العاطفي والتدخلات الخارجية، وبين الحماسة الشعبية والانقسام النخبوي.
وبرغم الزخم الشعبي الهائل، فإن غياب البناء على قواعد السنن – كسنة التداول، والاستحقاق، والتدرج، والتزكية – جعل المشهد الثوري أكثر عرضة للتشظي الداخلي والانكشاف الخارجي.
وقد نبّه د. فتحي ملكاوي إلى أن السنن الربانية ليست مجرد مفاهيم ثقافية، بل قوانين صارمة تحكم مسيرة الحضارات من النشوء إلى الاضمحلال، مؤكدًا أن “كل محاولة إصلاح دون وعي سنني هي بناء فوق رمال متحركة”. الحضارات لا تموت اغتيالًا من الخارج، بل انتحارًا من الداخل.” توينبي.
(إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ) [الرعد:11].
الرؤية الحضارية: غياب البوصلة وارتباك الجواب
الثورة التي لا تُنتج رؤية حضارية تفقد بوصلتها سريعًا. وفي الحالة السورية، ظهر الارتباك جليًا في غياب تعريف جامع للدولة، والهوية، والمواطنة، والسيادة. وتاهت الخطابات بين “مدنية” لم تُعرّف، و”إسلامية” لم تُجسّد، و”ديمقراطية” بلا تربية سياسية، فانتهت إلى مشهد مليء بالشعارات الفارغة والنماذج المستوردة؛ فالثورات التي لا تملك مشروعًا، سرعان ما تلتف عليها القوى المضادة، وكل مشروع سياسي لا يستند إلى رؤية حضارية – بحسب محمد عابد الجابري – مآله التبعية أو الفشل.
فالثورة السورية لم تكن نزاعًا على السلطة، بل بحثًا عن هوية وطنية مهدورة، واستعادة لحقوق المواطن ودوره في صياغة القرار. ومن هنا، لا يكون البناء إلا عبر حوار داخلي يعيد الاعتبار للتوازن المجتمعي، ويُخرج القرار السياسي من عباءة الخارج إلى وجدان الداخل.
من احتباس اللحظة إلى تحرير المسار
إنّ ما تعيشه سوريا اليوم ليس مجرد فراغ سياسي، بل هو فراغ في المعنى والرؤية والمشروع. ولن يملأ هذا الفراغ مجرّد تغيير في الوجوه أو الشعارات، بل لا بد من إعادة تأسيس الدولة على عقد شرعي جامع، تُفعّل فيه مقاصد الشورى والعدل والكرامة، وتُستعاد فيه سيادة القرار الوطني من الداخل لا من التبعية.
إن المستقبل لا يُصنع بالانفعالات، ولا يُستورد من الخارج، بل يُبنى بوعي تاريخي متجدد، يُحسن قراءة اللحظة، ويستلهم السنن، ويُعيد للأمة دورها كفاعل في صياغة مصيرها لا مجرد موضوع في معادلات الآخرين.
(*) داعية سوري، وباحث في السياسة الشرعية.