بقلم د. عزمي طه السيد أحمد(*)
وإذا كنّا نتعرَّف السُّنَن الإلهية من كلام الله سبحانه وتعالى (القرآن الكريم)، وكان الأمر كما نجده في كلامه سبحانه عن القرآن الكريم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَیۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِیهِ ٱخۡتِلَـٰفࣰا كَثِیرࣰا﴾ [النساء ٨٢] فإنَّه لا اختلاف ولا تعارض في كلام الله، الذي عرَفْنا سُنَنه منه. ومن ثَمَّ، فلن يكون بالضرورة بين السُّنَن الإلهية سوى الاتِّساق والتكامل.
[السنن أمثال وإرشاد وبيان]

إنَّ هذه النواميس (السُّنَن) -إضافةً إلى ما تقدَّم ذكره عنها- هي في جانب منها بمنزلة أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى للناس حتى تكون تذكيراً لهم بما حصل لمَنْ كان قبلهم مِنَ الأفراد والجماعات والأُمم، يستقون منها النتائج أو العواقب التي جاءت مُلازِمة لمُقدِّماتها، في حالة العواقب الإيجابية الخيِّرة، أو حالة العواقب السلبية التي كان فيها عذاب أو شَرٌّ. والحقُّ سبحانه وتعالى لم يقصد بهذه الأمثال تذكيرنا فقط، وإنَّما طلب منّا أنْ نتفكَّر فيها، وأنْ نتعقَّلها ونعقلها؛ لكي نَعِيَها وعياً مبنيّاً على عِلْم؛ أيْ على معرفة صادقة معها دليلها. فلنتأمَّل ولنتدبَّر قوله تعالى: ﴿وَیَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ یَتَذَكَّرُونَ﴾ [إبراهيم ٢٥] ، ثمَّ قوله تعالى: ﴿وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَـٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ یَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر ٢١]، وكذلك قوله سبحانه: ﭐ ﴿وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَـٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِۖ وَمَا یَعۡقِلُهَاۤ إِلَّا ٱلۡعَـٰلِمُونَ﴾ [العنكبوت ٤٣]
إنَّ الله عزّ جَلَّ وضع هذه النواميس (السُّنَن)، وجعلها -في أحد جوانبها- أمثلة للناس؛ لينتفعوا بمعرفتها، فيُطبِّقوها في حياتهم الإنسانية -في جميع مستوياتها- بوعي وعِلْم وصلوا إليه بعد تفكُّر وتعقُّل. وهذا في جانب آخر حثٌّ من الله الخالق أنْ ندرس السُّنَن الإلهية، وأنْ نجعلها موضوعاً لعِلْم (دقيق).
فهذه النواميس (السُّنَن) تتضمَّن إرشاداً وبياناً؛ أيْ هدايةً[1] للإنسان في حياته؛ إذ تُرشِده إلى الطريق القويم و”الصراط المستقيم” الذي يُحقِّق باتِّباعه الغاية التي خُلِق من أجلها، وهي عبادة الله تعالى؛ أيْ طاعته بالخضوع الإرادي، وتنفيذ أمره ونهيه وكل ما يُحِبُّه سبحانه ويرضاه.
قال سبحانه وتعالى مُبيِّناً لنا إرادته فينا، بوضع هذه السُّنَن وتبيينها؛ لتكون هدايةً وإرشاداً لنا: ﴿یُرِیدُ ٱللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَكُمۡ وَیَهۡدِیَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَیَتُوبَ عَلَیۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ﴾ [النساء ٢٦]. فالله يريد أنْ نعرف السُّنَن التي جَرَت على الأقوام قَبْلنا، فيكون ذلك هدايةً وبياناً من جانب، وعِبْرةً من جانب آخر في الوقت نفسه؛ فلا نقع في سوء عاقبة مَنْ ظلَمَ الرُّسُلَ وخالفهم مثلاً؛ إذ أعلمَتْنا السُّنَّة الإلهية بهذه العاقبة السيِّئة، ومن الـمُتوقَّع أنْ يحصد النتائج الإيجابية الذين أطاعوا الرُّسُل واتَّبعوهم؛ إذ أعلمَتْنا السُّنَّة الإلهية بذلك؛ لأنَّ سُنَن الله ثابتة “لا تتحوَّل، ولا تتبدَّل”.
وهذه المعاني أكَّدها الحقُّ سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، في مواضعَ عدّة، منها قوله في حقِّ مَنْ يطيع الله ورسوله: ﴿ وَمَن یُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ یُدۡخِلۡهُ جَنَّـٰتࣲ تَجۡرِی مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُ خَـٰلِدِینَ فِیهَاۚ وَذَ ٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِیمُ﴾ [النساء ١٣]، وكذلك قوله سبحانه في حقِّ مَنْ يعصي الله ورسوله: ﴿وَمَن یَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ یُدۡخِلۡهُ نَارًا خَـٰلِدࣰا فِیهَا وَلَهُۥ عَذَابࣱ مُّهِینࣱ﴾ [النساء ١٤]. وإذا كان هذا هو عاقبة كلٍّ من الطائعين والعاصين في الآخرة، فإنَّ لكلٍّ من الفئتين عواقب في الدنيا أيضاً ذكرها الله في كتابه الحكيم. ففي حقِّ الطائعين، قال سبحانه:ﭐ ﴿قُلۡ أَطِیعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِیعُوا۟ ٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡا۟ فَإِنَّمَا عَلَیۡهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَیۡكُم مَّا حُمِّلۡتُمۡۖ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهۡتَدُوا۟ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَـٰغُ ٱلۡمُبِینُ﴾ [النور ٥٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ﴾ [البقرة ١٢٠]. فمَنِ اتَّبع هدى الله لا يتيه في حياته؛ لأنَّه يعرف غايته في هذه الحياة والطريق القويم الموصِل إلى تحقيقها؛ أيْ لا يكون ضالاً، وكذلك لا يكون شقياً في حياته لا نفسياً ولا مادياً. قال سبحانه: ﴿فَإِمَّا یَأۡتِیَنَّكُم مِّنِّی هُدࣰى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَایَ فَلَا یَضِلُّ وَلَا یَشۡقَىٰ﴾ [طه ١٢٣]، وقال تعالى في حقِّ العاصين الذين لم يطيعوه: ﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِی فَإِنَّ لَهُۥ مَعِیشَةࣰ ضَنكࣰا وَنَحۡشُرُهُۥ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ أَعۡمَىٰ﴾ [طه ١٢٤]؛ أيْ حياةً مليئةً بالضيق والمشكلات المادِّية وغير المادِّية.
وقد تضمَّنت هذه النواميس (السُّنَن) أيضاً تقديم أمثلة (أحداث) حقيقية من واقع الحياة الإنسانية لأفراد أو أقوام سابقين؛ أمثلة لأُناس أخذوا بالـمُقدِّمات الإيجابية؛ أيْ بالأفعال التي يُحِبُّها الله تعالى، ويرضاها، وأمر الناس بفعلها، فأحرزوا النتائج الإيجابية؛ أيْ خيرهم وكمالهم الإنساني الـمُمكِن لهم في الدنيا أوّلاً، وفي الآخرة أيضاً كما وعدهم خالقهم وخالق هذه السُّنَن، فهذه الأمثلة التي يلزمهم جميعاً أنْ يقتدوا بها هي التي جعلت هؤلاء الناس داخلين في فئة “الذين أنعم الله عليهم”. أمّا الأمثلة الواقعية الأُخرى التي “ضربها” الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فهي لأفراد أو أقوام أخذوا بمُقدِّمات باطلة؛ أيْ أفعال لا يُحِبُّها الله تعالى، ولا يرضاها، ولم يأمر أحداً بفعلها، ونهى عن إتيانها، فكانت نتائج ذلك فساد نظام حياتهم، وضلال أعمالهم، واستحقاقهم العقوبات التي وقعت عليهم، ودخولهم في فئة “المغضوب عليهم”. ومن ثَمَّ، فإنَّ في هذه السُّنَن الإلهية عِبْرة للناس جميعاً؛ “عِبْرة بشرى” بالعاقبة الحَسَنة للطائعين، و”عِبْرة إنذار” للعاصين.
وقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى من وضع هذه النواميس (السُّنَن) أنْ يسير الناس في حياتهم، في كل جوانبها، وَفقاً لها دون إكراه، بل بإرادة حُرَّة، ومَردُّ ذلك إلى ما قدَّره الله تعالى للإنسان في عِلْمه الأزلي بإرادته الـمُطلَقة قبل خَلْقه، وقبل أنْ يكون “شيئاً مذكورا”. قال تعالى: ﴿هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَـٰنِ حِینࣱ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ یَكُن شَیۡـࣰٔا مَّذۡكُورًا﴾ [الإنسان: ١]؛ فالله تعالى خلق الإنسان لكي يعبده. قال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِیَعۡبُدُونِ﴾ [الذاريات ٥٦] وتتحقَّق هذه الغاية (العبادة) على الوجه الأتمِّ حين يكون كل سلوك -بلا استثناء- جليلاً أو حقيراً، كبيراً أو صغيراً، طاعةً لله سبحانه في “غاية الخضوع، وغاية المحبة”. وقد قضت إرادةُ الله -قبل خَلْقه الإنسان- أنْ يجعله خليفةً في الأرض. قال تعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَـٰۤىِٕكَةِ إِنِّی جَاعِلࣱ فِی ٱلۡأَرۡضِ خَلِیفَةࣰۖ﴾ [البقرة ٣٠]، ثم خلقه من ترابها. قال سبحانه: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابࣲ﴾ [فاطر ١١]، وجعل الأرض ميدان حياته وحركته. قال عَزَّ من قائل: ﴿وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ﴾ [الرحمن ١٠] وكلَّفه بتعميرها وإنشاء العمران فيها. قال تبارك وتعالى:ﭐ ﴿۞هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِیهَا﴾ [هود ٦١] ، ثم خلق للإنسان الموت والحياة؛[2] “ابتلاءً” وامتحاناً، ليرى كيف يعمل في هذه الحياة الدنيا، وليُقيِّم أعماله بميزانه الدقيق، ويُحدِّد له درجات الخير الحسن فيها. قال تعالى: ﴿تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِی بِیَدِهِ ٱلۡمُلۡكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ قَدِیرٌ الَّذِی خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَیَوٰةَ لِیَبۡلُوَكُمۡ أَیُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلࣰاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡغَفُورُ﴾ [الملك ٢] وقد اقتضت حكمة الله وعدله أنْ يجعل مهمة الإنسان في الخلافة وعمارة الأرض، وفي الابتلاء؛ لتتحقَّق الغاية القصوى (العبادة) واضحةً بيِّنةً؛ ولكيلا يضلَّ في حركته المطلوبة منه في امتحانه. ومن ثَمَّ، كانت السُّنَن الإلهية (النواميس) بمنـزلة الطرائق والشرائع التي يُمكِن للإنسان باتِّباعها وهدايتها أنْ يُمارِس حركته في الحياة وهو مُطمئِن وواثق بأنَّه إذا حقَّق الـمُقدِّمات المطلوبة، فإنَّ النتائج المرغوبة ستتحقَّق، وإنْ أهملها ولم يتَّبعها واتَّبع هواه ضلَّ، وشقي، “وكان أمره فُرُطاً”، وحقَّ عليه عقاب الله تعالى.
[وظيفة السنن الإلهية وسنة النصر]
وإذا كانت السُّنَن الإلهية قد وضعها الله سبحانه وتعالى، فإنَّه لم يضعها عبثاً بلا فائدة أو بلا جدوى، ومن تمام فِقْه السُّنَن الإلهية أنْ نتعرَّف الوظيفة التي تؤدّيها هذه السُّنَن في حياة الإنسان، وقد تقدَّمت إشارات إجمالية موجزة في ذلك، نقول في بيانها: إنَّ معرفة السُّنَن الإلهية تُعِين الإنسان على ألّا يضلَّ في حركته خلال حياته. والضالُّ هو الذي يجهل الغاية التي خُلِق من أجلها (عبادة الله)، ويجهل الطريق الأقصر والأصوب (الصراط المستقيم) الذي يوصِله بالسير عليه، ووَفقاً له، إلى تحقيق هذه الغاية، والمعرفة الصحيحة للسُّنَن الإلهية تُعِين على ذلك. وإذا كان تحقيق الإنسان الغاية التي وُجِد من أجلها يعني تحقيق خيره وكماله، فإنَّ معرفة حقيقة السُّنَن الإلهية تُعِين على تحقيق كماله اللائق به وخيره وسعادته. ويَتَّصِل بهذا المعنى القول بأنَّ معرفة الإنسان (فرداً، وجماعةً) للسُّنَن الإلهية وتطبيقها في واقعه الـمَعيش يُبعِد عنه الشقاء والضيق في حياته، سواء أكان الشقاء والضيق جسمياً ومادياً أم معنوياً؛ أي عقلياً، وروحياً، ووجدانياً.
وإذا كان عمران الأرض هو -بلفظ آخر- إنشاءُ حضارة أو إحياؤها، وهو جُمْلة جهود شاملة ومُتكامِلة يُنجِز فيها الإنسان ما يَلزمه من أدوات ووسائل تُيسِّر له فعل كل ذلك، وتُيسِّر له الدفاع عن نفسه من شرور الأعداء والطامعين في أرضه وثرواتها؛ فلا بُدَّ له أنْ يبدأ كل هذه الجهود بالتخطيط السليم له، مُبيِّناً فيها الأولويات، ومراعياً مبدأ “دفع الـمَضارِّ مُقدَّم على جلب المصالح”. ولا شكَّ في أنَّ معرفة السُّنَن الإلهية تُعِينه كثيراً على هذا التخطيط. وإلى جانب التخطيط السليم، فإنَّ السُّنَن الإلهية تفيده في الوصول إلى توقُّعات يوثَق بها، في ما يُعَدُّ أشبه بالتنبُّؤ العلمي.
ومعرفة السُّنَن الإلهية عامةً، وسُنَّة النصر بوجه خاص، تُسهِم في الأخذ بأسباب النصر الحقيقية؛ إذ يُعِين اتِّباعها على تحقيق النصر والتمكين للأُمَّة، والحفاظ على عِزَّتها، واستعادتها لحقوقها الـمُغتَصبة على اختلافها.
وإذا كان الإنجاز العلمي هو أحدُ العناصر الرئيسة لقيام الحضارات وبنائها، فإنَّ معرفة السُّنَن الإلهية في حياة الإنسان ومعرفة آيات الله الكونية تجعل الحصول على العِلْم أمراً مُمكِناً، فتَسْهُل بعد ذلك عمليات الإنجاز المادي وغير المادي، الذي به تنشأ الحضارات.
وأيضاً، فإنَّ معرفة السُّنَن الإلهية تُعِين على فهم مشكلات الحياة الواقعية، وتُعِين بعد ذلك على إيجاد الحلول لها، على اختلافها. ومعرفة السُّنَن الإلهية تفيد في تربية الأجيال وتثقيفهم والوعي بمشكلاتهم، فهذه المعرفة تَلزم الـمُربّي والداعية، فضلاً عن الحاكم والـمُصلِح.
وبوجه عام، فإنَّ في معرفة السُّنَن الإلهية عِبَراً في كل مجال من مجالات الحياة؛ إذ إنَّها تُبيِّن لنا نواميس حركة الحياة التي إذا تحقَّقت فيها الـمُقدِّمات تحقَّقت تبعاً لها النتائج.
والحقُّ أنَّ في كل مسألة من هذه المسائل تفصيلات يُمكِن أنْ يُوضِّحها أهل الاختصاص في مجالات الحياة المختلفة، ومن هنا، نجد أنَّ الحاجة ضرورية لإنشاء عِلْم السُّنَن الإلهية.
ثانياً: الثقافة السُّنَنية:
الثقافة السُّنَنية هي ثقافة منسوبة إلى السُّنَن الإلهية؛ وحتى نصل إلى فهمها، لا بُدَّ لنا من مرور سريع على مفهوم “الثقافة” بصورة عامة؛ إذ ما نحن بصدد بيانه هو “الثقافة” التي أضفناها إلى “السُّنَن”، فصار لدينا مصطلح “الثقافة السُّنَنية”.
[مفهوم الثقافة]
سنبدأ بتحديد مفهوم “الثقافة” في نظرنا؛ ليكون هو ما نبني عليه مفهوم “الثقافة السُّنَنية”، فنقول:
“الثقافة معرفة عملية مُكتسَبة، تنطوي على جانب معياري، وتتجلّى في السلوك الواعي للإنسان (فرداً، وجماعةً) في تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود بأجزائه المختلفة” (السيد أحمد، 2008، ص20-35).
أمّا الوجود فيُعَدُّ أعمَّ الأجناس، ويُطلَق عليه في عِلْم المنطق اسم جنس الأجناس. وهذا لا يُعرَّف إلّا بنفسه؛ فالوجود هو صفة لكلّ ما هو موجود، سواء كان من عالَـم الشهادة أو من عالم الغيب. وفي تاريخ الفلسفة تقسيمات مختلفة للوجود، ولكنَّ تقسيمنا للوجود هنا مأخوذ من القضية الوجودية الأولى؛ أعني قضية أنَّ ﴿ٱللَّهُ خَـٰلِقُ كُلِّ شَیۡءࣲۖ ﴾ [الزمر ٦٢]. وغيرها من الآيات الكريمة، وهو قسمان: الخالق، وهو واحد أحد لا شريك له في الخَلْق. والمخلوقات، وهي كثيرة جداً لدرجةٍ لا يُمكِن فيها حصْر أفرادها، ولكنَّ الـمُمكِن هو تصنيفها إلى أقسام كبيرة، وقد قسَّمناها إلى الأقسام الآتية:
الذات الفردية، والآخر (في دوائره العديدة)، والكون الطبيعي، والأفكار (يدخل فيها كل العلوم)، والوسائل والأدوات، والزمن، والغيب.
ولدينا في الثقافة مصطلحان ضروريان لفهمها؛ الأوَّل: مصطلح “الثقافة العامة؛ وهي معرفة عملية مُكتسَبة، تنطوي على جانب معياري، وتتجلّى في سلوك الإنسان الواعي في تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود، على نحوٍ مُجمَل يشمل المنطلقات، والأُسس، والمبادئ العامة، والضوابط” (السيد أحمد، 2008، ص32). والثاني: مصطلح الثقافة الخاصة؛ وهي معرفة عملية مُكتسَبة، تنطوي على جانب معياري، وتتجلّى في سلوك الإنسان الواعي في تعامله في الحياة الاجتماعية مع جانب مُحدَّد من الوجود. وجوانب الوجود الـمُحدَّدة لا حصْر لها. ولهذا، فإنَّ الثقافات الخاصة -في ضوء تحديداتنا- ستكون كذلك لا حصْر لها. فمثلاً: هناك ثقافة عسكرية، وهذه فيها ثقافات خاصة عديدة، وتوجد ثقافة طبية أو صحِّية، وهذه فيها ثقافات خاصّة عديدة، وهناك ثقافة صناعية، وكذا سياسية … إلى غير ذلك من أجزاء الوجود التي لا حصْر لها. وسنضرب مثالاً يُوضِّح هذا الفهم، فنقول: إنَّ المعرفة العملية بتعامل الإنسان مع مادَّة الخشب التي تتجلّى في سلوك النجّار هي ثقافة خاصّة، مجالها التعامل مع مادَّة الخشب، وكذلك المعرفة العملية في تعامل الحدّاد مع مادَّة الحديد، وكذلك يقال عن المعرفة العملية في تعامل رئيس شركة أو مؤسسة ما في إدارته للشركة أو المؤسسة، ويوصَف كلّ مَنْ يعرف كيفية التعامل مع هذا الجزء الـمُحدَّد بأنَّه مُثقَّف في هذا المجال الخاص. وبذلك، لا نرى أنَّ الـمُثقَّف هو إنسان من فئة نخبوية، يُدْلي برأيه في كل شؤون الحياة، ويتعامل مع القضايا في مختلف المجالات؛ فعامل النظافة -مثلاً- الذي يُتقِن مهنته هذه هو مُثقَّف في مجاله، وقد يكون لديه معرفة عملية عن النظافة لا يعرفها المسؤول عنه. وبطبيعة الحال، فقد لا يكون لديه ثقافة في التعامل مع أجزاء أُخرى من الوجود.
ولكنَّ هذا الـمُثقَّف بالثقافة الخاصّة يجب أنْ يكون لديه حدٌّ أدنى من الثقافة العامة فما فوقها؛ أيْ حدٌّ أدنى من المعرفة العملية الـمُرتبِطة بالمنطلقات، والمبادئ، والأُسس، والضوابط. وفي هذه المعرفة تفاوت بين الأفراد فيما فوق الحَدِّ الأدنى، وذلك بحسب جانب الوجود الذي يتعاملون معه. والثقافة العامة هي المرجعية الأخلاقية -بالمعنى الواسع والشامل للأخلاق- للثقافة الخاصّة (السيد أحمد، 2008، ص32-36). وهذه المرجعية لا تتجسَّد على أرض الواقع بصورة مستقلة، وإنَّما تتجسَّد في الثقافات الخاصّة عند تطبيقها في الحياة العملية. ومن هنا، فكل ثقافة خاصّة في التعامل مع جزء مُحدَّد من الموجود، مثل: التعامل في مهنة النجارة مع الخشب، والتعامل مع المحاصيل الزراعية في مهنة الزراعة، تختلف عن مثيلاتها في المجتمعات المختلفة وَفقاً للمرجعية العامة؛ أيْ وَفقاً للثقافة العامة السائدة في كلٍّ من هذه المجتمعات.
[ربط مفهوم الثقافة بمفهوم السنن الإلهية]
وبعد هذا التوضيح الموجز لمفهوم “الثقافة”، وبيان أنَّ ما يتجسَّد واقعاً هو ثقافات خاصة، سننتقل إلى ربط مفهوم “الثقافة” بمفهوم “السُّنَن الإلهية”، فنقول: لمّا كان الله سبحانه وتعالى هو “خالق كل شيء”، وكانت السُّنَن الإلهية (النواميس) تُنظِّم الحياة الإنسانية، وكانت الحياة الإنسانية والسُّنَن هي أجزاء من “كل شيء”؛ أيْ من المخلوقات، وكان كلّ جزء من المخلوقات هو جزءٌ من الوجود؛ فإنَّ المعرفة العملية بكيفية التعامل مع هذه الأجزاء، ومنها السُّنَن، تقع تحت عنوان: “الثقافة الخاصّة” (انظر تعريفها في ما تقدَّم آنفاً). ولأنَّ هذه السُّنَن عديدة؛ فإنَّنا نستطيع القول: إنَّ لكل سُنَّةٍ ثقافةً خاصّةً بها؛ أيْ معرفةً عمليةً بكيفية التعامل معها. وهذا التوضيح يُقرِّبنا من تحديد المقصود بمفهوم “الثقافة السُّنَنية”؛ إذ ستكون الثقافة السُّنَنية عامةً هي جُمْلة المعرفة العملية الـمُكتسَبة التي تنطوي على جانب معياري، وتتجلّى في سلوك الإنسان الواعي في تعامله في الحياة الإنسانية (الاجتماعية) مع السُّنَن الإلهية.
أمّا مرجعية هذه الثقافة السُّنَنية فستكون -بالضرورة- مرجعية الثقافة الإسلامية؛ ذلك أنَّ السُّنَن الإلهية مُستنبَطة من كلام الله سبحانه وتعالى، وأنَّ المبادئ والأُسس والقواعد والضوابط في مرجعية الثقافة الإسلامية مُستنبَطة من كلام الله سبحانه وتعالى، وليس من كلام غيره؛ فلا يُمكِن -والحال كذلك- أنْ تكون مرجعية المعرفة العملية في التعامل مع السُّنَن الإلهية غير مرجعية الثقافة الإسلامية؛ أي الثقافة الإسلامية العامة (السيد أحمد، 2008، ص36-42). ومن ثَمَّ، فإنَّ الـمُثقَّف بثقافة سُنَنية -في سُنَّة ما أو أكثر- لا بُدَّ أنْ يكون على معرفة ووعي بالثقافة الإسلامية العامة.
ما قدَّمناه من توضيح وتحديد لمفهوم “السُّنَن الثقافية” يتطلَّب ضرْب بعض الأمثلة على السُّنَن الإلهية التي لها تعلُّق بالأفراد، والجماعات (القوم)، والحضارات؛ بُغْيَةَ مزيد من البيان لمفهوم “الثقافة السُّنَنية”.
[مثال تطبيقي على سنة التقوى]
وسنبدأ بمثال على مستوى الأفراد، وهو سُنَّة التقوى، التي وردت الإشارات الواضحة إليها في عدد من الآيات الكريمة، وكانت فيها مُقدِّمات هذه السُّنَّة “أفعال التقوى”، وكانت النتائج الـمُترتِّبة على هذه الأفعال كلها نتائج إيجابية، دنيوية وأُخروية. قال الله تعالى مُقرِّراً سُنَّة التقوى: ﴿وَمَن یَتَّقِ ٱللَّهَ یَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجࣰا ویَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَیۡثُ لَا یَحۡتَسِبُۚ﴾ [الطلاق ٣]، فهاتان الآيتان -بحسب مصطلحات عِلْم المنطق- تُمثِّلان قضية شرطية متصلة لزومية؛ ما يعني وجود ارتباط حقيقي فعلي بين طرفيها (الـمُقدَّم والتالي)، وأنَّ الـمُقدَّم هنا عِلَّة للتالي؛ فتقوى الله هي عِلَّة جعْل الله للإنسان مخرجاً إذا مَرَّ بضيق في أحواله الحياتية، وهي عِلَّة لرزق يأتيه من عند الله دون تخطيط أو حسابات، ودون توقُّع. وبعد هذا الوصف المنطقي الموجز لهذه السُّنَّة الإلهية (سُنَّة التقوى) الواردة في هاتين الآيتين، فإنَّنا سنُعرِّج على “الثقافة السُّنَنية” الـمُرتبِطة بهذه السُّنَّة، وهي: المعرفة العملية الـمُكتسَبة التي تنطوي على جانب معياري، وتتجلّى في سلوك الأفراد الواعي في تعاملهم في الحياة مع سُنَّة التقوى. وهذا التحديد يعني أنْ يعرف الأفراد الأفعال التي توصَف بأنَّها أفعال تقوى، وكيفية القيام بها، والشروط اللازمة لتحقُّقها على أرض الواقع، وأنْ يعرفوا أيضاً النتائج التي تنجم عنها، وأنْ يعرفوا كذلك أمثلة واقعية تخصُّ أفراداً سابقين مارسوا أفعال التقوى في ما مضى، وكيف جاءت عواقب أفعالهم هذه، وأنْ يعرفوا أيضاً الأفعال التي هي مضادات لأفعال التقوى، وأنْ يعرفوا كذلك أمثلة واقعية تخصُّ أفراداً سابقين مارسوا هذه الأفعال (المضادة لأفعال التقوى)، وكيف جاءت عواقب أفعالهم هذه.
وإضافةً إلى ما تقدَّم من معرفة عملية، فلا بُدَّ من معرفة الجانب المعياري الذي تتضمَّنه المعرفة بأفعال التقوى، ونقصد بالجانب المعياري هنا معرفةَ المعيار -الصادر عن فرد ما- الذي تقاس به، وفي ضوئه، أفعال التقوى، قرباً من هذا المعيار أو بُعْداً عنه، ويُمثِّل -في الوقت نفسه- الحالة الـمُثلى وأكثر الحالات كمالاً التي يسعى المتقون للوصول إليها، أو الاقتراب منها ما أمكنهم ذلك.
ثمَّ إنَّ هذا المعيار مُضمَر في أحكامنا على أفعال التقوى، وسلوك فرد ما بأنَّه تقي أو غير تقي. فمثل هذا الحكم لا يكون مقبولاً إلّا إذا كان لدينا، وفي أذهاننا، هذا المعيار الذي أصدَرْنا حُكْمنا في ضوئه. وبطبيعة الحال، فإنَّ كل هذه المعرفة التي أشرْنا إليها هنا ليست معرفة فطرية، وإنَّما هي معرفة مُكتسَبة، يُحصِّلها الإنسان بالطرائق المختلفة لاكتساب المعرفة. وحين نحصل على كل هذه المعرفة -المشار إليها هنا- يصبح لدينا ثقافة سُنَنية خاصة بسُنَّة التقوى. وقد تَرِدُ إلى الذهن الآن أسئلةٌ عدّة، أهمُّها: كيف نُحصِّل المعرفة بأفعال التقوى؟ وما مصادرها؟ والجواب واضح وهو أنّ مصدر هذه المعرفة -ونحن في سياق الحديث عن السُّنَن الإلهية- هو كلام الله ووحيه؛ أيْ كتاب الله (القرآن الكريم) وصحيح سُنَّة رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم، الذي يُمثِّل الهداية الكاملة (الإسلام).
أمّا بالنسبة إلى المعرفة بالأمثلة الواقعية الخاصّة بالأفراد الذين اتّبعوا سُنَّة التقوى، أو الذين خالفوها، فإنَّنا نجد جانباً منها في الكتاب والسُّنَّة، وجانباً آخرَ نحتاج إلى البحث عنه في السِّيَر وكتب التاريخ، والسَّيْر في الأرض بنظر فاحص مُدقِّق، كما ورد في أمر الله تعالى وتوجيهه في أكثر من آية كريمة. ومن ذلك قوله تعالى: ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ [النحل: 36]، وقوله تعالى: ﴿فَسِیرُوا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُوا۟ كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِینَ﴾ [آل عمران ١٣٧]، وقوله عَزَّ من قائل: ﴿أَفَلَمۡ یَسِیرُوا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَیَنظُرُوا۟ كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ ﴾ [غافر ٨٢].
وهناك مصدر عقلي يفيدنا أحياناً في معرفة مضادات أفعال التقوى؛ إذ الأفعال المتضادة لا تجتمع معاً، وقديماً قالوا: “وبضدِّها تتميَّز الأشياء”؛ فحين نعرف أفعال التقوى يَسْهُل عقلاً معرفة مضاداتها.
إنَّ هدف هذا البحث -في القسم الثاني منه- هو بيان معنى الثقافة السُّنَنية وكيفية الوصول إليها. وفي كلامنا هنا عن سُنَّة التقوى لم نقصد أنْ نُبيِّن أفعال التقوى تفصيلاً، وإنْ كان يُمكِن القول بوجه عام وباطمئنان: إنَّ هذه الأفعال يجمعها الالتزام بالأحكام، والتوجيهات، والمواعظ، والأخلاق الواردة في الإسلام؛ كتاباً وسُنَّةً صحيحةً، والمبنية على الإيمان بالله والإخلاص له. وأمّا تفصيل أفعال التقوى فيدخل في موضوعات العِلْم الجديد الذي نرى ضرورة العمل على ترسيخه عِلْماً مستقلاً، وهو “عِلْم الثقافة السُّنَنية” الذي نرى أنَّه سيكون عِلْماً مُشتَقّاً من العِلْم الأوسع: “عِلْم الثقافة الإسلامية” (مثاله منهجياً: عِلْم المقاصد الـمُشتَقُّ من عِلْم أصول الفِقْه)، ونرى أنَّنا بحاجة إلى عِلْم الثقافة السُّنَنية الذي يحتاج إلى جهود الباحثين المتضافرة قبل إعلانه عِلْماً مستقلاً.
ولإتمام التوضيح لِما نحن بصدده بالأمثلة، سنورد آيات كريمات أُخر تُقرِّر سُنَّة التقوى في صورة قضايا شرطية لزومية، لها الـمُقدَّم نفسه، ولكنَّ التالي أي النتائج في كلٍّ منها مختلف:
قال تعالى: ﴿وَمَن یَتَّقِ ٱللَّهَ یَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ یُسۡرࣰا﴾ [الطلاق ٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَن یَتَّقِ ٱللَّهَ یُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَیِّـَٔاتِهِۦ وَیُعۡظِمۡ لَهُۥۤ أَجۡرًا﴾ [الطلاق ٥]، وقال سبحانه: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ یَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانࣰا وَیُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَیِّـَٔاتِكُمۡ وَیَغۡفِرۡ لَكُمۡۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِیمِ﴾ [الأنفال ٢٩]، وقال تبارك وتعالى: ﴿۞ لِلَّذِینَ ٱتَّقَوۡا۟ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّـٰتࣱ تَجۡرِی مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُ﴾ [آل عمران ١٥]، وقال عَزَّ من قائل: ﴿وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰۤ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوۡا۟ لَفَتَحۡنَا عَلَیۡهِم بَرَكَـٰتࣲ مِّنَ ٱلسَّمَاۤءِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ [الأعراف ٩٦]
إنَّ القول في هذه الآيات هو القول نفسه الـمُتقدِّم في الآية السابقة، من حيث وجود “أفعال التقوى” التي هي الـمُقدِّمات، والنتائج التي تنجم عنها؛ دنيوية وأُخروية.
وهذه الآيات الـمُعبِّرة عن “سُنَّة التقوى” تشير إلى نتائج أفعال التقوى في الدنيا والآخرة؛ فالنتائج الدنيوية -بحسب الآيات الواردة آنفاً- هي: المخرج من الضيق، والرزق من حيث لا يحتسب، وتيسير الأمور، والقدرة على التفريق بين الحقِّ والباطل، وحصول البركات والخير للأفراد والجماعات.
أمّا النتائج الأُخروية -بحسب هذه الآيات- فهي: تكفير السيئات، والمغفرة، وجنات تجري من تحتها الأنهار.
وفي الآية السادسة والتسعين من سورة الأعراف مَلْحَظٌ يحتاج إلى التنويه؛ ذلك أنَّنا صنَّفْنا “سُنَّة التقوى” على أساس أنَّها سُنَّة فردية، ولكنَّ هذه الآية الكريمة تشير إلى سُنَّة جماعية، هي أنَّ أهل القرى (الجماعات) إذا قاموا بأفعال التقوى جاءت النتيجة جماعية؛ فالبركات التي ستنهال عليهم من السماء والأرض ستصيب الأفراد وتصيب الجماعة، وفي هذا تنبيه على الجدلية الـمُتبادَلة بين الفردي والجماعي. وهذا شأن الإسلام عامةً؛ فالعبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج هي تكاليف فردية، ولكنَّ نتائجها -كما هو معلوم- فردية وجماعية في الوقت نفسه. ومن ثَمَّ، فإنَّ الـمُشتغِل ببحث الثقافة السُّنَنية يحتاج إلى أخذ هذه المسألة بالاعتبار.
وفي ضوء ما تقدَّم، يُمكِن أنْ نُجمِل فهمنا للثقافة السُّنَنية الخاصّة “بسُنَّة التقوى” بالقول الآتي: هي معرفة أفعال التقوى وبيان لها، ومعرفة شروط كلٍّ منها، ومعرفة وبيان لجميع النتائج اللازمة من هذه الأفعال، ومعرفة أمثلة تتعلَّق بأفراد مارسوا أفعال التقوى في الماضي ونتيجة ذلك، وأمثلة تخصُّ أفراداً مارسوا مضادات أفعال التقوى ونتيجة ذلك.
[مثال آخر بسنة النصر]
بعد أنْ قدَّمنا مثالاً يُبيِّن معنى الثقافة السُّنَنية الـمُرتبِطة بسُنَّةٍ على مستوى الأفراد هي “سُنَّة التقوى”، سنُقدِّم الآن مثالاً آخرَ لتعرُّف الثقافة الـمُتعلِّقة بسُنَّةٍ على مستوى الجماعات، وأقصد بذلك “سُنَّة النصر” للجماعات والأقوام.
وفي ما يأتي بعض الآيات التي تُمثِّل هذه السُّنَّة الإلهية:
قال تعالى: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ﴾ [محمد ٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ﴾ [الحج ٤٠].
هاتان الآيتان الكريمتان تعبّر كلّ منهما عن سُنَّة إلهية واحدة، يُمكِن تسميتها سُنَّة النصر، وكل واحدة منهما هي قضية شرطية متصلة لزومية، فيها مُقدَّم يَلزم منه التالي، والتالي هو النتيجة لتحقُّق الـمُقدَّم.
ففي الآية الأولى، نجد أنَّ القضية الشرطية اللزومية هي ﴿إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ﴾ ، وأنَّ الـمُقدَّم فيها هو نصْر القوم أو الجماعة لله سبحانه، وهذا إنْ حدث وتحقَّق حدث التالي، وهو -هنا- نصْر الله للقوم أو الجماعة وتثبيت أقدامهم، فلا يتراجعون في ميدان المعركة (على أقدامهم).
والآية الثانية هي أيضاً قضية شرطية متصلة لزومية -كما الأولى-، ويُمكِن صياغتها -للتوضيح- في الصورة الآتية:
القوم الذين ينصرون الله ينصرهم الله تعالى؛ فالـمُقدَّم هو نصْر القوم لله تعالى، وحدوثه يَلزم منه نصْر الله تعالى لهم. ولأنَّ ساحات النصر وميادينه مُتعدِّدة، كأنْ يكون في معركة عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو فكرية أو غير ذلك؛ فإنَّ هذا الناموس (السُّنَّة) ينطبق على كل حالة فيها صراع بين المؤمنين وغير المؤمنين.
وإذا أردنا أنْ نعرف الثقافة السُّنَنية الخاصّة بـ”سُنَّة النصر”، وجب علينا -كما أوضحنا في سُنَّة التقوى- أنْ نعرف الأفعال التي يتحقَّق بها (الـمُقدَّم) في القضية الشرطية هنا؛ أي الأفعال التي بها ينصر الناسُ (أو القوم) الله سبحانه “الغني الحميد”، وأنْ نعرف شروط هذه الأفعال التي تجعلها كذلك، وأنْ نعرف أمثلة واقعية حدثت في حياة أقوام أو جماعات، وكان فيها نصْر الله لهم نتيجةَ نصْرهم لله سبحانه، وأنْ نعرف أمثلة واقعية أُخرى في حياة أقوام أو جماعات لم يحدث فيها نصْر لهم من الله نتيجةً لعدم نصْرهم الله سبحانه، وأنْ نعرف كذلك -كلَّما أمكن- تفاصيل النصر الذي يتحقَّق وَفق هذه السُّنَّة.
وإضافةً إلى ما تقدَّم، فإنَّه يَلزم أنْ نعرف الجانب المعياري الذي تتضمَّنه المعرفة بالأفعال التي بها ينصر القومُ الله سبحانه وتعالى؛ أي المعيار الذي تقاس في ضوئه هذه الأفعال قرباً أو بُعْداً، وهي الحالة الـمُثلى وأكثر الحالات كمالاً التي يُعبِّر عنها هذا المعيار، وهي الحالة التي يسعى الذين يريدون أنْ ينصروا الله لتحقيقها أو الاقتراب منها ما أمكن؛ لكي يتحقَّق لهم النصر من الله تعالى.
وهذه المعرفة -المشار إليها في ما تقدَّم- بكل أجزائها هي -بطبيعة الحال- معرفة مُكتسَبة يحتاج القوم إلى بذل الجهد لاكتسابها بطرائق الاكتساب المناسبة، وإذا حاز المرء (أو القوم) هذه المعرفة كلها كانت لديه ثقافة سُنَنية خاصة بـ”سُنَّة النصر”.
وأمّا مصدر هذه المعرفة، وكيفية الوصول إليها، فيكون بالهداية الإلهية الكاملة الـمُتمثِّلة في كتاب الله وسُنَّة نبيِّه الخاتم الصحيحة؛ إذ فيهما ذكر أو إشارة للأفعال التي ينصر الناسُ بها الله سبحانه، وفيهما أمثلة واقعية على كلٍّ من الفريقين؛ الذين نصروا الله فنصرهم، والذين لم ينصروا الله فخذلهم. وكذلك نحصل على قَدْر من هذه المعرفة المطلوبة -كما قلنا في سُنَّة التقوى فيما تقدَّم- من سِيَر الأُمم والأقوام السابقين وتاريخهم، ومن السَّيْر في الأرض والنظر. قال تعالى: ﴿كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِینَ﴾ [النحل ٣٦] وقال سبحانه: ﴿كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِینَ﴾ [النمل ٦٩] ، وقال تعالى على وجه العموم: ﴿كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ﴾ [محمد ١٠]، سواء كانت هذه العواقب إيجابية فيها خيرهم أو سلبية فيها خذلانهم وهلاكهم.
إنَّ اكتساب هذه الثقافة السُّنَنية الخاصة بـ”سُنَّة النصر”، على نحوٍ مُفصَّل وتامٍّ، يحتاج إلى جهد مُتخصِّص غير قليل في اكتسابها؛ فهذه الثقافة تَلزم القادة في الدولة، وتَلزم أيضاً قادة الجيوش وغيرهم من المسؤولين؛ لكي يُحقِّقوا بتطبيقها نصْر الله لهم على أعدائهم.
وإذا بحثنا في القرآن الكريم، فلن نجد -بطبيعة الحال- كلاماً مُفصَّلاً عن أيِّ جانب من جوانب هذه الثقافة السُّنَنية الخاصة بـ”سُنَّة النصر”، ولكنَّنا سنجد إرشاداً إلى المبادئ الـمُهِمَّة والضرورية لنصْر الأقوام لله الذي به يتحقَّق النصر على الأعداء. وهذه المبادئ تُستنبَط من الآيات القرآنية الـمُتعلِّقة بالنصر، ومن الألفاظ الـمُقارِبة لها وسياقاتها، مثل: الظفر، والفوز؛ إذ نجد أنَّ جوهر الأفعال التي ينصر بها المؤمنون الله سبحانه هي طاعته بفعل أوامره وترك ما نهى عنه، والقيام بذلك بإخلاصٍ لله، وتوكُّلٍ عليه.
وسنضرب مثالاً على أمر إلهي جاء عاماً دون تفصيل، وهو أمره بالاستعداد لمواجهة الأعداء بأنواع القوَّة، بقَدْر استطاعة القوم أو الجماعة. قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ﴾ [الأنفال ٦٠]، وقد فهم العلماء من لفظ “القوَّة” جميع أشكال القوَّة: المادِّية من الأفراد والعتاد اللازم بكل أشكاله، والمعنوية مثل التخطيط السليم أوَّلاً، ثمَّ التقوى والثبات في مواجهة العدوِّ، والصبر، والإخلاص لله، والثقة به، والتوكُّل عليه. وجميع أشكال القوَّة هذه مطلوبٌ الإعداد لها، ولكنْ بحسب استطاعة القوم وإمكاناتهم؛ ذلك أنَّ الله تعالى لا يُكلِّف الناس ما لا يستطيعون فعله أو القيام به.
وبحسب واقع الحال، وعلى مَرِّ التاريخ، فإنَّ تعرُّف الثقافة السُّنَنية الخاصة بـ”سُنَّة النصر” يحتاج إلى جهد في بيان ذلك رُبَّما أكبر ممّا يَلزم الثقافة الخاصة بسُنَن أُخرى؛ فهذه الثقافة التي تختصُّ بإعداد القوَّة المادِّية تحتاج إلى خبراء عسكريين، واقتصاديين، وسياسيين، وإعلاميين، وتربويين، ودعويين (مُتخصصين في الدعوة)، وهي ليست كل الأفعال التي ينصر بها المؤمنون الله سبحانه. وهذا يُؤكِّد أنَّ تحصيل الثقافة السُّنَنية الخاصة بـ”سُنَّة النصر” يتطلَّب جهوداً بحثيةً علميةً مُتخصِّصةً ومُتكامِلةً، للوصول إلى تمام الثقافة (المعرفة العملية) الخاصّة بهذه السُنَّة.
وكما لاحَظْنا وجود جانب جماعي في سُنَّة التقوى الـمُتعلِّقة بالأفراد، فإنَّنا نلحظ هنا في سُنَّة النصر الـمُتعلِّقة بالجماعات وجود جانب فردي؛ إذ إنَّ جدلية الاجتماعي والفردي واردة في هذه السُّنَّة أيضاً، فقوله تعالى: ﴿وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ﴾ [الحج ٤٠]. يُفهَم على مستوى الجماعات والقوم، وعلى مستوى الأفراد أيضاً. ويُؤكِّد هذا المعنى قوله تعالى في نصره نبيِّه نوح عليه السلام: ﴿وَنَصَرۡنَـٰهُ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِینَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔایَـٰتِنَاۤ﴾ [الأنبياء ٧٧]،وقوله سبحانه في نصره سيِّدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدۡ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذۡ أَخۡرَجَهُ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ ثَانِیَ ٱثۡنَیۡنِ﴾ [التوبة ٤٠]، وقوله تعالى في نصره لغير الأنبياء: ﴿وَمَنۡ عَاقَبَ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیۡهِ لَیَنصُرَنَّهُ﴾ [الحج ٦٠]، ويُفهَم من هذه الجدلية أنَّه يجب على الأفراد -كما الجماعات- أنْ ينصروا الله، ليتحقَّق لهم النصر الفردي والنصر الجماعي.
وفي ضوء ما تقدَّم، فإنَّنا نُجمِل فهمنا للثقافة السُّنَنية الخاصة بـ”سُنَّة النصر” بالقول الآتي:
هي معرفة وبيان الأفعال التي ينصر القومُ (المؤمنون) بها الله سبحانه، ومعرفة شروط كل واحد من هذه الأفعال، ومعرفة وبيان جميع النتائج اللازمة من هذه الأفعال، ومعرفة الأفعال المضادة لأفعال نصر الله والنتائج الـمُترتِّبة عليها، ومعرفة أمثلة على أقوام مارسوا أفعالاً نصروا الله فيها ونتيجة ذلك، وأمثلة على أقوام لم ينصروا الله بأفعالهم ونتيجة ذلك (وما أحوج الأُمَّة اليوم إلى هذه الثقافة!).
(*) دكتوراه في الفلسفة الإسلامية، أستاذ جامعي في عدد من الجامعات الأردنية. البريد الإلكتروني: [email protected]، والعناوين التي جاءت بين معقوفتين [] هي من وضع المحرر.
(أحمد، عزمي طه السيد (2023). فقه السُّنَن الإلهية والثقافة السُّنَنيّة، مجلة “الفكر الإسلامي المعاصر”، مجلد 29، العدد 105، 129-164. DOI: 10.35632/citj.v29i105.7723).
[1] الهداية لغةً: البيان والإرشاد، واصطلاحاً: المعرفة بالغاية التي تتوجَّه إليها أفعال الإنسان كلها، ومعرفة أقصر الطرائق وأصوبها لتحقيق هذه الغاية، ومعرفة النماذج الواقعية للذين تمثَّلوا الهداية ليُقتدى بسلوكهم، وهم “الذين أنعم الله عليهم“، ومعرفة النماذج الواقعية للذين لم يتمثَّلوا الهداية؛ لكي لا نقع في مثل أفعالهم، وهم “المغضوب عليهم“. ولا تتمُّ الهداية إلّا بتطبيق هذه المعرفة في حياتنا وسلوكنا (هذا الفهم مستمد من تأمُّل سورة الفاتحة).
[2] الموت هو انفصال الروح عن الجسد، وآيات القرآن تُؤكِّد وجود الروح منفصلة عن الجسد قبل خَلْق الإنسان؛ أيْ موتها. والحياة هي اتحاد الروح بالبدن بقدرة الله (والله أعلم).

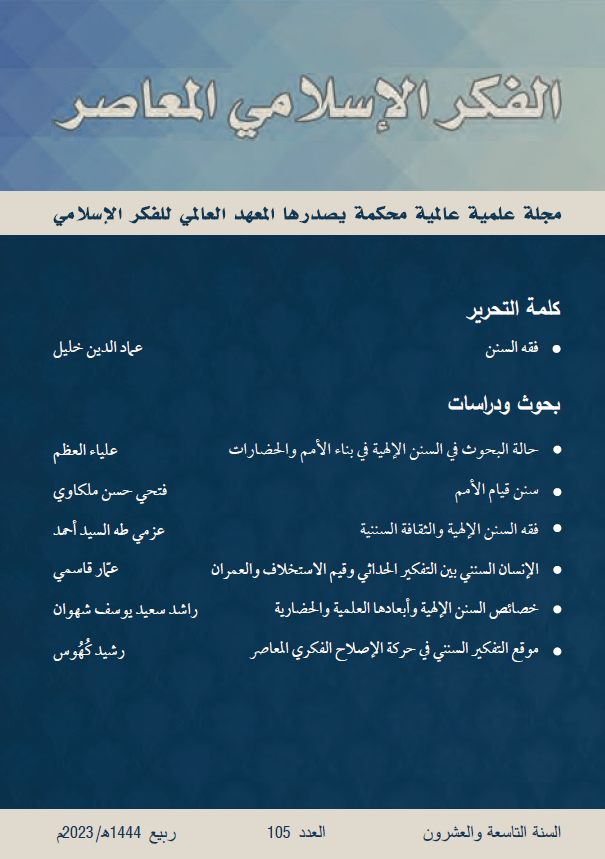



I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂