بقلم أ.د. أحمد حسن فرحات(*)
سنن الكون وطبائع الخلق:
أما سنن الكون وطبائع الخلق، فلم ترد في القرآن بلفظ “السنن”.
ومن ثم فالأصل ألا تكون مشمولة باللزوم المستفاد من قوله تعالى:
﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 62]
لأن استقراء استعمال “سُنَّة الله” في القرآن يرينا أنها واردة في سنن التاريخ والاجتماع. ومن ثم لا يجوز تعميمها على كل السنن بدلالة النص، لأن الأصل مراعاة مورد الاستعمال، كما لا يمكن أن نجعل اللزوم لسنن الكون بطريق القياس على سنن التاريخ والاجتماع، لأنه قياس مع الفارق، ويظهر ذلك فيما يلي:
– سنن الكون وطبائع الخلق من فعل الله المبني على المشيئة والحكمة، وقد تقتضي المشيئة والحكمة التغيير والتبديل، ومن هنا كانت المعجزات خرقاً لقوانين الكون، وهذا تبديل قد حصل.
– أما سنن التاريخ والاجتماع: فإنها وإن كانت من فعل الله المبني على المشيئة والحكمة، إلا أن فيها معنى ترتب هذا الفعل على عمل الإنسان، من خير أو شر. ومن ثم كان فيها معنى العدل، والجزاء. ومن ثم كان اللزوم فيها من مقتضيات العدل الذي هو صفة ثابتة ودائمة لله عز وجل. ومن هنا أخبرنا الله تعالى بأنها لن تتبدل ولن تتحول، لأن من العدل: التسوية بين المتماثلات، والمخالفة بين المختلفات، واطراد التماثل والتخالف.
وبناءً على هذا نستطيع أن نقول إن سنن الكون وطبائع الخلق ليس اطرادها لازماً، لأن الله لم يخبرنا بلزومه، ولأنه لا يمكن قياسه على ما أخبرنا بلزومه، لوجود الفارق. ولأن الواقع المشاهد والمحسوس أن التغيير والتبديل فيها ممكن، والمعجزات الخارقة دليل واضح على ذلك.
ولكننا مع ذلك نرى الاطراد فيها غالباً، والثبات فيها عاماً.
ولكن اللزوم لا دليل عليه، أما الاستدلال على اللزوم بالتجارب العملية التي تترتب فيها الآثار على الأسباب، فإن هذه التجارب تفيد العموم، ولا تفيد اللزوم. ومن ثم فلا نستطيع أن نجزم بأن التجارب التي ستكون في المستقبل ستترتب عليها نفس النتائج، التي ترتبت على مثيلاتها من التجارب السابقة، وإن كنا نرجح أن تكون كذلك ([1]).
ومع هذا فيمكن للإنسان أن يتعامل مع هذا العموم المطرد، والذي لا يكاد ينخرق إلا في حالات استثنائية.
وهكذا نرى أن الذين جعلوا سنن الكون داخلة تحت السنن التي لا تتبدل ولا تتحول، اضطروا إلى تقييد ذلك بطلاقة المشيئة، ليفسروا ذلك الاستثناء الذي يخرق السنن الكونية كالمعجزات. وربما اضطر بعضهم إلى التعسف في التأويل أو إنكار المعجزات. ليستقيم له ما ذهب إليه من لزوم هذه السنن. وربما رأي البعض الآخر أن التغيير والتبديل الحاصل دليل على أن السُنَّة لم تتحقق لفقد شرط، أو وجود مانع، ومن ثم فلم تكن سُنَّة لفوات الشرط، او لوجود المانع. ولكن مثل هذا القول لا يفسر لنا وجود المعجزات على أية حال.
وعلى الرغم من كل ما قيل في شأن السنن الكونية من لزوم أو عموم، فلابدَّ من العمل على أساسها، ولا ينبغي إهمالها بحجة عدم حتميتها، وبخاصَّة إذا علمنا أن المعجزات التي تخرق السنن الكونية، قد انتهت بانتهاء النبوات، مما يجعل خرق السنن الكونية مستبعداً، كما أنَّ إهمال هذه السنن لن يؤدي إلا إلى الفوضى وعدم الاستقرار، وإذا كان الإسلام يوجب العمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية، فمن باب أولى أن يوجبه في السنن الكونية التي تفيد العموم، ولا تفيد اللزوم.
سنن الإنسان.. وسنن الإيمان:
خلق الله تعالى الإنسان كما خلق الكون والمادة، ومنحه من الطبائع والغرائز والقوى ما يقيم حياته على هذه الأرض، وجعل حياته على هذه الأرض لغاية أكبر من مجرد الاستمرار في الحياة – كما هو شان عالم المادة – ومن ثم كان تميزه عن بقية المخلوقات بالعقل والاختيار والقدرة على الفعل والتغيير في حياته طبقاً للوظيفة المختصة به.
وهذه الوظيفة محددة بالاستخلاف في الأرض القائم على شريعة الله سبحانه المنزلة، ومن ثم فالإيمان بهذه الشريعة وتطبيق ما جاءت به من هداية في جميع شؤون الحياة، يدخل تغييراً كبيراً على حياة الإنسان، حتى ليمكن القول إنه يغدو خلقاً آخر بعد دخوله في الإسلام، واهتدائه بتوجيهاته وأحكامه. الأمر الذي يجعل الفارق كبيراً بين الإنسان المسلم، والإنسان غير المسلم. ومن ثم فإن السنن التي تحكم الحياة الإنسانية التي لا تخضع لشريعة الإسلام، لا يمكن أن تبقى شاملة للإنسان المسلم دون تعديل، بعد أن دخل الإسلام كعنصر معدَّل ومؤثّر في تغيير الإنسان ليكون “الإنسان المسلم”.
ويمكن توضيح هذه الفكرة بالأمثلة التالية:
– يقول الله تعالى: ﴿۞إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا١٩ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعا٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا٢١ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ٢٢ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ﴾. المعارج [19-23]
ويلاحظ هنا استثناء المسلم المصلي الدائم على صلاته مما فطر عليه الإنسان من الهلع، ومن جزعه من الشر الذي يمسه، ومن منعه الخير الذي يعطى، فكأن الإنسان المسلم أصبح فعلاً خلقاً آخر بتأثير الصلاة، على النقيض من الإنسان المجرد من الإسلام. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر أو نزلت به شدة فزع إلى الصلاة، نظراً لما لها من التأثير في هذا الجانب.
ويقول الله تعالى: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ -النساء: 128-.
فالشح إذن حاضر في النفس الإنسانية، خلقت على هذا، وتستمر عليه، إلا أن يعدل ذلك بشريعة الله، عن طريق الزكاة والصدقات التي تطهر المزكي من هذا الشح:
﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ -التوبة: 103-
وهكذا يتحول التكالب على المال والاستئثار به بفعل الشريعة، إلى إيثار يقي المسلم من الشح، الذي كان حاضراً في نفسه:
﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ -الحشر: 9-
ومنه قوله تعالى:
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ -التغابن: 16-.
وهكذا فإن “سنن الإنسان” تسري على الإنسان الفطري أو الطبيعي مع جميع غرائزه، كما وهبها إليه الله تعالى.
ولكن سنن الإيمان: تسري على الإنسان المسلم، وهو الذي تخضعه العقيدة الإسلامية إلى عملية شرطية من شأنها الحد من طغيان الغرائز وتنظيمها في علاقة وظيفية، مع مقتضيات العقيدة الإسلامية.
فالعملية الحيوانية التي تمثلها الغرائز- بصورة محسوسة- لم تلغ هنا ولكنها انضبطت بقواعد نظام معين.
وفي هذه الحالة: يتحرر الإنسان جزئياً من القانون الطبيعي، الذي فطر عليه جسده، ويخضع في كليته إلى المقتضيات الروحية، التي تبعثها العقيدة الإسلامية في نفسه، بحيث يمارس حياته في هذه الحالة الجديدة، حسب قانون الروح..
وهكذا كانت روح بلال رضي الله عنه هي التي تتكلم وتتحدى بلغتها الدم واللحم، كما أن ذلك الصحابي كأنه يتحدى بسبابته المرفوعة الطبيعة البشرية، ويرفع بها في لحظة معيَّنة مصير الدين الجديد.
كما أنها هي نفسها تتحدث بصوت تلك “المرأة الزانية” التي اقبلت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتعلن عن خطيئتها وتطلب إقامة حد الزنا عليها. فالوقائع هذه جميعها تخرج عن معايير الطبيعة” ([2]).
وبناء على هذا فإن العقيدة الإسلامية بضبطها للغرائز البشرية، بالحد من طغيانها، فإنها بالمقابل توجه هذا الفائض من قوة الغرائز، باتجاه القيم الخلقية والمُثل العليا، التي تجعل لحياة المسلم هدفاً ومعنى، تهون في سبيله التضحيات، الأمر الذي يجعل من المسلم قوة تتجاوز المألوف من قوة الإنسان الطبيعي. وهذا يفسر لنا فريضة الإسلام على المسلم: أن يصمد أمام عشرة من المشركين في أول الإسلام، حيث تم شحن طاقته الإيمانية إلى حدها الأعلى. أو أن يصمد أمام اثنين من المشركين – في حال كون طاقته الإيمانية في حدها الأدنى – كما يفسر لنا كثيراً من المواقف التاريخية التي انتصر فيها الإسلام على خصومه، مع قلة العَدَد والعُدة، وهو ما عبَّرت عنه الآيات القرآنية: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ إِن يَكُن مِّنكُمۡ عِشۡرُونَ صَٰبِرُونَ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٞ يَغۡلِبُوٓاْ أَلۡفٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَفۡقَهُونَ٦٥ ٱلۡـَٰٔنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمۡ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمۡ ضَعۡفٗاۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٞ صَابِرَةٞ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمۡ أَلۡفٞ يَغۡلِبُوٓاْ أَلۡفَيۡنِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾[الأنفال:65-66].
﴿…قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 249].
(*)أستاذ التفسير وعلوم القرآن في عدد من الجامعات، وهذا المقال استكمال لدراسة طويلة نوالي نشرها في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى.
الهوامش:
(1) يذكر العقاد في كتاب الفلسفة القرآنية أن التلازم بين الأسباب والنتائج في الوقائع الطبيعية ليس تلازماً عقلياً كتلازم المقدمة والنتيجة في القضايا العقلية، وإنما هو تلازم المشاهدة والإحصاء، وغاية ما نملكه فيه أن نسجل هذه المشاهدة أو هذا الإحصاء… فكل ما هنالك – مما يسمى بالأسباب الطبيعية – إنما هو مقارنات في الحدوث… ولا تفسير فيها أمام العقل لتعليل الإيجاد). انظر المجموعة الكاملة للعقاد م/7 الإسلاميات 3/24.


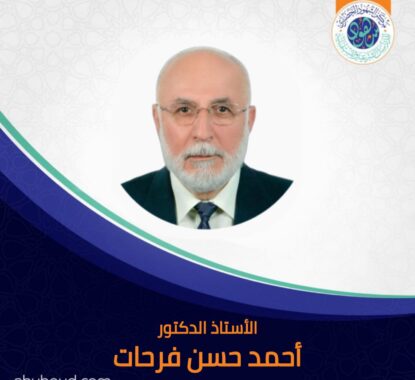



5j6wqe