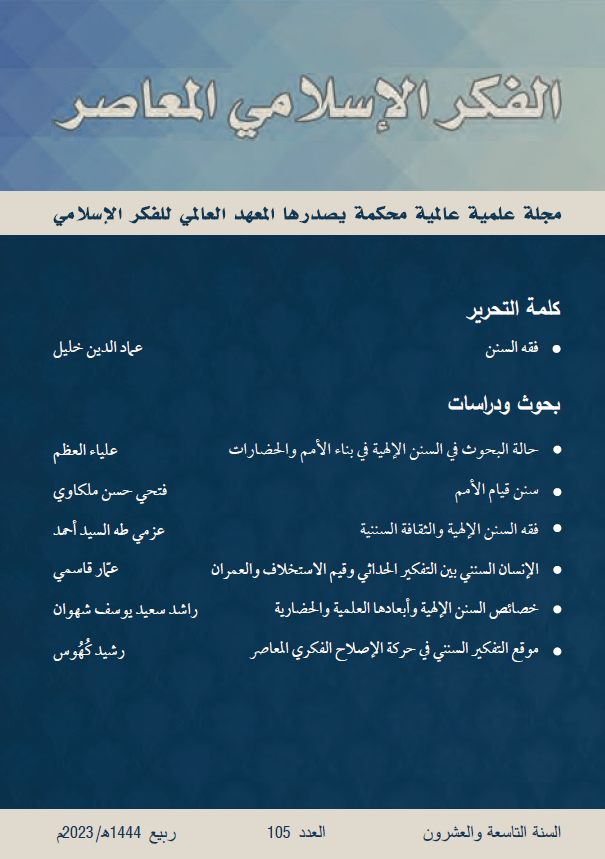بقلم الدكتور عمّار قاسمي(*)
الملخص

ولَّد انشغال الفكر البشري بمسألة أصل الكون ونشأته، من حيث هو تركيب مُنظَّم منذ وقت مُبكِّر، ثلاثة اتجاهات مركزية؛ الأوّل: اتّجاه اللا أدرية الذي ولَّد الخُرافة والسِّحْر، ويعتمد على المصادفة في تفسير جميع الظواهر الكونية. والثاني: الاتجاه الحلولي الذي يرى أنَّ الكون قد أنشأ نفسه بنفسه، وأنّه اتخذ صوراً مختلفةً لفكرة واحدة، يُعبِّر عنها كل فيلسوف بطريقته الخاصة، لكنَّه يُكرِّر الشيء نفسه منذ زمن ديمقريطس وهرقليطس إلى يوم الناس هذا. والثالث: الاتّجاه الذي يقول: إنَّ الكون قد أوجدته قوَّة مستقلة عنه. ويتفرّع هذا الاتجاه إلى اتجاهين، هما: الاتجاه الديني الذي يقول بالخالق، والاتجاه الفلسفي الإغريقي الذي يقول بالصانع الـمُبدِع.
والحضارة المعاصرة قامت بوصفها رَدَّة فعلٍ على الكنيسة، فكانت حضارة مادِّية في جوهرها، قادت شعوب الغرب غالباً إلى حالة من الفراغ الروحي والأخلاقي الذي لم يُبْقِ لهم في حياتهم سوى طلب اللذَّة والمتعة؛ لأنَّ الإنسان هو مرجعية ذاته في تقرير جميع أحكامه، فغدا بذلك لا يُفرِّق بين الفطري والـمُنحرِف، ولا بين الأخلاقي والبهيمي، وأصبح يعيش في مجتمع مُتذبذِب بين الحلولية واللا أدرية.
ومن ثَمَّ، فإنَّ هذا البحث يهدف إلى النظر في مفهوم “الإنسان الخليفة” في أصوله والأبعاد الـمُكوِّنة لماهيَّته وهُوِيَّته بوصفه إنساناً، والكشف عن خصائص الإنسان السُّنَني برصد الإنسان الخليفة وعلاقته بالسُّنَن الفطرية والنفسية والكونية، ثمَّ النظر السُّنَني في الأصول المعرفية للتفكير الحداثي، وإعادة توجيهها بقِيَم الاستخلاف والعمران.
الكلمات المفتاحية: الإنسان السُّنَني، الاستخلاف، العمران، التسخير، التفكير الحداثي.
مقدمة
تُعَدُّ الحداثة المعاصرة إحدى حلقات النهضة الأوروبية التي تمخَّضت عنها حضارة من أضخم الحضارات الإنسانية التي تشكَّلت على مَرِّ العصور. ونظراً إلى ديمومتها واستمرارها كلّ هذه القرون، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية مُبهِرة، ونتائج سلبية خطيرة، قد تؤدّي بالحضارة البشرية إلى “الفتنة والنكبة والهلاك” بحسب تعبير الشيخ بديع الزمان النورسي، ولأنَّ الإنسانية وصلت إلى عالمية تلاحمت فيها مراحل تكوين الإنسان جميعها، لتنتهي إلى الدائرة الأصل، وهي الآدمية التي تُمثِّل مرحلة بلغ فيها الإنسان حَدَّ النضج العلمي السُّنَني الذي أزال حواجز الزمان والمكان والعنصريات المقيتة؛ فإنَّه آنَ الأوان للعلمية السُّنَنية الشاملة أنْ تحتضن هذه العالمية.
فكل الديانات قبل الإسلام كانت ديانات قَبَلية، خلافاً للإسلام الذي جاء رسالة للعالمين، وكان خطابه خطاباً عالمياً مُوجَّهاً إلى الإنسانية جمعاء، وعمل على تحقيق ذلك عن طريق العلمية السُّنَنية الكونية القائمة على كتاب )اقرأ(، الذي غايته العدل والسلام. ومن ثَمَّ، كانت قراءة )بسم الله( للتزوُّد بالمفاهيم والأولويات والكليات، وهي قراءة لتكوين الرؤية التوحيدية، وشحن العقل حتى يكون ميزاناً صحيحاً يكتشف التوازن والتطابق العجيب بين الوحي والسُّنَن الفطرية والكونية، ويُنتِج إنساناً سُنَنياً.
وعليه، فإنَّ الإشكالية تكمن في معرفة معالم صورة الإنسان السُّنَني الذي ينتج من هذا المنظور، ويسعى لتأسيس نظام معرفي وخطاب علمي يقوم على قِيَم الاستخلاف والعمران، ويحترم نفسه بقَدْر ما يحترم المنظورات الكونية الأخرى. ولكنْ، من هو الإنسان السُّنَني؟ وكيف يُمكِنه استئناف نهضته الحضارية بقِيَم الاستخلاف والعمران في ظِلال تأثيرات التفكير الحداثي بأبعاده الطينية؟
ومن ثَمَّ، فإنَّ هذا البحث -بمحاوره ومباحثه- يهدف إلى النظر في مفهوم “الإنسان الخليفة” في أصوله والأبعاد الـمُكوِّنة لماهيَّته وهُوِيَّته بوصفه إنساناً، والكشف عن خصائص الإنسان السُّنَني برصد الإنسان الخليفة وعلاقته بالسُّنَن الفطرية والنفسية والكونية، ثمَّ النظر السُّنَني في الأصول المعرفية للتفكير الحداثي وإعادة توجيهها بقِيَم الاستخلاف والعمران من حيث بحث المنهجية التلفيقية والمخاض التحديثي، ثمَّ دراسة الفرق بين المنهجية العلمية المادِّية الحداثية ومنهجية التفكير السُّنَني، فتعود المفاهيم إلى آدميتها، ووضوحها، وجلائها، ويُسْرها، وسهولتها التي تقرَّرت مُذْ خلق الله تعالى سيِّدنا آدم u، وسوّاه، ونفخ فيه من روحه، وعلَّمه الأسماء، بعدما تأثَّرت بالنظريات والمفاهيم الفارسية، والهندية، واليونانية، والصينية، …، لا سيما المفاهيم الفارسية والشرقية القديمة التي توغَّلت في الحضارة الإسلامية، وسَرَت فيها مسرى الدم في العروق منذ وقت مُبكِّر.
ولهذا، فإنَّ المنهج الأساسي الـمُلائِم للبحث هو منهج الاستقراء، إلى جانب الآليّات المنطقية، مثل: التعريف، وإعادة التعريف، والتعريف بالمقابلة، والتعريف بالضرب.
ولا يَتَّسِع المقام هنا للحديث عن الدراسات السابقة؛ نظراً إلى سعة رقعة الدراسات والأفكار السُّنَنية، وتناثرها في جميع الشعب العلمية؛ فهي موجودة في بطون كتب التفسير، وكتب الأصول والفِقْه والكلام والسِّيَر والمغازي، وكتب التاريخ والفلسفة والنفس والطبيعيات.
وفي هذا السياق، أَعَدَّت علياء العظم دراسة مسحية شاملة، وُسمت بـ”حالة البحوث في السُّنَن الإلهية”، واستطاعت من خلالها رسم خارطة، بَدْءاً من الحضارات القديمة، وانتهاءً بيوم مناقشة الدراسة. وميزة هذه الخريطة أنَّها مسحية شاملة، إضافة إلى أنّها غير قابلة للتحيين بما اكتُشِف واستجدَّ في البحث السُّنَني.
أوَّلاً: الإنسان السُّنَني:
بما أنَّ الهدف المركزي من الفكر السُّنَني هو بناء إنسان سُنَني يمارس فعل الاستخلاف والتسخير والإعمار على أتمِّ وجه؛ لذا لا بُدَّ من تصوُّر مُسْبَق لمفهوم “الإنسان” من حيث ماهيَّته الوجودية، وموقعه في الوجود العياني، ووظيفته فيه، ومصيره بعد نهاية دورته الوجودية. ومن ثَمَّ، هذا ما يجعل مفهوم “الإنسان” مرتبطاً بمفاهيم “الاستخلاف”، و”الأمانة”، و “التسخير”، ومفهوم “الإعمار”، لكنَّه لا يتحدَّد إلّا بمعرفة علاقته بها عن طريقين هما:
– ماهيَّة الإنسان الخليفة في أصوله والأبعاد الـمُكوِّنة لماهيَّته وهُوِيَّته بوصفه إنساناً.
– خصائص الإنسان السُّنَني برصد الإنسان الخليفة وعلاقته بالسُّنَن الفطرية والنفسية والكونية.
- 1. الأصول والأبعاد والعناصر الـمُكوِّنة لماهيَّة الإنسان وهُوِيَّته
خلق الله تعالى الكون، بمَنْ فيه مِنْ مخلوقات، على رأسها الإنسان الذي كرَّمه سبحانه، واختاره ليكون خليفة في الأرض، وأودع فيه خصائصَ وسُنَناً فطريةً ونفسيةً تجعله أهلاً لأداء هذه المهمة؛ ما يعني وجود سُنَن وعناصر تحكم العالَم الطيني المحسوس، وتجعل الإنسان يشترك في هذه السُّنَن مع غيره من المخلوقات الكونية. وكذلك وجود سُنَن وعناصر تحكم العالَم الروحي، وتجعل الإنسان مخلوقاً مُميَّزاً عنها، وأهلاً لأنْ يُستخلَف عليها. ولهذا، فإنَّ للإنسان أصلين اثنين: أصل روحي، وأصل طيني.
أ. الأصول
هي مُكوِّنات الإنسان الـمُتمثِّلة في جسمه الطيني قبل تمييزه من الحيوانات التي كان معدوداً منها لاحقاً في أصل تكوينه، ومُكوِّناته التي أُضيفت إليه بعد النفخة الروحية الربّانية التي منحته وجوده الفعلي، وجعلته ينماز عن الحيوان بنِعَم السمع والبصر والفؤاد، قال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَیۡـࣰٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَـٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ [النحل ٧٨]. وهذه الأصول هي التي تُحدِّد الهُوِيَّة السُّنَنية التي هي هُوِيَّة علمية في جوهرها، بعدما وهب الله تعالى الإنسان مدارك الحِسِّ والأفئدة التي هي الفكر؛ ليكون أهلاً لإمضاء العقد الأوَّل: )اقْرَأْ(، ويُباشِر فعله العقلي في اتجاهيه؛ قراءة الوحي المسطور، وقراءة الوحي المنظور.
* الأصل الروحي (النور): إنَّ الحديث عن الروح يقتضي الحديث عن الخصائص التي أودعها الله تعالى في الإنسان، وجعلته يختلف عن بقية الموجودات؛ لأنَّ الحيوان يشترك مع الإنسان في الحياة، لكنَّه لا يشترك معه في الروح (أبو سليمان، 2003، ص38). ولهذا، فإنَّ السُّنَن التي تحكم الذات الإنسانية الـمُزدوَجة تختلف عن تلك التي تحكم الحيوان. والقرآن الكريم بيَّن أنَّ الحياة الإنسانية الدنيوية إنَّما هي تَدافع بين مُتطلَّبات الروح ومُتطلَّبات المادَّة، “حيث يلتقي التوجُّهان في ذات الإنسان وكينونته خلال حياته الدنيوية لقاءً فريداً” (أبو سليمان، 2003، ص42-43). ثمَّ ينتهي هذا اللقاء بالفوز بالجَنَّة أو الشقاء في النار. وأوَّل مُكوِّنات هذا الأصل الروحي هو الفكر، الذي هو جوهر الخلافة والتسخير والإعمار. والقرآن الكريم -في غير آية منه- عرض على الفكر الإنساني آيات الأنفس، وآيات الأكوان، وآيات البيان، ودعاه إلى النظر فيها، ورغَّبه فيها، وحثَّه عليها. قال تعالى: ﴿كَذَ ٰلِكَ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡـَٔایَـٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ﴿فِی ٱلدُّنۡیَا وَٱلۡـَٔاخِرَةِۗ ﴾ [البقرة ٢٢٠]، فقد جعل التفكير فيهما معاً، وقدَّم الدنيا على الآخرة؛ لأنَّها الطريق إليها (ابن باديس، 1985، ج4، ص47-48). ولكي يكون هذا الفكر مُثمِراً واتجاهه صحيحاً؛ فلا بُدَّ له من عقائد يعتقدها في أمر دينه وأمر دنياه. وقد دعا القرآن الكريم إلى العقد الحقِّ المبني على العِلْم واليقين (ابن باديس، 1985، ج4، ص49)، المبني على المحسوس في باب المحسوس، وعلى المعقول في باب المعقول، ونهى عن الاكتفاء بالظنِّ، فتَتَّحِد بذلك طبيعة أعمال الإنسان التي هي مبنية على ما عنده من عقائد وأفكار وغرائز؛ فإذا كانت هذه مستقيمة كانت أعماله مستقيمة، وإذا كانت مُعوَجَّة كانت أعماله مثلها. غير أنَّ القرآن الكريم لم يكتفِ في نهضة الأعمال بهذا الاستلزام، وإنَّما تتبَّع أصول الأعمال، فوضع لها سُنَنها على قواعد الحقِّ، والصدق، والرحمة، والعدل، والإحسان (ابن باديس، 1985، ج4، ص49). فالقرآن الكريم كفيل بنهضة الإنسان نهضةً حقيقيةً تبلغ به إلى مقامات السيادة والكمال.
* الأصل الطيني (الترابي): خلق الله ثلاثة أنواع من المخلوقات، هي: المخلوقات النورانية، والمخلوقات النارية، والمخلوقات الطينية. والنور والنار والطين هي أحوال وأشكال للطاقة “التي لا يبدو أنَّ العلْم الإنساني حتى اليوم يُدرِك كُنْهها” (أبو سليمان، 2003، ص31). ومن الواضح في القرآن الكريم أنَّ النار أعلى درجةً من الطين، وأنَّ النور أعلى درجةً من النار.
ولـمّا كان الإنسان والحيوان يشتركان في مادَّة الصنع التي هي الطين، فإنَّ طبع الدوابِّ الطينية هو افتراس بعضها بعضاً من أجل البقاء واستمرار الحياة. ولهذا، اعتقد الملائكة بأنَّ الإنسان سيسلك “قانون الغاب”؛ لأنه مخلوق من طين، لكنّ الله U أخبرهم أنَّه يعلم مِنْ أمْر خَلْقه ما لا يعلمون. فالأصل الطيني يتكوَّن من الغرائز المطبوعة على الخير والشَّرِّ، وقد ضمَّنها الله أصول الخير وأصول الشَّرِّ، ونهضتها تكون “بمقاومة ما فيها من أصول الشَّرِّ، وإنماء ما فيها من أصول الخير، والقرآن مُعلِّم أخلاقي عظيم” (أبو سليمان، 2003، ص48)؛ فقد تضمَّنت آياته ذكر أصول الخير وما يُزكّيها، وذكر أصول الشَّرِّ وما يُدسّيها.
فالإنسان جزء من هذا العالَم الطيني المحسوس؛ إذ “من أرضه نبت، ومن نباته يتغذّى، ومن هوائه يتنفَّس، ومن مائه يرتوي، ويَتَّقي بناره بَرْده، وببَرْده ناره” (مفتاح، 2011، ص86). فهو في حقيقة تكوينه حيوانٌ من جُمْلة الحيوانات، ونوعٌ من أنواعها، يُشارِكها في الحِسِّ، والحركة، والحاجة إلى الغذاء، والسكن، والجنس، والراحة، وغير ذلك من شروط البقاء، لكنَّ الله تعالى فرض على قلبه وجوارحه أعمالاً وعباداتٍ.
ب. العناصر (الجسد، والنَّفْس، والصدر، والقلب، والعقل، والفؤاد، واللُّبُّ)
ذكرنا آنفاً أنَّ الله قد أودع في الإنسان عناصر تُؤهِّله لأداء مهمة الخلافة والإعمار. وما يهمُّنا من هذه العناصر التي اختُلِف في تعدادها هو الوظائف الكبيرة التي تُؤدّيها، لتحقيق الغاية من خلافته في الأرض وتسخيرها له، وتتمثّل في تعرُّف الله تعالى في الدنيا عن طريق التقرُّب إليه بالعبادة، والتزام أوامره، واجتناب نواهيه؛ كي يتسنّى له إدراك التطابق بين آياته المسطورة والسُّنَن المنثورة في النفس والكون، فيهتدي بذلك إلى سُبُل التسخير والإعمار الخيِّر، ويتطلَّع إلى الكمال الذي يصل به إلى مرتبة الإنسان السُّنَني، الذي يُحقِّق السعادة في الدنيا، والفوز والفلاح في الآخرة.
فانضباط الجوارح بالعبادات والعمل الصالح يُحقِّق التزكية للنفس؛ فتُنتِج نوراً ينعكس على الصدر، فينشرح بنور الإسلام؛ ما يؤدّي إلى انفتاح القلب، فيندفع إلى التدبُّر في آيات الله تعالى، فيحصل له نور الإيمان الذي يُزوِّد العقل (الميزان) بكليات الوحي، التي تساعده على الموازنة بين الوحي المسطور والسُّنَن النفسية والكونية، فيَنتج منها نور المعرفة الذي ينصهر في الفؤاد، ويتفاعل معه، ويتكاثر فيه. وكلَّما زاد الإنسان في العمل الصالح، وانضبط أكثر بالشريعة، وطبَّق الفرائض على أتمِّ وجه، وتدرَّج في تطبيق النوافل على أحسن حال؛ انبثق نور التوحيد من اللُّبِّ، وهو ما يتيح للمعرفة أنْ تصل إلى أَوْجها، ويصل السالك إلى التوحيد الخالص، فيصبح إنساناً سُنَنياً ربّانياً.
فالإنسان السُّنَني هو الذي يصل إلى اكتشاف العلاقة بين آيات الله المسطورة وسُنَنه المنثورة في النفس والكون، فيهتدي بها إلى سُبُل التسخير والإعمار، ويشرع فعلاً في عملية التسخير والإعمار.
* الجسم والجوارح: خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن صورة، وقوَّمه أحسن تقويم؛ بأنْ وهبه مجموعةً من الأعضاء البيولوجية الـمُنسجِمة والـمُتناسِقة، بحيث يؤدّي كل عضو منها وظيفته على نحوٍ مُتكامِل ومُنسجِم مع الأعضاء الأُخرى، استناداً إلى سُنَن ثابتة. وكذلك أودع الله في هذا الجسم نعمة السمع والبصر والفؤاد، وجعل القلب (آن ساترباك وآخرون، 2011، ص701-723) مركزاً لها، وخصَّص للجسم وظيفتين اثنتين: وظيفة بيولوجية، ووظيفة روحية. فالحواسُّ الخمس -مثلاً- تؤدّي عملين مُهِمَّين، هما: العمل البيولوجي التابع للمراكز العصبية، والعمل الروحي التابع للقلب. أمّا العمل الأوَّل فتحكمه سلامة الأعضاء الحِسِّية، وأمّا العمل الثاني فتحكمه سلامة القلب الروحية. ومن ثَمَّ، فقد يكون سمع الإنسان سليماً من الناحية العضوية، لكنَّه لا يسمع؛ لأنَّ قلبه مُقفَل، وقد يكون بصره الذي ينظر به سليماً، لكنَّه لا يُبصِر. قال تعالى: ﴿وَإِن تَدۡعُوهُمۡ إِلَى ٱلۡهُدَىٰ لَا یَسۡمَعُوا۟ۖ وَتَرَىٰهُمۡ یَنظُرُونَ إِلَیۡكَ وَهُمۡ لَا یُبۡصِرُونَ﴾ [الأعراف ١٩٨]. فكلما ابتعد الإنسان عن الدين الحقِّ (الإسلام) حتى يُقفَل على قلبه، ويتعطَّل العمل الروحي لأعضائه ونِعَمه وحواسِّه، فيصبح كائناً بيولوجياً مثل بقية الحيوانات أو أضلَّ منها سبيلاً؛ لأنَّ الحيوانات غير العاقلة مُبرمَجة، خلافاً للإنسان الذي كرَّمه الله تعالى بالعقل؛ فإذا تخلّى عن توجيه الدَّيّان سلك حتماً طريق الشيطان.
والإنسان في تركيبة جسمه تحكمه سُنَن سببية محسوسة، وفي تركيبة نِعَمه تحكمه سُنَن غائية روحية. فمن الناحية الجسدية، تجتمع الخلايا الـمُتشابِهة، لتُشكِّل أنسجة تنتظم في أربع مجموعات أساسية، هي: الأنسجة الطلائية، والأنسجة الضامَّة، والأنسجة العضلية، والأنسجة العصبية (زهير، د.ت. ص4-8). وهذه الأنسجة تُشكِّل معاً الصورة الهندسية البديعة لجسم الإنسان، وكل عضو في جسمه تحكمه هندسة وسُنَن مُعيَّنة خاصّة به (الجاويش، 2005، ص6). فمثلاً، للعين والرؤية هندسةٌ وسُنَنٌ خاصّة بهما، وكذا الحال بالنسبة إلى الأذن والسمع، ولكل عضو من أعضاء الجسم البشري (الزيدية، 2009، ص109-265). والخلية هي الوحدة الأساسية لتركيب الجسم، والنواة هي مركز القيادة الحيوي وغرفة العمليات التي دونها تموت الخلية (عبد الله، 1424ﻫ، ص86؛ الصوفي، 1428ﻫ، ص28–29)، ويتلاشى الجسم في وقت قصير.
أمّا من الناحية الروحية، فإنَّ الإنسان إذا “نظر إلى نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمة، وأدلَّة التوحيد على ربِّه ناطقة شاهدة لمُدبِّره، دالَّة عليه، مُرشِدة إليه” (ابن قيم الجوزية، التبيان في إيمان القرآن، د.ت، ص457-458؛ ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، د.ت، مج1، ص539).[1] فالتدبُّر الـمُزدوَج للكشف عن السُّنَن السببية والسُّنَن الغائية ضروريٌّ لفهم جسم الإنسان وجوارحه؛ إذ لا يكفي معرفة السُّنَن السببية البيولوجية، بل لا بُدَّ من معرفة السُّنَن الغائية الروحية؛ لِما لها من علاقة بسلامة الجسم والجوارح المادِّية.
* النفس: ورد لفظ “النفس” في القرآن الكريم في أكثر من مئتين وسبعين موضعاً، وكان لكل لفظ عائده المعرفي الذي يُعبِّر عن ذات الإنسان وحقيقته. وقد بيَّن الله كيف سوّى هذه النفس، وألهمها فجورها وتقواها، بحسب طبيعته ذات التركيب الـمُزدوَج بين النور والطين، وبحسب الطريقينِ اللذينِ مُنِح حرية الإرادة للاختيار بينهما؛ طريق الهدى، وطريق الضلال؛ وطريق التزكية، وطريق التدسية. وكل طريق تحكمه سُنَن ثابتة، لا تتبدَّل، ولا تتحوَّل، وكذلك نتائج هذه السُّنَن وثمارها؛ فهي مضمونة، بحيث لا يشوبها ريبٌ أو شكٌّ؛ فالذي يسلك طريق التزكية يجد نفسه أمام سُنَن ثابتة تهدي سبيله إلى ثمار معلومة، والشيء نفسه ينطبق على طريق التدسية.
وقد انعكست هذه المعاني على اللغة العربية، فرأت أنَّ النفس -في مُجْملها- تُعبِّر عن جميع الإنسان وحقيقته (ابن منظور، د.ت، ص4500-4503). فالنفس “غائبة عن العِيان، وآثارها ظاهرة في البَدَن، فكأنَّه وجميع أجزائه (مُجتمِعة، ومُتفرِّقة) آلةٌ للنفس ولِقواها” (ابن خلدون، 2001، ص121). ولهذا عُدَّت النفس نقطة الانطلاق في عملية التغيير والإصلاح، وفي عملية التربية والبناء؛ فإذا اهتدت النفس إلى الحقِّ، فإنَّها ستسلك طريق التزكية، فتنقضي ولاية النفس الأَمّارة بالسوء في الصدر، فينشرح بمباشرة الجوارح للعبادات والعمل الصالح، فينفتح القلب. ومن ثَمَّ، “فالتوحيد سِرٌّ، والمعرفة بِرٌّ، والإيمان محافظة السِّرِّ ومشاهدة البِرِّ، والإسلام الشكر على البِرِّ وتسليم القلب للسِّرِّ” (الترمذي، د.ت، ص22). وخصائص النفس الفطرية تُمثِّلها الاستعدادات الأوَّلية. أمّا خصائص النفس الإنسانية فهي ما ينشأ عن تلك الاستعدادات لاحقاً، بحسب تعلُّق هِمَّة الإنسان بالتزكية والبِرِّ وطلب العِلْم النافع، أو تعلُّقها بالتدسية والشَّرِّ والسَّيْر في طريق الضلال.
* الصدر: يُعرَّف الصدر في اللغة العربية بأنَّه مُقدِّمة كل شيء وأوَّله، وكل ما يُواجِه الإنسان (الفيروزآبادي، 2005، ص423). وهو في الاصطلاح بالمعنى نفسه؛ فهو إمّا أنْ يكون الدرع الذي يحمي الإنسان، وإمّا أنْ يكون مصدر هلاكه؛ لأنَّه هو الـمُقدِّمة، وهو أوَّل ما يُواجِه به الإنسان وساوس الشيطان؛ “فهو موضع دخول الوسواس والآفات … والذي يدخل في الصدر قلَّما يشعر به في حينه، وهو موضع دخول الغِلِّ والشهوات … وهو موضع ولاية النفس الأَمّارة بالسوء” (الترمذي، د.ت، ص17-22). وهذا المفهوم ينطوي على مجموعة من الخصائص، تهدينا إلى السُّنَن الناظمة له، ويُمكِن إيجازها في الجدول الآتي:
| الصدر | ||
| الخصيصة | الآية الدالَّة عليها | السُّنَّة |
| – الصدر موضع النفس الأَمّارة بالسوء. دخول الغِلِّ والشهوات والـمُنى والحاجات. | – [الحجر: 47]. – [الأعراف: 43]. | السُّنَن التي تحكم دخول الغِلِّ والشهوات والـمُنى والحاجات وخروجها. |
| – الضيق أحياناً، والانشراح أحياناً أُخرى. | إحدى عشرة آية، منها: [الأعراف: 2]. – [الزمر: 22]. – [الشعراء: 13]. – [هود: 12]. | – السُّنَن التي تحكم انشراح الصدر وضيقه. |
| – في الصدر شفاء يؤدّي إلى شفاء القلب؛ فهو موضع نور الإسلام. | – [التوبة: 14]. – [يونس: 57]. | – السُّنَن التي تحكم شفاء الصدور. |
| – انثناء الصدر يتيح للإنسان إخفاء ما يريد. | – [القصص: 69]. – [النمل: 74]. – [غافر: 19]. – [آل عمران: 29]. | – السُّنَن التي تحكم ضيق الصدر وانثناءه. – السُّنَن التي تحكم اتِّساع الصدر. |
| – الصدر موضع دخول الوسواس والآفات. | – [الناس: 5]. | – السُّنَن التي تحكم دخول الوسواس والآفات في الصدر. – السُّنَن التي تمنع دخول الوسواس والآفات في الصدر. |
| – الصدر مصدر التحصيل، وموضع حفظ العِلْم المسموع الذي يُتعلَّم من عِلْم الأحكام والأخبار. | – [العاديات: 10]. – [العنكبوت: 49]. | – السُّنَن التي تحكم علاقة الصدر بالتعلُّم. – السُّنَن التي تحكم اللغة المناسبة للصدر والتعلُّم. |
| – الصدر مصدر وساوس الحوائج وفكر الاشتغال، وهي تصدر منه إلى القلب إذا استقرَّت، وطالت الـمُدَّة. | – [الحشر: 9]. – [غافر: 80]. | – السُّنَن التي تحكم انتقال وساوس الحوائج إلى القلب. |
| – الله وحده هو الذي يعلم ما في الصدور. | اثنتا عشرة آية، منها: – [الملك: 13]. – [فاطر: 38]. – [الحديد: 6]. | – السُّنَن التي تحكم الشعور برقابة الله للصدور. |
| – الصدر مصدر الخوف. | – [الحشر: 13]. | – السُّنَن التي تحكم نـزْع الخوف من الصدر. – السُّنَن التي تحكم زرْع الخوف في الصدر. |
| – الصدر مصد الكِبْر. | – [غافر: 56]. | – السُّنَن التي تحكم نـزْع الكِبْر من الصدر. – السُّنَن التي تحكم زرْع الكِبْر في الصدر. |
| – الصدر مصدر الابتلاء. | – [آل عمران: 154]. | – سُنَن الصبر والثبات. |
| – الصدر هو المكان الذي يحمل القلب. | – [الحج: 46]. | – سُنَن التمييز بين القلب والصدر. |
* القلب: ورد لفظ “القلب” في القرآن الكريم بصيغ مختلفة وصل عددها إلى نحو مئة وسبعة وعشرين موضعاً، لكل موضع منها عائده المعرفي، إلّا أنَّها تشترك جميعاً في وظيفة العقل والعِلْم. قال جَلَّ جلاله: ﴿إِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ لَذِكۡرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلۡبٌ أَوۡ أَلۡقَى ٱلسَّمۡعَ وَهُوَ شَهِیدࣱ﴾ [ق ٣٧]. فإذا انفتح القلب أدّى هذه الوظيفة، وإذا أُقفِل تعطَّل عمله، وأصبح مَجْمَع الرّان والأوساخ، فيغلظ، ويقسو، وتزداد قسوته، ويشتدُّ مرضه واتِّساخه بزيادة المعاصي، خلافاً للصدر الذي له وظيفة مُزدوَجة؛ لأنَّه موطن العِلْم والعقل، مثلما هو موطن القوى الجسمية من الشهوات والغضب والهوى وما إلى ذلك.
وللقلب في اللغة العربية “أصلان صحيحان؛ أوَّلهما: يدلُّ على خالص الشيء وشريفه، والثاني على رَدِّ شيء من جهة إلى جهة. فالأوَّل؛ القلب: قلب الإنسان وغيره، وسُمِّي بذلك؛ لأنَّه أخلص شيء فيه، وأرفعه، وخالص كل شيء وأشرفه قلبه … والأصل الآخر … قلبت الشيء؛ كببته” (ابن فارس، 1979، ج5، ص17).
والقلب اسم جامع يقتضي السُّنَن الغائية التي تحكم مقامات الباطن كلها. وإذا كان الصدر مثل الحوض يُصَبُّ فيه الماء من العين، فإنَّ القلب أشبه بالعين التي تَصُبُّ العِلْم في الصدر، فيخرج ويدخل عن طريق السمع، والقلب في يد النفس رحمة من الله تعالى؛ لأنَّه هو الـمَلِك، والنفس هي المملكة. وكل عمل جاء من النفس من غير قلب فإنَّه ليس بمُعتبَر في حُكْم الآخرة، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَـٰكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِیمࣱ﴾ [البقرة ٢٢٥]. فالقلب تحكمه سُنَن النِّيَّة والقصد، وسُنَن العقل، وسُنَن البصر والعمى، وسُنَن الطمأنينة والخوف، وسُنَن التقوى والضلال، وسُنَن الفطنة والغفلة، وسُنَن الانفتاح والانغلاق والعِلْم والجهل، وسُنَن التطهُّر والاتِّساخ، وسُنَن الهَدْي والضلال، وسُنَن الصحَّة والمرض، وسُنَن التواضع والتكبُّر، وسُنَن الليونة والقسوة … وكلَّما أحاط الإنسان بهذه السُّنَن، وعمل بها، كانت الحياة لقلبه، فينفتح، ويتزوَّد بنور الإيمان.
* العقل: ورد لفظ “العقل” في القرآن الكريم في أكثر من ثلاثة آلاف موضع بصيغ فعلية، ولم يَرِدْ ولو مَرَّة واحدة بصيغة اسمية؛ ما يدلُّ على أنَّه “آلة عاجزة” (الكفوي، 1998، ص619)، غير مُكتفِية بذاتها، وتَتْبَع لقوَّة معرفية أكبر منها، هي القلب؛ لذا وصفه بعض الدارسين بأنَّه “نور في القلب يعرف الحقَّ والباطل” (الجرجاني، 2003، ص154). والعقل هو وسيلة وآلة في يد النفس، تستخدمه كيفما شاءت في الخير أو في الشَّرِّ؛ لأنَّه “آلة للنفس بمنـزلة السِّكّين بالنسبة للقاطع”.[2] فإذا سلكت النفس طريق التزكية سلك العقل طريق النظر وطلب الهَدْي[3] من الوحي، وذلك بشحن نفسه بكليات الوحي ومفاهيمه، فيصبح نوراً يتصرَّف فيه القلب بالنظر في الدلائل وتدبُّر الآيات، فيغدو ميزاناً صحيحاً مهمته التحقيق في قضية العلاقة بين الوحي والسُّنَن الفطرية والكونية. إذن، فمهمته هي النظر في الآفاق والأنفس؛ ليريه الله تعالى آياته فيهما، حتى يتبيَّن له التوافق التامُّ بين هداية الوحي والسُّنَن الكونية والنفسية، ويستثمر هذه السُّنَن في عمليتي التسخير والإعمار؛ ليتمكَّن من أداء مهمة الخلافة وتحمُّل الأمانة على أتمِّ وجه، ويصل إلى مرتبة الإنسان السُّنَني الكامل.
* الفؤاد: ورد لفظ “الفؤاد” في القرآن الكريم في خمسة عشر موضعاً بصيغ مختلفة؛ إذ ورد بصيغة المصدر “فؤاد”، وبصيغة المفرد المخاطب “فؤادك”، وبصيغة الجمع “الأفئدة، وأفئدتهم”. والفؤاد -مثله مثل السمع والأبصار- نعمة ووسيلة من وسائل المعرفة التي ميَّز الله بها الإنسان، ليكون خليفة في الأرض.
والفؤاد في اللغة العربية مشتق من الفعل “فَأَدَ” الذي يعني “اتَّقَدَ”، و”التفؤُّد: التوقُّد، والفؤاد: القلب لتفؤُّده وتوقُّده” (ابن منظور، د.ت، ص3333؛ الفيروزآبادي، 2005، ص305). ومن ثَمَّ، “فالفؤاد … موضع المعرفة، وموضع الخواطر، وموضع الرؤية، وكل ما يستفيد الرجل يستفيد فؤاده أوَّلاً، ثمَّ القلب … والفؤاد في وسط القلب كما أنَّ القلب في وسط الصدر، مثل اللؤلؤة في الصدف” (الترمذي، د.ت، ص21). فالفؤاد يفرغ ويمتلئ كما الموقد، وهو يثبت ويتزعزع، وهو يهوي ويرتفع إذا هبَّت عليه ريح الشهوات وميول النفس، وهو يرى ويعمى، وهو يصغي وينقلب، ويصبح هواءً إذا انطفأت حرارته. وكل خصيصة من هذه الخصائص تحكمها قواعد وسُنَن ثابتة.
* اللُّبُّ: ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في ستة عشر موضعاً بصيغة الجمع “الألباب”، وصيغة المخاطب؛ إذ خاطبت به الآيات القرآنية مَنْ كان في مستوى مرتفع من الذكاء والفطنة والعِلْم والنباهة والصفاء العقلي. فلفظ “أُولي الألباب” مُرتبِط -في أغلب الآيات- بالأحكام التي لا تُدرِكها إلّا العقول الذكية “الـمُنوَّرة بنور القدس الصافي عن قشور الأوهام والتخيُّلات” (الجرجاني، 2003، ص191- 200).
وقد جاء لفظ “لُبٍّ” في اللغة العربية، وفيه “اللام والباء أصل صحيح يدلُّ على لزوم وثبات، وعلى خلوص وجودة، أَلَبَ بالمكان؛ أيْ أقام به … واللُّبُّ أيضاً؛ خالص كل شيء، وما يُنتقى منه” (ابن فارس، 1979، ص199-200). ولهذا سُمِّي العقل الخالص من الشوائب لُبّاً. “واللُّبُّ … هو موضع نور التوحيد، ونور التفريد، وهو النور الأتمُّ والسلطان الأعظم” (الترمذي، د.ت، ص22) فالصدر مَجْمَع نور الإسلام الناتج من عمل الجوارح وانضباطها بالعبادات. وما إنْ ينشرح الصدر، وينفتح القلب، حتى يشرع الصدر في العمل بمساعدة ميزان العقل، فينبثق نور الإيمان الذي يتجمَّع في الفؤاد، ليُطهى، وينضج مع المعرفة، ويتجمَّع في اللُّبِّ، فينبثق نور التوحيد. إذن، فاللُّبُّ هو مَجْمَع نور التوحيد الذي يستضيء به العقل الإنساني حتى يصبح صافياً من الفتور، ويُدرِك صاحبه العلوم العالية الـمُتعلِّقة بالسُّنَن الفطرية والنفسية والكونية.
ت. الأبعاد
ذكرنا في ما تقدَّم أنّ الإنسان مجبول على جُمْلة من الأصول والعناصر، وأنَّه تحمَّل أمانة الخلافة، وكُلِّف بالتسخير والإعمار. وهذا يعني أنَّ له علاقاتٍ وأبعاداً؛ علاقة بالله تعالى تمنحه البُعْد السُّنَني العِبادي، وعلاقة بنفسه تضفي عليه البُعْد السُّنَني الفطري النفسي، وعلاقة بالكون الفسيح تدفعه نحو البُعْد السُّنَني الكوني، وعلاقة حياتية (اجتماعية، واقتصادية، وسياسية …) تعطيه البُعْد السُّنَني الحياتي. أمّا تحديد هذه الغايات والمقاصد السُّنَنية وتحقيقها فمُرتبِط بالهِمَم البشرية التي تُمثِّل الاستعدادات الطبيعية التي تستخدمها النفس في تحقيق ذاتها من قوى النِّعَم (السمع، والبصر، والفؤاد). قال الله تعالى: ﴿سَنُرِیهِمۡ ءَایَـٰتِنَا فِی ٱلۡـَٔافَاقِ وَفِیۤ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ یَتَبَیَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّۗ أَوَلَمۡ یَكۡفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ شَهِیدٌ﴾ [فصلت ٥٣]. فالله تعالى يري عباده الذين آمنوا به، ودخلوا في عقد القراءة )اقرأ(؛ يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم؛ حتى يتبيَّن لهم التطابق بين الآيات المسطورة والآيات المنظورة.
فالقرآن الكريم “كالخارطة للكون في جميع جزئياته” (مصطفى، 2010، ص56). فإذا كانت الآية هي “العلامة الثابتة” (العسكري، 1998، ص71)، وكان الأُفق هو “الناحية أو الموضع” (الكفوي، 1998، ص154؛ الفيروزآبادي، 2005، ص864)، أو “اسم الجوِّ الذي يبدو للناظر مُلتقى بين طرف مُنتهى النظر من الأرض، ومُنتهى ما يلوح كالقُبَّة الزرقاء” (ابن عاشور، 1984، ج27، ص96)؛ فإنَّ من معاني الآفاق التي يجب أنْ يُنظَر فيها، تلك الناحية التي تفصل بين أنواع الكائنات؛ بين التراب والأرض، ومختلف الكائنات الحيَّة، بمَنْ في ذلك الإنسان. قال U: ﴿وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتࣰا﴾ [نوح ١٧]، وقال تبارك وتعالى: ﴿تُولِجُ ٱلَّیۡلَ فِی ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِی ٱلَّیۡلِۖ وَتُخۡرِجُ ٱلۡحَیَّ مِنَ ٱلۡمَیِّتِ وَتُخۡرِجُ ٱلۡمَیِّتَ مِنَ ٱلۡحَیِّۖ وَتَرۡزُقُ مَن تَشَاۤءُ بِغَیۡرِ حِسَابࣲ﴾ [آل عمران ٢٧]. ثمَّ بين المخلوقات الطينية والمخلوقات النارية، ثمَّ بين المخلوقات النارية والمخلوقات النورية؛ لاستخراج السُّنَن الثابتة التي تحكم النسيج السُّنَني الكوني. والشيء نفسه ينطبق على النفس، وبذلك يُمكِن التمييز بين أربعة أنواع من العلاقات الكبيرة التي تضبطها أربعة أنواع من الأبعاد: علاقة الإنسان بالله التي يحكمها البُعْد السُّنَني العِبادي، وعلاقة الإنسان بنفسه التي يضبطها البُعْد السُّنَني الفطري النفسي، وعلاقة الإنسان بالكون الفسيح التي يحكمها البُعْد السُّنَني الكوني، والعلاقة الحياتية الاجتماعية التي يحكمها البُعْد السُّنَني العمراني. فجوهر ما يُقدِّمه الوحي للإنسان هو توضيح طبيعة علاقته بالله سبحانه وتعالى، وغاية وجوده في الكون، ودليل حركته في الحياة، ومصيره فيما وراء هذه الحياة. وفي ما يأتي بيان وتفصيل لكلٍّ من هذه الأبعاد الأربعة:
* البُعْد السُّنَني العِبادي: جعل الله العبادة هي الوظيفة المركزية للإنسان، حتى إنَّ كلّ المهام والوظائف والأعمال التي تتعلَّق بحياة الإنسان، في كل أبعادها، تُعَدّ عبادة إذا أخلص الإنسان نِيَّته لله U. والمقصد الأساسي من العبادة هو التقرُّب إلى الله تعالى، والتعرُّف إليه في الدنيا؛ لنيل ثوابه في الدنيا، والفوز بجَنَّته في الآخرة. وهذا التقرُّب والتعرُّف تحكمه سُنَن ثابتة؛ فإذا تدرَّج السالك في مراتب العبادة نال حتماً ثمراتها، فقد روى رسول الله عن ربِّه تبارك وتعالى أنَّه قال: “ما تقرَّب إليَّ عبدي بمثل ما افترضت عليه، وإنَّه ليتقرَّب إليَّ بعد ذلك بالنوافل حتى أُحِبَّه، وما يتقرَّب إليَّ بشيء من النوافل أحبَّ إليَّ من النصيحة، فإذا أحببته كنت عينه التي بها يُبصِر، وسمعه الذي به يسمع، وفؤاده الذي به يعقل، ولسانه الذي به ينطق، ويده التي بها يبطش، ورجله التي بها يمشي، فإنْ دعاني أجبته، وإنْ سألني أعطيته” (الترمذي، 2007، ص63؛ البيهقي، 1987، ج3، فصل: الاجتهاد في الطاعة، ص270).
فالتدرُّج في تطبيق الفرائض يجب أنْ يكون على أتمِّ وجه؛ فإذا أتمَّها السالك، ونال ثمارها، شرع في تطبيق النوافل، وتدرَّج في إتقانها؛ فإن نال ثمارها وصل إلى مرتبة التعرُّف إلى الله وحُبِّه. وكل عبادة من العبادات مُعلَّلة، ومقصودة، وتضبطها سُنَن سببية وغائية ثابتة، لا تتغيَّر، ولا تتبدَّل. فإذا توافرت الأسباب والشروط نفسها حصلت الظاهرة نفسها، ونتج منها الثمرة نفسها. إذن، فالعبادات تحكمها منهجية علمية سُنَنية دقيقة جداً، لا تختلف عن المنهجية العلمية السُّنَنية التي تحكم الظواهر الطبيعية.
* البُعْد السُّنَني الفطري النفسي: عِلْم السُّنَن النفسية هو معرفة النفس ما لها وما عليها من وجدانيات، وهو أيضاً عِلْم المعاملة والإخلاص في الطاعات، والتوجُّه إلى الله تعالى من جميع الجهات، وفيه يتعلَّم الإنسان السُّنَن التي تحكم آفات النفس ومعرفتها، والسُّنَن التي تحكم مكايد الشيطان وسُبُل الاحتراز منها، والسُّنَن التي تستقيم بها النفس على الواجبات، والسُّنَن التي تُصلِح الطباع، وتؤدّي إلى التأدُّب بآداب الله تعالى، فيصل الإنسان إلى تطهير سريرته ومراقبة خواطره.
وعِلْم السُّنَن النفسي يُبحث فيه عن العوارض الذاتية للنفس، وغرضه الوصول إلى معرفة الله تعالى. ولا يتمُّ بلوغ هذا العِلْم إلّا بمعرفة السُّنَن التي تحكم عمل الجوارح، التي تؤدّي إلى حفظها، ومعرفة السُّنَن التي تكشف عن ثمرات الفرائض حتى يكتمل الاندفاع إلى أدائها على أتمِّ وجه، ومعرفة السُّنَن التي تحكم عمل القلب، وتؤدّي إلى السَّيْر في استقامةٍ حتى الوصول إليه.
* البُعْد السُّنَني الكوني: إنَّ القرآن الكريم والكون صِنوان؛ إذ يحكمهما نسيج سُنَني واحد. قال تعالى: ﴿۞ فَلَاۤ أُقۡسِمُ بِمَوَ ٰقِعِ ٱلنُّجُومِ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمࣱ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِیمٌ إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانࣱ كَرِیمࣱ فِی كِتَـٰبࣲ مَّكۡنُونࣲ لَّا یَمَسُّهُۥۤ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة ٧٩]. فكما أنَّ النجوم سُنَن كونية، فلكل نجم فَلَك يسبح فيه، وإذا خرج أحدها عن مداره، واصطدم بغيره، اختلَّت موازين الأجرام كلها، فكذلك القرآن الكريم؛ فهو أيضاً بنائية سُنَنية مُنضبِطة. ومن ثَمَّ، فإنَّه يجب التعامل مع الكونية القرآنية بما يُميِّز الاستخدام الإلهي للغة عن الاستخدام البشري.
وبذلك يكتسب القرآن الكريم خصائصه السُّنَنية؛ فهو عالمي، وآياته كونية، وإنسانه كوني يتفاعل مع كلّ الأنساق الثقافية والحضارية، وبالمناهج المعرفية جميعها، بحيث يحتضنها، ويسمو بها في وحدة مُتكامِلة إلى بارئها. فالتزوُّد بمفاهيم “الوحي” و”السُّنَن الكلية الغائية”، واستعارة القوانين والسُّنَن السببية الجزئية، على اختلاف مُحدِّداتها النظرية والمعرفية والمنهجية؛ كلّ ذلك من صميم مهام الـمُسلِم المعاصر. ومن ثَمَّ، فلا تتلاشى خصوصيات الإنسان الثقافية، ولا تفقد هُوِيَّتها في ظِلِّ اتِّساعها الإنساني السُّنَني الشامل، ولا تفقد وطنيتها باتِّساعها السُّنَني الجغرافي، بل تلتحم الإنسانية في وحدة واحدة، وتعتصم بحبل الله المتين.
* البُعْد السُّنَني العمراني: إنَّ الدين الإسلامي في كماله وتمام نِعَمه ينفي مفهوم “العبثية” في حركة الحياة والظواهر الإنسانية والطبيعية في آنٍ معاً، ويدفع الإنسان السُّنَني دفعاً إلى التأمُّل داخل جوف الزمان والحركة، ويتحرّى السياق الزمني للأحداث، ويتقصّى كيفية تولُّد بعضها من بعض في اتجاه محكوم بحكمة القدرة الإلهية في الزمان والمكان. فكما أنَّ ظواهر الكون تحكمها سُنَن ثابتة في تشكُّلها المادي مكانياً، فإنَّ نفس هذه الظواهر تحكمها سُنَن زمنية ثابتة مُرتبِطة بتوقيت إلهي دقيق. ومن ثَمَّ، فإنَّ الظاهرة -بصرف النظر عن نوعها- تحكمها سُنَن زمنية ومكانية في آنٍ معاً؛ فالزمن يتحكَّم في نتائجها وَفق عامل التوقيت بما ينفي عنها مفهوم “المصادفة” ومفهوم “العبثية” في كلّ النتائج، والمكان يتحكَّم في حركتها صعوداً ونـزولاً، والربط بين السُّنَن الغائية الكلية والسُّنَن السببية الجزئية ضروري؛ ليَعبر الإنسان من خلال وحدتهما إلى التجربة الوجودية، ويفهم طبيعة مساره في الحياة. “فالاجتماع ضروري للنوع الإنساني، وإلّا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من إعمار الأرض بهم واستخلافه إيّاهم” (ابن خلدون، 2000، ص55). والعمران كذلك ضروري للنوع الإنساني، وشرط من شروط إعمار العالَم والاستخلاف فيه.
(*) دكتوراه في العقيدة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، 2016م، أستاذ محاضر (أ) بقسم العقيدة بكلية أصول الدين في جامعة الأمير عبد القادر. البريد الإلكتروني: [email protected]
قاسمي، عمّار (2023). الإنسان السُّنَني بين التفكير الحداثي وقِيَم الاستخلاف والعمران، مجلة “الفكر الإسلامي المعاصر”، مجلد 29، العدد 105، 165-212. DOI: 10.35632/citj.v29i105.77255
كافة الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 2023 ©
[1] وقد استمرَّ ابن القيِّم في وصف هذه الهندسة على نحوٍ دقيق وبديع حتى ص469.
[2] قال الجرجاني: “العقل والنفس والذهن واحد؛ إلّا أنَّها سُمِّيت عقلاً لكونها مُدرِكة، وسُمِّيت نفساً لأنَّها مُتصرِّفة، وسُمِّيت ذهناً لكونها مُستعِدَّة للإدراك” (الجرجاني، 2003، ص197).
[3] قال أبو الهلال العسكري: “النظر هو طلب الهَدْي، وهو أيضاً طلب ظهور الشيء، والرؤية هي إدراك المرئي، والتفكير تصرُّف القلب بالنظر في الدلائل” (العسكري، 1998، ص75).