بقلم أ.د. راشد سعيد يوسف شهوان(*)
الملخص
يحاول البحث – بعون الله تعالى- دراسة خصائص السُّنَن الإلهية ودلالاتها في القرآن الكريم والسُّنَّة الـمُطهَّرة، مشيراً في ثنايا الحديث عن هذه الخصائص إلى أبعادها العلمية والحضارية، وأهميتها في بناء الأُمم وارتقائها.
وقد جاء هذا البحث في مُقدِّمة، ومَطْلَبين، وخاتمة. أمّا الـمُقدِّمة فتضمَّنت حديثاً عن أهمية البحث، وحدوده، ومصطلحاته. وأمَّا الـمَطْلَب الأوَّل فحمل عنوان “خصائص السُّنَن الإلهية وأبعادها العلمية والحضارية”. وأمّا الـمَطْلَب الثاني فوُسِم بـ “السُّنَن الاجتماعية طريق إلى بناء الأُمم وارتقاء الحضارات”. في حين اشتملت الخاتمة على أبرز النتائج وأهم التوصيات.
كلمات مفتاحية: السُّنَن الإلهية، السُّنَن الاجتماعية، بناء الأُمم، خصائص السُّنَن.

مقدمة
الحمد لله ربِّ العالمين وبعد، فإنَّ السُّنَن الإلهية، وحُسْن التعامل معها من المفاتيح الرئيسة لفهم الكون والإنسان والحياة، والإسهام الفاعل في بناء الأُمم وارتقاء الحضارات وإصلاحها، لا سيّما المستقبل الحضاري للأُمَّة الإسلامية؛ نظراً إلى ما آلت إليه من الضعف والهوان، والتفكُّك والتجزئة وتكالُب الأُمم عليها.
أمّا الكون بطبيعته السماوية والأرضية، وعناصره وظواهره وكل طاقاته، فيُعَدُّ الميدانَ والمختبر الحقيقي للكشف عن هذه السُّنَن والآيات والقوانين الـمُسخَّرة بين السماوات والأرض؛ بُغْيَةَ إغناء المعرفة، وتوليد الطاقات الكامنة فيه، ثمَّ امتلاك القدرات التي تساعد على تحسين الحياة وتحقيق النهضة.
وقد أعطى القرآن الكريم السُّنَن الإلهية قيمةً عُليا وخطاباً مُتميِّزاً، وأمر الإنسان أنْ يُفعِّل نشاطه وطاقاته ومحاولاته وقدراته؛ لكي يتمكَّن من استكشاف هذه السُّنَن، واستثمارها، وتوظيفها في عمارة الأرض وإصلاحها؛ لأنَّ إدراك السُّنَن الإلهية واستكشافها والتجاوب مع مُسخَّراتها يفتح للإنسان آفاقاً علميةً لا حدود لها، ويُحقِّق له منافعَ وأبعاداً حضاريةً راقيةً.
غير أنَّ موضوع السُّنَن الإلهية، وفِقْه مسائله لم يلقَ الاهتمام اللازم -من المسلمين اليوم- الذي يتناسب مع التركيز القرآني على حقائقه وموضوعاته، عِلْماً بأنَّ دراسة المنهج السُّنَني في القرآن الكريم تُعَدُّ ضالَّةً يبحث عنها الـمُربّون والـمُصلِحون والـمُفكِّرون والعلماء على اختلاف تخصُّصاتهم وتنوُّعها؛ لأنَّ هذا المنهج يمدُّهم جميعاً بالزاد، والوَقود، والانطلاقة، والرؤية، والمعالم، والدلالات العلمية والمنهجية التي يحتاجون إليها.
إنَّ إحياء فِقْه السُّنَن الإلهية والمنهج السُّنَني في القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية، وتفعيل التفكير السُّنَني في الحياة، واستثماره في مختلف التخصُّصات؛ مطلوبٌ اليوم أكثر من أيِّ وقت مضى، وهو لا يقلُّ أهمية عن فِقْه الصلاة والزكاة.
وترجع أهمية البحث من هذا كله إلى الإسهام في إعادة تشكيل العقل الـمُسلِم، واستعادة الدور الحضاري للأُمَّة الـمُسلِمة، وتجديد قدراتها وشحن طاقاتها؛ حتى تكون على مستوى دينها وقرآنها وعصرها، وتتمكَّن من البرهنة على وجودها في التمكين والخيرية والشهادة على الناس، وتحقيق الاستخلاف المطلوب، والمستقبل المأمول؛ لأنَّ الأُمم التي لا تتقدَّم تتقادم، والأُمم التي لا تتجدَّد سوف تتبدَّد. وبهذا يهدف البحث إلى إحياء فِقْه السُّنَن الربّانية، وإحياء المنهج السُّنَني في القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية، وتفعيل التفكير والثقافة السُّنَنية من أجل بناء الأُمَّة الإسلامية، وارتقائها، وتجديد قدراتها.
يقوم المنهج الذي يتطلَّبه البحث على كلٍّ من الاستقراء والتحليل؛ وذلك لتتبُّع بعض النصوص، وتحليلها، واستنباط المضامين والتوجيهات الـمُتعلِّقة بالدلالات السُّنَنية، وربطها، وتوظيفها في التطبيقات الخادمة للموضوع، بالقَدْر المناسب الذي يقتضيه البحث.
تقتضي مُحدِّدات البحث أنْ نتحدَّث عن الموضوع في الدائرة القرآنية والسُّنَّة النبوية وواقع الأُمَّة الإسلامية، وليس عن جميع الأُمم وشرائح المجتمعات البشرية الأُخرى، عِلْماً بأنَّ الخطاب الإسلامي هو خطاب دعويّ عالميّ، يُخاطِب جميع الأُمم، ويُمثِّل ما فيه هدى ورحمة للعالمين.
وكذلك تقتضي مُحدِّدات البحث عدم التطرُّق إلى مسألة انهيار الحضارات، أو الخوض في تفاصيل السُّنَن التاريخية وتطبيقاتها.
أوَّلاً: خصائص السُّنَن الإلهية وأبعادها العلمية والحضارية
– الخصائص لغةً
لفظ “الخصائص” مُشتَقٌّ من الفعل “خَصَّ”، وجذره “خصص”. أمّا المفرد فهو “خصيصة” و”خاصية”؛ وهي الصفة التي تُميِّز الشيء من غيره سَلباً أو إيجاباً (ابن منظور، د.ت، ج7، ص24؛ المعجم الوسيط، د.ت، ج1، ص24). والخصائص تتعلَّق بماهيّة الأشياء وهيئتها الداخلية الذاتية، وما هو كامن فيها من صفات وطاقات وقوَّة تأثير مادِّية، أو ما اصطلح القاضي عبد الجبّار على تسميته الكمون،[1] مثل: خاصية الإرواء في الماء، وخاصية الإحراق في النار، وغير ذلك ممّا اختصَّت به الأشياء من خصائص ومُميِّزات.
أمّا السمات فتتعلَّق بالأشياء الظاهرة للعين الـمُجرَّدة. قال تعالى: ﴿سِیمَاهُمۡ فِی وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ﴾ [الفتح ٢٩]. وهي تُستخدَم في مقارنة الشيء بغيره إذا كان من الأمور الشكلية غير الجوهرية، مثل قولنا: هذا ماء بارد، وهذا ماء حارٌّ، ومثل قولنا: هذا جميل، وهذا قبيح.
– الخصائص اصطلاحاً
تُعرَّف الخصائص بأنَّها تصوُّرات كلية ومضامين عامة تُشكِّل منظومة متكاملة، ورؤية شمولية لموضوع مُعيَّن أو نظام مُعيَّن؛ وبمعنى آخر: هي تصوُّرات كلية وُضِعت في أُطُر ومنظومات مُتجانِسة، وأفكار مُتقارِبة تتعلَّق بموضوع مُعيَّن؛ ما يساعد على فهمه، ورؤيته، ومعرفة وظائفه، وتميُّزه من غيره.
وحديثنا عن خصائص السُّنَن الإلهية في هذا المقام ليس كما تعوَّدنا أنْ نسمع عن خصائص الشريعة، أو النظام الإسلامي، أو خصائص الثقافة الإسلامية، مثل: خصيصة “الوسطية”، و”العالمية”، و”الإنسانية”، و”الإيجابية”، وغير ذلك ممّا أَلِفنا سماعه.
ولكنَّه حديث عن نوع آخر من الخصائص الـمُتعلِّقة بالسُّنَن الإلهية، يتمثَّل في سبع خصائص، هي:
*الربّانية.
*التسخير والقابلية للكشف.
*الاطِّراد، والتلازم، والانتظام.
*الوحدة، والتوازن، والاتِّساق، والتكامل.
*الثبات، والاستقرار، وعدم التخلُّف، والتلازم بين الأسباب والـمُسبِّبات.
*العموم، والحياد، والاستجابة لكل مَنْ يتعقَّلها.
*التداخل، والاشتراك، والترابط.
وفي ما يأتي تفصيل وبيان لكلٍّ من هذه الخصائص:
- الربّانية
إنَّ التصوُّر الإسلامي لخصائص السُّنَن الربّانية، بوصفه مُنبثِقاً عن النظرة الكلية الشاملة للكون والإنسان والحياة، إنَّما هو تصوُّرٌ مُستمَدٌّ من القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية الصحيحة. وهذا التصوُّر يشير إلى أنَّ أُولى خصائص هذه السُّنَن على اختلاف أنواعها (الكونية، والتشريعية، والإنسانية، والاجتماعية، والتاريخية) هي “خصيصة “الربّانية”؛ أيْ إنَّها من تقديرات الله تعالى، وعاداته، ووقائعه، وقوانينه، وآياته، وأفعاله التي أودعها الله سبحانه في الوجود، أو أنـزلها في خَلْقه، بوصفه جَلَّ جلاله ربَّ كل شيء، وخالقَ كل شيء ومليكه” (قطب، 1399ﻫ، ص51). وهي تُشير إلى أنَّ الله تعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنَّه يدير الكون من داخله ومن خارجه، بكل ما أودع فيه؛ من: عناصر، وظواهر، وخصائص، وسُنَن، وطاقات. وهي كلها تجري على مراد الله تعالى، وعنايته، وحكمته، وتشهد بوحدانيته الكاملة، وتثبت ربوبيته وعدله الـمُطلَق.
وتعني هذه الخصيصة أيضاً أنَّ الله سبحانه وتعالى مُمِدٌّ هذه السُّنَن بالتأثير والديمومة والفاعلية، وليس للإنسان فيها أكثر من اكتشافها، واستثمارها، واستدرار خيراتها، والانتفاع بمُقدَّراتها. قال تعالى: ﴿ٱلَّذِیۤ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَیۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه ٥٠]، وقال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَیۡءࣲ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِیرࣰا﴾ [الفرقان ٢]، وقال سبحانه: ﴿ٱلَّذِیۤ أَحۡسَنَ كُلَّ شَیۡءٍ خَلَقَهُۥۖ﴾ [السجدة ٧] ، وقال جَلَّ جلاله: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَۖ ثُمَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمۡ یَعۡدِلُونَ﴾ [الأنعام ١].
وخصيصة “الربّانية” هي أوَّل مسألة، وأهمُّ قضية في الخَلْق والأمر، ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ﴾ [الأعراف ٥٤] ، يجب قراءتها وفهمها في هذا الإطار فهماً صحيحاً. قال تعالى: ﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِی خَلَقَ﴾ [العلق ١] . وهذه الآية الكريمة هي عُمْدة القراءة للكون والإنسان والحياة من منظور هذه الخصيصة، فإذا أتقنها الإنسان، وصَحَّ إيمانه وتوحيده، صَحَّت قراءته لكل مظاهر الوجود.
والإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى، جاء إلى الوجود بتقدير الله وفعله، وإنَّ لوجوده غاية ربّانية عظمى تتمثَّل في العبادة، وتحقيق الخلافة، وحمل الأمانة، وعمارة الأرض وإصلاحها، والشهود الحضاري.
إذن، فهذه هي معالم القراءة الربّانية الصحيحة لخَلْق الإنسان، وهذه هي معالم القراءة الصحيحة لخصائص السُّنَن الربّانية؛ فإذا أحسن الإنسان فهمها، وفِقْهها، والعمل بها، والتعامل معها تعاملاً صحيحاً، كانت قراءته صحيحة، ونتائجه سليمة، وإنْ أخطأ في قراءتها، فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً، ولم يعرف سبب مجيئه إلى هذه الدنيا وخروجه منها.
وهذا ما يُميِّز التصوُّر الإسلامي للسُّنَن الربّانية، والاستفادة من خصائصها، من سائر التصوُّرات الوضعية والفلسفات المادِّية، التي تُعلِّل قوانين الوجود، وتُفسِّر أحداث الحياة وحركة التاريخ والاجتماع البشري بالمصادفة، وصراع الأضداد، والتطوُّر التلقائي للكائنات الحيَّة، والفيض، والصدور، إلى غير ذلك من القراءات والتصوُّرات المادِّية الضالَّة (القرضاوي، د.ت، ص7).
وهذا ما يجعلنا في موضع الثقة والطمأنينة من التلقّي، والتصوُّر اليقيني لحقائق الأشياء، والمعرفة الكاملة الشاملة والصحيحة بتاريخ الكون، وغاية الحياة، وحقيقة الإنسان، ومركزه، ووظيفته، ومهمته، ومسؤوليته في هذا الوجود، وبعثه، ونشوره.
وهكذا يتأكَّد لنا من هذه الخصيصة أنَّ السُّنَن -على اختلاف أنواعها- إلهية المصدر والمنهج، وربّانية الغاية والوجهة، وأنَّ الخصائص الأُخرى كلها ترتكز على هذه الخصيصة، وتنبثق عنها، ذلك أنَّها تُبصِّرنا بكبرى الحقائق الكونية، واليقين بعظمة الله تعالى، والثقة بتدبيره لشؤون الكون كله، وأنَّه لا مكان للعبث والمصادفة العمياء. قال تعالى: ﴿أَوَلَمۡ یَتَفَكَّرُوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ﴾ [الروم ٨].
إنَّها تُبصِّرنا بمركزية الإيمان في صناعة الوعي بالكون، بكل عناصره وظواهره، واستبعاد الأُلوهية في مجال الطبيعة بأسرها (الفاروقي، 2015، ص11-19).
وكذلك فإنَّها تَمُدُّنا بفاعلية الإيمان في التأسيس للوظائف الإنسانية، مثل الوظيفة المعرفية الموضوعية والعلمية، للنظر في هذه السُّنَن، واستكشافها، واستثمارها، والتعامل معها. وكذلك تُكسِبنا الرؤية المنهجية، واستبعاد التربية العشوائية والعبثية والفوضوية في إدارة الكون وتفسير ظواهره، وتجاوز التفكير الخرافي والأسطوري والإلحادي، مُؤكِّدةً سلامة التصوُّر، وصدق التلقّي والاعتقاد.
فهي خصيصة تُولِّد جميع الفضائل والكمالات، وتسري في كل شيء، فما من أثر جميل وخُلُق كريم وفائدة عظيمة إلّا ناتج منها، وهي وعاء لكل قِيَم الإسلام كبيرة كانت أم صغيرة، ويترتَّب عليها كل الآثار والفوائد والثمار، فلله الحمد والمِنَّة.
- التسخير، والقابلية للكشف
التسخير هو خضوع الكون -بكل نِعَمه، وطاقاته، ومُكوِّناته، ومخلوقاته، وما يتعلَّق به من عناصر وظواهر- لأمر الله تعالى وعنايته وتدبيره، وتهيئته لأداء مهمته ووظيفته التي خُلِق من أجلها؛ بُغْيَةَ الاستفادة منه (الفيروزآبادي، د.ت، باب: الراء، فصل: السين، ص19؛ الراغب الأصفهاني، 1412ﻫ، ج1، مادَّة “سَخَرَ”، ص402)، على نحوٍ يكون فيه مستجيباً لقدرات الإنسان، ومُنسجِماً مع أهدافه ومهامه وطموحاته وحاجاته، ومُلبِّياً لمُتطلَّبات خلافته وتكليفه بعمارة الأرض وإصلاح الحياة.
وخصيصة “تسخير” السُّنَن وقابليتها للكشف نجدها تتردَّد كثيراً في القرآن الكريم بوصفها قاعدة مهمة، يُوجِّه القرآن الكريم العقل الإنساني إليها؛ ففي آيات عديدة من كتاب الله الـمُعجِز، نجد تأكيداً مستمراً على أنَّ السماوات والأرض، وما في هذا الكون من أشياء بصفاتها، وتركيبها الجغرافي والفيزيائي والكيميائي والحيوي … قد هُيِّئت تهيئة خاصة، وذُلِّلت كي يستخدمها الإنسان في منافعه وتطبيقاته العلمية والعملية؛ ارتقاءً في معاشه وعمرانه، ولو لم تكن كذلك ما استطاع الإنسان -بإمكان عقله، أو حِسِّه- أنْ يستثمر ما فيها، أو يصل إلى شيء من كشفه، أو الاستفادة منه البتة.
والآيات الكريمة التي تحدَّثت عن هذه الخصيصة تمنحنا التصوُّر الإيجابي لمهمة الإنسان العمرانية والحضارية، وتُبصِّرنا بمهمة الإنسان الـمُكرَّم بما منحه الله تعالى من حريةٍ، واختبارٍ، وتحمُّلٍ للمسؤولية والأمانة والعهد (الفاروقي، 2015، ص25)؛ ليقوم بدوره، ويستفيد من هذه النِعَم والـمُقدَّرات التي سُخِّرت لنشاطه، وأُخضِعت لقدراته؛ ليتعامل معها تعاملاً إيجابياً فعّالاً. قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِی جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولࣰا فَٱمۡشُوا۟ فِی مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَیۡهِ ٱلنُّشُورُ﴾ [الملك ١٥] . وفي هذا المعنى، قال الدكتور البوطي -رحمه الله-: “فجُمْلة ما يُقرِّره القرآن عن الكون أنَّه خادم أمين، مُسخَّر للإنسان، يستفيد منه الإنسان بمقدار ما يتأمَّل فيه، ويستبطن ظواهره. وكلمة “التسخير” من أقوى التعابير في الدلالة على الخدمة المستقرة الدائبة، وعلى الإنسان أنْ يستفيد منه، ويُسخِّره لصلاحه في المعاش والمعاد الأُخروي” (البوطي، 1962، ص62).
ولنتصوَّر كيف سيكون الحال لو كانت الشمس والقمر -مثلاً- أقرب قليلاً من موقعهما، أو أبعد قليلاً عنهما، أو إذا كانت الجاذبية أخفَّ ممّا هو مُقدَّر لها، أو أثقل من ذلك، أو إذا كان الغلاف الجوي على غير ممّا هو عليه من النسب المحدودة، أو إذا كانت مياه البحار والمحيطات خالية من الملح والرياح راكدة، ومحور الأرض غير عمودي، وشكلها غير بيضوي!
والحقيقة الثابتة أنَّ الله سبحانه وتعالى قدَّر في الأرض أقواتها، وفي السماء موازينها وأقدارها، وحدَّد أبعادها وحجومها بما يتلاءَم والمهمة الأساسية المنوطة بالإنسان، ويجعلها مُوافِقة لتكاليفه الشرعية والمادِّية والمعنوية.
ومن حكمة الله تعالى أنَّه لم يُمهِّد العالَم تمهيداً كاملاً، ولم يكشف للإنسان عن قوانينه وأسراره كلها؛ لأنَّ ذلك يحمل العقول على تبنّي حقائق علمية دون البحث عنها بالتجارب والبراهين، وهذا ما لا يحمل القرآن الكريم أحداً عليه؛ تكريماً للعقل، وإطلاقاً للمنهج والبحث والتجريب (البوطي، 1399ﻫ، ص34).
لأنَّ ذلك أيضاً نقيض عملية الاستخلاف والإبداع التي تتطلَّب جهداً، وسعياً، وتحدِّياً، واستجابةً، ودَأْباً، ونشاطاً؛ ولأنَّه يقود الإنسان إلى التواكل والركون إلى الدَّعَة، ويُسلِّمه إلى الكسل الذي لا تُقِرُّه مهمة الإنسان الـمُتمثِّلة في عمارة الأرض.
ومن أشكال هذه الطاقات الـمُسخَّرة في الكون: الموجات الكهرومغناطيسية، والحرارة التي تصلنا من الشمس، وتؤدّي دوراً في صناعة الاتصالات والأقمار الصناعية. ومن ذلك أيضاً أنواع الطاقات الـمُسخَّرة في الكون التي تُؤثِّر في حياة الإنسان بزخّاتها وموجاتها، مثل: الأكسجين، والضوء، والجاذبية، وغير ذلك ممّا ورد في الكتاب الذي حمل عنوان “الله يتجلّى في عصر العِلْم”. ونشير في هذا المقام إلى عدم طاقة كونية يُمكِنه التصرُّف في الكون وتدبيره بمعزل عن الله تعالى مُطلَقاً، أو تكون مستقلة في ذلك عن العناية الربّانية.
وكذلك ينبغي تأكيد أنَّ خصيصة “التسخير” لهذه السُّنَن لا تخدم الإنسان إلّا إذا فهم كيف يتعامل معها وَفق قوانين تسخيرها، والأخذ بمستلزماتها ومقتضياتها، وإلّا ظلَّت مُعرِضة وصامتة أمامه؛ فكما يستعصي القُفْل أنْ يُفتَح بغير مفتاحه، فإنَّ هذه السُّنَن كذلك لا تستجيب بغير معرفة قوانينها، مثلها في ذلك مثل السيّارة التي لا تتحرَّك ولا تستجيب لمَن يجهل قوانين تحريكها وتشغيلها. والزَّرْع يزداد عطاؤه بمعرفة قوانين الزراعة، وتحسينها، وتطويرها. وكذلك الحيوانات والدواجن؛ إذ يزداد إنتاجها بمعرفة قوانين رعايتها، وتدجينها، وتطويرها.
وإنَّ الأُمم التي تَغُضُّ الطرف عن خصائص التسخير لسُنَن الله تعالى ومُقدَّراته في هذا الوجود، إنَّما هي أُمم غافلة، وضعيفة، ومسجونة في جهلها، ومُستعبَدة لغيرها (البشتاوي، 2011، ص35-250).
إنَّ خصيصة “التسخير”، وما يتعلَّق بها من مسائل، تُعَدُّ موضوعاً له أبعاده وتفريعاته المعرفية. وهو موضوع يحتاج إلى عناية خاصة، واهتمام بالغ، ودراسة مُتكامِلة في إطار معرفة أنواع التسخير، وميادينه، ومجالاته، ووظائفه، وأهدافه؛ حتى يُكشَف النقاب عن مكنوناته وطاقاته؛ لتتحقَّق في الحياة ثماره العلمية ومنافعه الحضارية. وهو يحتاج أيضاً إلى أُمم واعية تُنشِئ له المؤسسات العلمية ومراكز البحث، وتُفرِد له الدراسات التطبيقية اللازمة لنهضة شعوبها.
- الاطِّراد، والتلازم، والانتظام
الاطِّراد لغةً: الاستمرار، والانتظام، وعدم التخلُّف. يقال: اطَّرد الأمر إذا استقام، وجرى على عادته، وتبع بعضه بعضاً. والطريدان هما: الليل والنهار (الفيروزآبادي، د.ت، ص378). وخصيصة “الاطِّراد والانتظام” نجدها في كل شيء في هذا الكون والخَلْق، وهي تنبض في الكائنات الحيَّة والموجودات غير الحيَّة، ويُمكِن الإحساس بها وإدراكها بالفكر، واليد، والذوق، والشَّمِّ، والسمع، والبصر. ومن ثَمَّ، فإنَّ الربّانية مُنتظِمة انتظاماً مذهلاً، وهي تمتاز بأنَّها غاية في الدقَّة والإتقان. قال تعالى: ﴿مَّا تَرَىٰ فِی خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ مِن تَفَـٰوُتࣲۖ﴾ [الملك ٣] (أبو سنينة، 2002).
وهذه الخصائص (الاطِّراد، والتلازم، والانتظام) هي مُكمِّلة لخصيصة “التسخير”، ومُشترِكة معها، ومُوضِّحة لها.
وقد أشارت آيات كثيرة في القرآن الكريم إلى وجود القانون، والحكمة، والغاية، والاطِّراد في نظام الكون. وهذا ما تدلُّ عليه كلمة “بالحقّ”، التي تَرِدُ كثيراً في القرآن الكريم، وتحتاج إلى استقراء شامل؛ لاستجلاء ما تشير إليه من دلالات علمية، وتوجيهات سُنَنية، وقوانين كونية، ويترتَّب على وجودها؛ (أيْ كلمة “بالحق”) وجود مفهوم “القانون”، والانتظام في الأشياء، وماهيَّتها الطبيعية، وضرورة خضوعها لسُنَن وقواعد مُطَّرِدة، ديدنها الانتظام، وعدم التخلُّف.
والقرآن العظيم كثيراً ما يلفت الأذهان والعقول والأنظار والأبصار إلى ما في الكون من آيات، وإلى ما فيه من سُنَن مُرتبِط بعضها ببعض ارتباطاً مُطَّرِداً؛ ما يوحي بأنَّ السُّنَن والحوادث والـمُسبِّبات إنَّما تصدر عن أسباب، وهو ما يوحي بفكرة “السببية”. فالمطر -مثلاً- ينهمر من السحاب، والثمر يُزهِر على الشجر، والشجر ينبت من الماء والتراب، والماء يتكوَّن من عنصرين، هما: الهيدروجين، والأكسجين.
ومن الـمُلاحَظ أنَّ القرآن الكريم لم يستعمل لفظ “السببية”، وإنَّما عرض لصورة الكون بما يدلُّ على الاقتران الـمُنتظِم الـمُطَّرِد. قال الله تعالى: ﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ یُزۡجِی سَحَابࣰا ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیۡنَهُۥ ثُمَّ یَجۡعَلُهُۥ رُكَامࣰا فَتَرَى ٱلۡوَدۡقَ یَخۡرُجُ مِنۡ خِلَـٰلِهِۦ﴾ [النور ٤٣]، وقال سبحانه: ﴿وَءَایَةࣱ لَّهُمُ ٱلَّیۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِی لِمُسۡتَقَرࣲّ لَّهَاۚ ذَ ٰلِكَ تَقۡدِیرُ ٱلۡعَزِیزِ ٱلۡعَلِیمِ وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِیمِ لَا ٱلشَّمۡسُ یَنۢبَغِی لَهَاۤ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّیۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلࣱّ فِی فَلَكࣲ یَسۡبَحُونَ﴾ [يس ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءࣰ مُّبَـٰرَكࣰا فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ جَنَّـٰتࣲ وَحَبَّ ٱلۡحَصِیدِ﴾ [ق ٩] . ولننظر أيضاً كم هو واضح هذا المعنى في العلاقة بين العناصر الكونية والظواهر الكونية، وارتباط الأسباب بمُسبِّباتها، في مثل قوله تبارك وتعالى: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَۖ ثُمَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمۡ یَعۡدِلُونَ﴾ [الأنعام ١] فثمة ارتباط بحركة العناصر السماوية (الشمس، والقمر) ارتباط الأسباب بمُسبِّباتها؛ من شروق، وغروب، وغير ذلك، وهذا ما تدلُّ عليه كلمة “خَلَقَ” وكلمة “جَعَلَ”، ودلالة كلٍّ منهما، وهو ما ينسحب أيضاً على الظواهر الكونية الأُخرى.[2]
- الوحدة، والتوازن، والاتِّساق، والتكامل
يتمثَّل التوازن، والاتِّساق، والتكامل في كل شيء، على اختلاف نوعه، فنجده -مثلاً- في: الاتزان الغذائي، والاتزان الكوني، والاتزان البشري، والاتزان الحيوي، والاتزان الحيواني. وكذلك نجده في المجال الكهربائي، والمجال المغناطيسي، وفي كل ما في الكون من طاقات وهالات. وسنشير في ما يأتي إلى هذه الخصيصة، وما لها من دلالات علمية وأبعاد عقدية في ترسيخ الإيمان واليقين والثقة بوحدانية الله، وأهميتها في تعرُّف التكوينية، والعناية والتدبير في ما يختصُّ بقوانين الله تعالى المضبوطة والموزونة، التي لا يعتريها نقض أو نقد أو نقص.
فالعالَم الذي نعيش فيه، بكل ما يشتمل عليه من كائنات حيَّة، وموجودات غير حيَّة، محكومٌ بدقَّة فائقة من الأنظمة والقوانين والسُّنَن التي تضبط سلوكه، ومسيرته، وحركاته من أصغر ذَرَّة إلى أكبر مَجرَّة فيه؛ ما يثير فينا الإعجاز والدهشة والإجلال لِما أودع الله فيه من خصائص الانسجام والاتِّساق. قال تعالى: ﴿مَّا تَرَىٰ فِی خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ مِن تَفَـٰوُتࣲۖ﴾ [الملك ٣] . وهو ما يفوق تصوُّرنا، ويُضعِف قدراتنا حياله. ولهذا وصف القرآنُ العظيمُ العالـمَ بأنَّه موزون، وفي هذا دليل على التناسق في الخَلْق، الدالِّ على الحكمة الإلهية البالغة، والقدرة العجيبة التي أوجدت كل شيء بمقدار، ووزنت كل موجود بميزان، بحيث تتحقَّق فيه المنفعة التي أرادها الله لعباده (البشتاوي، 2011، ص439). قال الله تعالى: ﴿وَٱلۡأَرۡضَ مَدَدۡنَـٰهَا وَأَلۡقَیۡنَا فِیهَا رَوَ ٰسِیَ وَأَنۢبَتۡنَا فِیهَا مِن كُلِّ شَیۡءࣲ مَّوۡزُونࣲ وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِیهَا مَعَـٰیِشَ وَمَن لَّسۡتُمۡ لَهُۥ بِرَ ٰزِقِینَ وَإِن مِّن شَیۡءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَاۤىِٕنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥۤ إِلَّا بِقَدَرࣲ مَّعۡلُومࣲ﴾ [الحجر ٢١].
وفي ذلك يقول الراغب الأصفهاني: “وقيل: بل ذلك إشارة إلى كل ما أوجده الله تعالى، وأنَّه خلقه باعتدال كما قال: ﴿إِنَّا كُلَّ شَیۡءٍ خَلَقۡنَـٰهُ بِقَدَرࣲ﴾ [القمر ٤٩]. فالآية الكريمة ظاهرة الدلالة على أنَّ ما يتفضَّل الله به على عباده إنَّما هو وليد الحكمة والقدرة التي تجعل لكل شيء مقداره وميزانه الذي يُنتفَع به، ولا يضرُّ. ونجد هذا التناسق والتوازن في سُنَن الكون كلها؛ في الماديّات والمعنويّات، وفي الليل، والنهار، والحرارة، والبرودة، والماء، واليابسة، …، وفي المتقابلات كلها، بحيث لا يطغى شيء منها على شيء، ولا يخرج عن حَدِّه الـمُقدَّر له. وكذلك نجده في المجموعات الكونية السابحة في فضاء الكون؛ إذ كلٌّ منها يسبح في مداره، ويخضع لجاذبية محدودة (مريسيون، د.ت، فصل: ضوابط وموازين، ص159؛ نوفل، 1998، ص26-102). قال تعالى: ﴿صُنۡعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِیۤ أَتۡقَنَ كُلَّ شَیۡءٍۚ﴾ [النمل ٨٨]، وقال تعالى: ﭐ ﴿ٱلَّذِیۤ أَحۡسَنَ كُلَّ شَیۡءٍ خَلَقَهُۥ﴾ [السجدة ٧]، وقال سبحانه: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَیۡءࣲ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِیرࣰا﴾ [الفرقان ٢] ، وقال عَزَّ من قائل: ﴿إِنَّا كُلَّ شَیۡءٍ خَلَقۡنَـٰهُ بِقَدَرࣲ﴾ [القمر ٤٩].
ويُمكِننا إدراك خصيصة “التوازن والاتِّساق” في سُنَن الله تعالى، في عدد من الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى: ﱡﭐ ﴿أَفَلَمۡ یَنظُرُوۤا۟ إِلَى ٱلسَّمَاۤءِ فَوۡقَهُمۡ كَیۡفَ بَنَیۡنَـٰهَا وَزَیَّنَّـٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجࣲ وَٱلۡأَرۡضَ مَدَدۡنَـٰهَا وَأَلۡقَیۡنَا فِیهَا رَوَ ٰسِیَ وَأَنۢبَتۡنَا فِیهَا مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِیجࣲ تَبۡصِرَةࣰ وَذِكۡرَىٰ لِكُلِّ عَبۡدࣲ مُّنِیبࣲ وَنَزَّلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءࣰ مُّبَـٰرَكࣰا فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ جَنَّـٰتࣲ وَحَبَّ ٱلۡحَصِیدِ وَٱلنَّخۡلَ بَاسِقَـٰتࣲ لَّهَا طَلۡعࣱ نَّضِیدࣱ﴾ [ق ١٠]، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِی مَدَّ ٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَ ٰسِیَ وَأَنۡهَـٰرࣰاۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَ ٰتِ جَعَلَ فِیهَا زَوۡجَیۡنِ ٱثۡنَیۡنِۖ یُغۡشِی ٱلَّیۡلَ ٱلنَّهَارَۚ إِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ لَـَٔایَـٰتࣲ لِّقَوۡمࣲ یَتَفَكَّرُونَ وَفِی ٱلۡأَرۡضِ قِطَعࣱ مُّتَجَـٰوِرَ ٰتࣱ وَجَنَّـٰتࣱ مِّنۡ أَعۡنَـٰبࣲ وَزَرۡعࣱ وَنَخِیلࣱ صِنۡوَانࣱ وَغَیۡرُ صِنۡوَانࣲ یُسۡقَىٰ بِمَاۤءࣲ وَ ٰحِدࣲ وَنُفَضِّلُ بَعۡضَهَا عَلَىٰ بَعۡضࣲ فِی ٱلۡأُكُلِۚ إِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ لَـَٔایَـٰتࣲ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ﴾ [الرعد ٤].
والآيات القرآنية كثيرة في الدلالة على هذه الخصيصة، وكلها تُؤكِّد الترابط والتناسق والتوازن والانسجام في الخَلْق، وتدلُّ على عظمة الخالق ووحدانيته جلَّ جلاله، وعَمَّ ثناؤه (القاسمي، د.ت، ج13، ص211؛ ابن عاشور، 1984، ج13، ص85، وج22، ص112).
- الثبات، والاستقرار، وعدم التخلُّف، والتلازم بين الأسباب والـمُسبِّبات
بوجه عام، السُّنَن الربّانية ثابتة، ومستقرة، ولا تتخلَّف؛ فما من شيء في هذا الكون إلّا خَلَقَ الله تعالى له صفاته، وأوجد له خصائصه وتقديراته وتراكيبه ونواميسه الكامنة فيه. غير أنَّ هذا الثبات والاستقرار لا ينسحب على جميع أجناس هذه السُّنَن والنواميس، وأنواعها، وما يندرج تحتها من أفراد، تُميِّزها من غيرها بخصوصيات مُعيَّنة.
فالسُّنَن التاريخية والاجتماعية من خصائصها أنَّها ثابتة على الإطلاق، وما عُرِف أنَّها تعرَّضت للخرق في ماضٍ أو حاضر؛ فهي ماضية، ومستمرة، وغير مُتبدِّلة أو مُتغيِّرة على مَرِّ الأزمان؛ نظراً إلى قيامها وبنائها على الحكمة الإلهية. فخرقها يقتضي التناقض في تدبير الله الحكيم الخبير حاشاه سبحانه (رضا، 1990، ج7، ص210). قال تعالى: ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبۡدِیلࣰاۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحۡوِیلًا﴾ [فاطر ٤٣].
أمّا السُّنَن التشريعية وأحكامها، فنجدها تنقسم قسمين: قسم يُمثِّل الثبات والخلود، وقسم يُمثِّل المرونة والتطوُّر. ويتجلّى هذا الثبات في المصادر الأصلية النصِّية القطعية للتشريع، مثل: العقائد الأساسية، والأركان، والـمُحرَّمات اليقينية، وأُمَّهات الفضائل التي عَدَّها القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية من شعب الإيمان، ومن شرائع الإسلام القطعية؛ من: شؤون الزواج، والطلاق، والميراث، والحدود، والقصاص، ونحو ذلك من سُنَن الإسلام التي ثبتت بنصوص قطعية الثبوت والدلالة.
وتتباين المرونة في المصادر الاجتهادية، التي اختلف فقهاء الأُمَّة في درجة الاحتجاج بها، وتعدَّدت مذاهبهم ما بين مُوسِّعٍ، ومُضيِّقٍ، ومُكثِرٍ، ومُقِلٍّ من حيث مقدار الأخذ بها، مثل: الإجماع، والقياس، والاستحسان، والمصالح الـمُرسَلة، وقول الصحابي، وغير ذلك من مآخذ الاجتهاد وطرائق الاستنباط (القرضاوي، د.ت، عوامل المرونة، ص11).
أمّا السُّنَن والقوانين الكونية فهي ثابتة وكامنة في ماهيَّة الأشياء، ومستقرة، ولا تتخلَّف، لكنَّها قد تُخرَق أو تتعطَّل معجزة لنبيٍّ أو كرامة لوليٍّ. وحتى لا يقع الوهم بفاعلية الأسباب مُطلَقاً، والقول بالحتمية المادِّية؛ فقد أجرى الله تعالى تعطيلها أحياناً لحكمةٍ يريدها جَلَّ جلاله.
وخصيصة “الثبات، والاستقرار، وعدم التخلُّف، والتلازم بين الأسباب والـمُسبِّبات” أكثرُ ما تظهر واضحة، في صورها وأحكامها وتطبيقاتها، في السُّنَن الاجتماعية والسُّنَن التاريخية، والسُّنَن التشريعية، وسُنَن الثواب والعقاب. فهي سُنَن لا تتخلَّف، ولا تُخرَق، ولا تتعطَّل، ولا تتغيَّر، ولا تتبدَّل البتة؛ لأنَّ ذلك مُخالِف لعدل الله تعالى، وحكمته، ووعوده، وتعهُّده على نفسه جَلَّ جلاله إثابة الطائعين، ومعاقبة العاصين. ومن ثَمَّ، فهي مُتلازِمة في أسبابها ومُسبِّباتها، وكذلك تجري على كلٍّ من الـمُسلِم والكافر. قال تعالى: ﴿أَكُفَّارُكُمۡ خَیۡرࣱ مِّنۡ أُو۟لَـٰۤىِٕكُمۡ أَمۡ لَكُم بَرَاۤءَةࣱ فِی ٱلزُّبُرِ﴾ [القمر ٤٣].
ولا شكَّ في أنَّ الترف والظلم والركون إلى الذين ظلموا -مثلاً- من الـمُعجِّلات والـمُسبِّبات لغضب الله وعذابه، ومن أشدِّ الأمراض الحضارية فتكاً بالأُمم والشعوب (برغوث، 1995، ص93؛ السامرائي، 1421ﻫ، ص3-5). قال تعالى: ﴿وَكَمۡ قَصَمۡنَا مِن قَرۡیَةࣲ كَانَتۡ ظَالِمَةࣰ وَأَنشَأۡنَا بَعۡدَهَا قَوۡمًا ءَاخَرِینَ فَلَمَّاۤ أَحَسُّوا۟ بَأۡسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنۡهَا یَرۡكُضُونَ لَا تَرۡكُضُوا۟ وَٱرۡجِعُوۤا۟ إِلَىٰ مَاۤ أُتۡرِفۡتُمۡ فِیهِ وَمَسَـٰكِنِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُسۡـَٔلُونَ قَالُوا۟ یَـٰوَیۡلَنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِینَ فَمَا زَالَت تِّلۡكَ دَعۡوَىٰهُمۡ حَتَّىٰ جَعَلۡنَـٰهُمۡ حَصِیدًا خَـٰمِدِینَ﴾ [الأنبياء ١٥]، وقال سبحانه: ﴿وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟ مَاۤ أُتۡرِفُوا۟ فِیهِ وَكَانُوا۟ مُجۡرِمِینَ﴾ [هود ١١٦]، وقال عَزَّ من قائل: ﴿وَلَا تَرۡكَنُوۤا۟ إِلَى ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنۡ أَوۡلِیَاۤءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ [هود ١١٣]. يقول الإمام العَلّامة ابن خلدون في “مُقدِّمته”: “باب في أنَّ الظلم نذير بخراب العمران.” وكذلك نجد سُنَّة تلازم الأسباب ومُسبِّباتها وعدم تخلُّفها في عموم قوله تعالى: ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبۡدِیلࣰاۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحۡوِیلًا﴾ [فاطر ٤٣].
- العموم، والحياد، والاستجابة لكل مَنْ يتعقَّلها
من خصائص السُّنَن الربّانية أنَّها عامة، ولا تحابي أحداً؛ فهي تستوعب جميع البشر؛ مُؤمِنهم وكافرهم، وليست خاصة بالمسلمين وحدهم كما يعتقد بعض الناس؛ إذ تمتاز بالحياد، والاستجابة لكل مَنْ يتعقَّلها. أمّا مَنْ خالفها وتنكَّبها فهي له بالمرصاد.
والله جَلَّ جلاله قد سَنَّ في الحياة الدنيا سُنَناً، ووضع في الكون والوجود أسباباً وقوانينَ. وهذه السُّنَن والنواميس مُقدَّرة بأسبابها وأقدارها وَفق قوانينها الكلية، وهي تؤتي ثمارها ونتائجها إذا اجتمعت شروطها.
ويستوي في ما تقدَّم من شروط ونتائج أنْ يكون المتعاطي معها مُؤمِناً أو كافراً؛ فالإنسان إذا أهمل اكتشاف تلك القوانين، ولم يحفل بأهمية استخدامها، فإنَّه يصبح ضعيفاً ولو كان مُؤمِناً. أمّا الإنسان الذي يكتشف تلك القوانين، ويُسخِّرها في خدمة مصالحه ومجتمعه، فإنَّه يصبح قوياً ولو كان كافراً. ولهذا، فإنَّ الأُمم التي تقدَّمت في اكتشاف السُّنَن الكونية بمعزل عن الأخلاق بلغت رُقِيّاً مادِّياً أدّى إلى اصطناع حضارة مادِّية منقوصة، وكذا الأُمم التي حافظت على أخلاقها، وغفلت عن السُّنَن الكونية؛ فقد أمست هزيلة ذليلة.
والله سبحانه وتعالى حثَّ الإنسان على أنْ يبحث في الكون والحياة عن الأسباب والعلاقات التي تربط هذه السُّنَن بعضها ببعض؛ حتى يهتدي إليها، ويعمل بها، وحتى يتحصَّل على ثمارها، ويُسخِّرها لخدمته في الحياة الدنيا. فالعمل وسيلة لطلب الرزق، والواجب على الإنسان أنْ يجتهد في طلب رزقه؛ فالفلّاح يحرث الأرض، ويبذر الحَبَّ، ثمَّ ينتظر الرزق من الله تعالى. ولو بقي نائماً، ولم يجتهد في الزراعة ظنّاً منه أنَّ رزقه سيأتيه من غير عمل وتعهُّد للأرض، فإنَّه سيكون واهماً، بل آثماً لعدم أخذه بالأسباب التي هي قَدَر الله جَلَّ جلاله. وكذلك الدعاة والـمُصلِحون الذين يَنشدون الإصلاح والتغيير؛ إذ يتعيَّن عليهم أنْ يعملوا، ويبذلوا غاية جهدهم؛ لتحقيق ما يصبون إليه من أهداف.
وتنطبق هذه الخصيصة أكثر ما تنطبق على سُنَّة التغيير التي تُعَدُّ أُمَّ السُّنَن؛ فهي سُنَّة تجري على الناس كافةً، وهي قاعدة عامة يخضع لها الناس جميعهم؛ فإذا أخذوا بأسباب التغيير، فإنَّهم سيتغيَّرون. ولهذا، فمن الضروري معرفة سُنَن تغيير الأنفس، وأن على كلّ فرد البدء بإصلاح نفسه؛ لأنَّ الفرد هو مُحرِّك الأحداث، ولأنَّ الفرد الواعي الصالح الـمُصلِح بصورة جماعية هو أهمُّ عناصر قوى التغيير (عبد الحميد، 2000، ص17 وما بعدها).
فالتغيير هو سُنَّة مجتمع، لا سُنَّة فرد. وبالرغم من أنَّ تغيير الأنفس هو أساس لتغيير المجتمع، فإنَّ التغيير سُنَّة جماعية، وليس سُنَّة فردية. وقد جاء في القرآن الكريم ما يفيد ذلك الجمع، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ یُغَیِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ﴾ [الرعد ١١]. فكلمة “قوم” تعني المجموعة من الناس، ومدلولها شامل أيَّةَ جماعة. فالحديث في الآية السابقة عن قوم، وعن جمع، له خصائصه، وله عناصره. ثمَّ جاءت كلمة “بأنفسهم” لتشير إلى الجمع مَرَّةً أُخرى. ومن الآيات القرآنية الأُخر الدالَّة على ذلك، قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ بِظُلۡمࣲ وَأَهۡلُهَا مُصۡلِحُونَ﴾ [هود ١١٧]. والـمُلاحَظ على هذه الآية ورودُ كلمة “مُصلِحون” فيها بدلاً من كلمة “صالحون”.
ومن هنا، يُمكِن القول بأنَّ الفردية ليس لها حظٌّ من التغيير الكافي، لا سيّما تغيير المجتمعات؛ فالتغيير الذي يحدث في المجتمع يقوم على أساس العمل الجماعي، وليس على أساس الجهود الفردية غير الـمُنسَّقة، التي تكون أحياناً مُتضارِبة، ولا تؤدّي الغرض المنشود منها (صبري، 1981، ج4، ص30).
إذن، فالتغيير الفردي غير كافٍ لتغيير المجتمع تغييراً كلياً وجذرياً وشاملاً لجميع نواحيه الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والأخلاقية، وغيرها.
- التداخل، والاشتراك، والترابط
يُقصَد بالتداخل والاشتراك تواردُ السُّنَن بعضها على بعضٍ، وترتُّبها على هذا النحو، وارتباط بعضها ببعض بشيء من العلاقة والارتباط، على نحوٍ يُؤثِّر في ميزان البحث فيها، وإدراك الحقائق، والحُكْم عليها، وفهمها، وتفسيرها. وتُعْزى أهمية هذه الخصيصة إلى دورها الفاعل في الفهم الـمُتكامِل والرؤية الكلية الشمولية لِما يختصُّ بفهم السُّنَن الربّانية، والوصول إليها، والكشف عن تطبيقاتها. ومن ثَمَّ، فإنَّ عدم إدراك هذه الخصيصة، وجهل كثير من الباحثين بكيفية المواءَمة والانسجام والتوفيق بينها وبين خصائص السُّنَن الأُخرى؛ يؤدي إلى خَلل في التصوُّر والاعتقاد لكثير من مسائلها وأحكامها وتطبيقاتها؛ ذلك أنَّه لا توجد سُنَّة إلّا ولها تداخل مع غيرها من السُّنَن. فسُنَن النصر مُرتبِطة بسُنَن التغيير، وسُنَن التغيير مُقدِّمة لسُنَن النصر، وسُنَن النصر تابعة لسُنَن التدافع، وسُنَن العقاب والشِّدَّة مُتعلِّقة بسُنَن الهداية والتشريع، وسُنَن الرخاء مُتعلِّقة بسُنَن التمكين والاستخلاف.
وقد يوجد تداخل في مرحلية السُّنَن، واختلاف في الأوقات والوقائع، وقد تجتمع سُنَّة مع سُنَن أُخر في ظرف واحد، أو واقعة واحدة، أو زمان واحد، ثمَّ يحدث تعارض بينهما، فكيف ندفع إحداهما بالأُخرى؟ وقد تندمج إحدى هاتين السُّنَّتين في الأُخرى، فتنتج سُنَّة جديدة أثرها واحد بالرغم من اختلاف السُّنَّتين إحداهما عن الأُخرى، فما قواعد الترجيح في ذلك؟
إنَّ كل سُنَّة من سُنَن الله مُتداخِلة بغيرها، ولها علاقة بالسُّنَن الأُخرى، مادِّية كانت أم معنوية، وسواء كانت في الكائنات الحيَّة، أو الموجودات غير الحيَّة. فمثلاً، أوقات الصلاة لها علاقة بجسم الإنسان، وطاقاته المادِّية والمعنوية. وتكاد تكون مسألة التداخل بين أنواع السُّنَن، وما يندرج تحتها من تقسيمات وتفريعات، ظاهرة عامة في معظم علوم الشريعة ومقاصد الدين؛ لِما بينها من وشائج وعلاقات. فهي مسألة ليست سهلة، وموضوع يحتاج إلى بحث خاص، ويكاد يكون لُبُّ الإشكال في فهم السُّنَن وتطبيقاتها.
ولم أقفْ -بحسب عِلْمي واطِّلاعي- على كتاب مستقل أصَّل هذا المفهوم، ووضَّح أسبابه، وحقَّق مسائله الـمُتعلِّقة به؛[3] فكل ما وجدْتُ من كتب تحدَّثت عن هذا الموضوع، وظننتُ أنَّها تناولته بشيء من الشمولية والتكامل، كانت أبعد ما يكون عن ذلك، بل إنَّها لم تتطرَّق إلى الموضوع المنشود، وكان الحديث فيها عاماً شاملاً عن خصائص الشريعة ونُظُمها.
ومن أسباب هذا التداخل أيضاً أسلوبُ القرآن العظيم الـمُتميِّز. فحين يتحدَّث القرآن الكريم في آية واحدة عن سُنَّة مُعيَّنة، فإنَّ هذه الآية تصلح أنْ تكون عُرْفاً اجتماعياً، أو قانوناً سياسياً، أو نظريةً اقتصاديةً، أو منهجاً تربوياً، أو عِبْرةً تاريخيةً؛ لِما تُقدِّمه من أهمِّ الحقائق وأدقِّ المعارف معاً في آنٍ واحد. ومن ثَمَّ، يتوارد كل ذلك على خاطر الإنسان، ويستثير مشاعره ووجدانه بهذه المعارف كلها، وتعمل هذه الآية بما فيها من حقائق وقِيَم ومعلومات على التأثير في الـمُتلقّين، فتتعلَّم العقول، وتُؤمِن القلوب، وتعتبر الأذهان، وتترقّى المشاعر، وتستقيم الأخلاق والسلوكات.
والحقيقة أنَّه لا يسعُني التطبيق على هذه الخصيصة في هذا المقام، أو تخريج الفروع على الأصول فيها كما يقول الفقهاء، ونسأله تعالى أنْ يُبارِك لنا في الأعمار والأفكار؛ لنُفرِد فيها بحثاً، ونبسط القول فيه، ونذكر نماذج وأمثلة تطبيقية عليها من الكتاب والسُّنَّة وواقع الأُمَّة الـمُسلِمة، ونعمل على ربطها وتوظيفها بما يخدم الموضوع، آملاً أنْ يتسنّى للباحثين اجتماع الفهم الـمُترابِط للعلاقة الـمُتداخِلة بين السُّنَن في منظومة واحدة ورؤية كلية شمولية[4] من جميع الجوانب، بوصفها مذهبية إسلامية (أبو السعود، 1975، ص60؛ عبد الحميد، 2022، ص19)،[5] ووحدة مُترابِطة مُتكامِلة، لا تضارب بينها، ولا تصادم، ولا تعارض.
ثمَّ نربط ذلك كله بالمنهج السُّنَني في القرآن الكريم والسُّنَّة الـمُطهَّرة ضمن رباط وثيق مُتماسِك، وبالرؤية الشمولية الـمُتكامِلة، التي تربط الأسباب بالـمُسبِّبات والنتائج بالـمُقدِّمات، وصولاً إلى سبر عِلَل الظواهر الاجتماعية وفِقْه سُنَن التاريخ والحضارات، في إطار علوم الإنسان وقوانين الله الاجتماعية التي وضعها سبحانه لصلاح المعاش والمعاد.
(*) دكتوراه في الشريعة الإسلامية من المملكة العربية السعودية، أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية/ الأردن. البريد اللأكتروني: [email protected]
شهوان، راشد سعيد يوسف (2023). خصائص السُّنَن الإلهية وأبعادها العلمية والحضارية، مجلة “الفكر الإسلامي المعاصر”، مجلد 29، العدد 105، 213-251. DOI: 10.35632/citj.v29i105.7727
كافة الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 2023 ©
[1] لتعرُّف المزيد عن الكمون والسببية، انظر (الأسدآبادي، د.ت، ج9، التوليد).
[2] للاستزادة، انظر:
– نخبة من العلماء الأمريكيين (د.ت). الله يتجلّى في عصر العلم، ترجمة: الدمرداش عبد المجيد سرحان، إشراف: جون كلوفرمونسيما، بيروت: دار القلم للنشر والتوزيع.
– البرنامج الإذاعي “لا يوجد تناقض” there is no clash، تقديم: كلير فورستر.”
[3] قدَّم الدكتور محمد خالد منصور نظرية كاملة عن هذا الموضوع في مشروع أطروحته للدكتوراه، فأَوْلاها عنايةً فائقةً؛ تأصيلاً وتقعيداً وتفريعاً، وحملت عنوان: “التداخل وأثره في الأحكام الشرعية”، لكنَّها كانت في باب الفِقه وأصوله.
[4] التصوُّرات الكلية عند علماء التربية تعني النظرة الشاملة. وقد تبنَّت المدرسة الألمانية المعروفة باسم الجشطلت هذا المعنى، ونادت بقيام التعليم على أساس مبدأ الشمول والكلية، وأجرت تجارب لإثبات صحَّة النظرة الكلية والشمولية في الفهم والإدراك، أثبتت فيها أنَّ الإنسان يميل إلى إدراك الأشياء بصورة كلية مُترابِطة ومُجتمِعة. وهذا هو التصوُّر، أو الاستبصار، أو الغلق. وقد أخذ هذا المفهوم يتوسَّع في التربية حتى أصبح يعني النظرة الكلية الشاملة في مختلف المجالات (عثمان، د.ت).
[5] المذهبية الإسلامية: هي كل ما ذهب إليه الإسلام في أمور الكون، وخالقه، والحياة، والإنسان. أو: هي كليات الإسلام في الوجود كله.

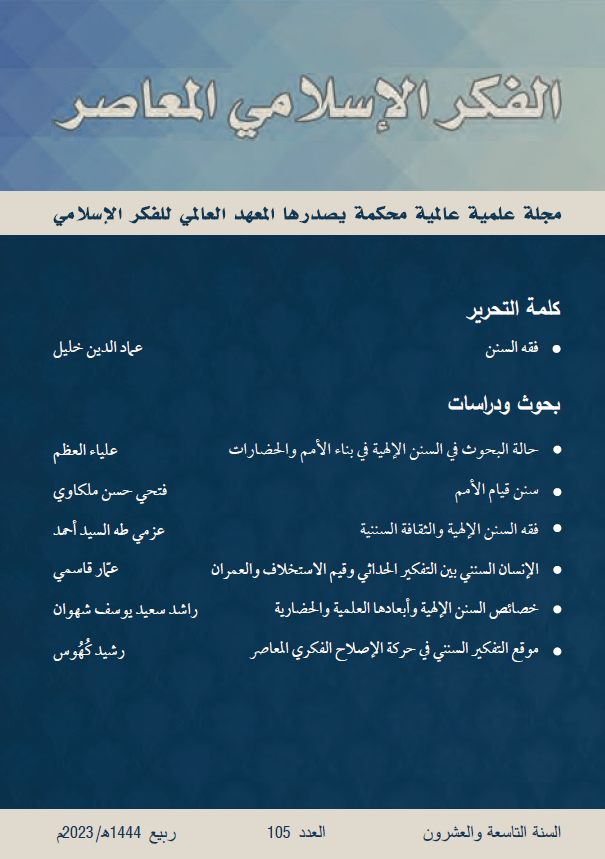



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيا الله الشيخ ونفع به الإسلام، مررت بالبحث سريعا واطلعت على مضامينه على أني ساقرأ البحث من جديد بكل تؤدة وتأن كبي أثتثمر منه الفوائد إن شاء الله وجزاكم الله عنا خيرا
أرجو من حضرتكم السماح بإرسال البحث إلي بشكل في دي إيف كي يكون بحوزتي أقرأ لكم
بقي منه جزء سينشر قريبا إن شاء الله، تابع الموقع، ونفع الله بك
When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thank you!