بقلم أ.د. فتحي حسن ملكاوي*
الملخص
مفاهيم: السُّنَّة، والقيمة، والأُمَّة، مفاهيم مركزية في معجم الألفاظ القرآنية. ويعد استحضار هذه المفاهيم حاجة مطلوبة في كل وقت. لكن حالة الأُمَّة الإسلامية في العالَـم المعاصر، تستدعي مزيداً من الاهتمام بها وإيلائها الأولوية. وتتأكَّد الحاجة إلى هذا الاهتمام عندما نُدرِك موقع الثقافة السُّنَنية والتفكير السُّنَني، والاعتبار بالسُّنَن في حياة الأُمم كما يعرضها القرآن الكريم؛ فقيام الأُمَّة وبقاؤها يعتمد على عدد من الـمُقوِّمات، تقوم الأُمَّة بوجودها، وتضعف أو تنهار بغيابها، وهذه سُنَّة الله.

ويتضمَّن هذا البحث أربعة مباحث، تبدأ بالحديث عن السُّنَّة، ثمَّ عن الأُمَّة، ثمَّ ينطلق الحديث عن سُنَن قيام الأُمم عن طريق الربط بين السُّنَن والقِيَم والـمُقوِّمات، وتأكيد موقع منظومة القِيَم العُليا في كيان الأُمَّة. ثم يأتي البحث على علاقة سُنَّة التغيير بمنظومة القِيَم، وصلتها بعدد من القِيَم التي لا تقوم الأُمَّة دون وجودها.
كلمات مفتاحية: السّنة، القيمة، الأمّة، ثقافة سننية، تفكير سنني، علم السّنن. القيم العليا.
مقدمة
في هذا البحث حديثٌ موجزٌ عن ثلاثة مفاهيم مفتاحية، هي: السُّنَّة، والقيمة، والأُمَّة، وهذه المفاهيم مركزية في معجم الألفاظ القرآنية. لذا، فإنَّ استحضار هذه المفاهيم حاجة مطلوبة في كل وقت، ولكنَّ ذلك يكون في بعض الحالات حاجة مُلِحَّة تستدعي أولوية خاصّة من الاهتمام والبحث والمعالجة. وحالة الأُمَّة الإسلامية في العالَـم المعاصر تستدعي هذا الاهتمام وهذه الأولوية.
وتتأكَّد هذه الحاجة عندما نُدرِك موقع الثقافة السُّنَنية والتفكير السُّنَني، والاعتبار بالسُّنَن في حياة الأُمم كما يعرضها القرآن الكريم؛ فقيام الأُمَّة وبقاؤها يعتمد على عدد من الـمُقوِّمات، تقوم الأُمَّة بوجودها، وتضعف أو تنهار بغيابها، وهذه سُنَّة الله. وبعض هذه الـمُقوِّمات تختصُّ بكيان الأُمَّة الداخلي، وبعضها الآخر يـختصُّ بالتدافع بين الأُمم، وموازين القوى الـمُؤثِّرة في علاقاتها. وإذا كانت الأمور تتميَّز بضدِّها، فإنَّ غياب التفكير السُّنَني يعني التفكير الفوضوي العبثي الذي لا يبني أُمَّةً، ولا يحفظ كياناً.
ولكنَّ مفهوم “السُّنَن” لا يقف عند المعنى الضيِّق الذي يحيل إلى ثقافة دينية تقليدية تحجُر دلالة النصوص في سياق تراثي وتاريخي، وإنَّـما تحيل الدلالة القرآنية للسُّنَن إلى ما جعله الله في العوالم الطبيعية والاجتماعية والنفسية من قوانين، يُلِحُّ القرآن الكريم على ضرورة الكشف عنها وفهمها وتوظيفها. وإنَّ ربط هذه القوانين بتشريعات يُعِين الإنسان على ضبط حركة حياته؛ لتَتَّسِق مع تلك السُّنَن والقوانين.
وموضوع القِيَم في حياة الأُمَّة تعبيرٌ واضحٌ عن مُقوِّمات بناء الأُمَّة، وهو حديث حاضر في كثير من البحوث والدراسات، وفي كثير من البرامج التعليمية الـمسطرة، والممارسات التعليمية والوعظية. لكنّ معظم هذا الحديث يتوزَّع على جانبين؛ إمّا صياغة الفرد على القِيَم النبيلة الفاضلة، مثل: الصدق، والأمانة، والوفاء … وإمّا تجنُّب القيام بمخالفات الكذب، والخيانة، والسرقة، مع العِلْم بأنَّ مفهوم “القِيَم” يَتَّسِع إلى أبعد من ذلك بكثير، ليتصل بالوجود البشري الجمعي، الذي يتمثَّل في المجتمعات والأُمم والدول، وما يَلزمها من نُظُم وتشريعات، وما يكون فيها، وفيما بينها من علاقات.
ولذلك، فإنَّ بناء أُمَّة جديدة، أو تجديد بناء كيانها؛ لنقلها من حالة إلى أُخرى، يستدعي وجود نوعين من القِيَم، لا يُغْني أحدهما عن الآخر؛ الأوَّل: القِيَم الخاصّة بشخصية الإنسان الفرد في هذه الأُمَّة؛ إذ لا خلاف على أنَّ الأُمَّة بأفرادها، وأنَّ وحدة التغيير تبدأ بالفرد. والثاني: القِيَم اللازمة للانتقال بحالة الأُمَّة إلى كيان تتماسك عناصره، وتأتلف مُكوِّناته؛ لينظر إليه العالَـم، فيجده رقماً صعباً، لا يقطع صُنّاع القرار في العالَـم برأيٍ دونَه؛ فهي أُمَّة واحدة لها حضورها السياسي، والاقتصادي، والإعلامي، والعلمي.
والتعزيز اللازم لكلا النوعين من القِيَم ليس مسألة فردية تتمُّ بالتأمُّل أو بالأماني، وإنَّـما هي مسألة اجتماعية تتولّاها مؤسسات المجتمع التي تُعْنى بالفرد الإنساني منذ الطفولة الـمُبكِّرة، وبالتأثير الـمُتساوِق لسائر مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتنمية الفكرية؛ حتى ينشأ الفرد، وتتكوَّن الجماعة، ويُبنى المجتمع في بيئة ثقافية مشتركة، تكون فيها تجلِّيات القِيَم الاجتماعية والحضارية نتيجة تلقائية.
ومن الـمُلاحَظ أنَّ مفهوم “الأُمَّة” عانى كثيراً من القصور في استعماله، ويكاد يغيب عن التداول عندما نتحدَّث عن الأُمَّة الإسلامية في هذه الأيام، بتأثير الشكِّ في الاحتفاظ بالـمُقوِّمات والقِيَم التي قامت هذه الأُمَّة على أساسها، والشكِّ في إمكانية استعادتـها في ضوء الوقائع القائمة في العالَـم المعاصر. ومن هنا تأتي أهمية استدعاء هذا المفهوم، وتأكيد موقعه في الخطاب الإسلامي المعاصر، والتفكير في سُنَن قيام الأُمم بصفة عامّة، وسُنَن قيام الأُمَّة الـمُسلِمة على وجه الخصوص.
ويتضمَّن هذا البحث أربعة مباحث، تبدأ بالحديث عن السُّنَّة، ثمَّ عن الأُمَّة، ثمَّ ينطلق الحديث عن سُنَن قيام الأُمم عن طريق الربط بين السُّنَن والقِيَم والـمُقوِّمات، وتأكيد موقع منظومة القِيَم العُليا في كيان الأُمَّة. وأخيراً سنضرب مثلاً على علاقة بعض السُّنَن بمنظومة القِيَم، وهي سُنَّة التغيير وصلتها بعدد من القِيَم التي لا تقوم الأُمَّة دون وجودها.
أوَّلاً: في معنى السُنَّة
جاء لفظ “سُنَّة” ولفظ “سُنَن” في القرآن الكريم في إحدى عشرة آية. وقد تحدَّث السياق في آيتين منها عن سُنَّة الله تعالى في التعامل مع الرُّسُل، وحفظه لهم، ونصره إيّاهم. أمّا في الآيات التسع الأُخرى فقد كان السياق حديثاً عن سُنَّة الله في الـماضين من الأُمم. قال تعالى: ( لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِين) [الحجر:13]، وقال سبحانه: (قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِين) [آل عمران: 137]، وقال عَزَّ من قائل: (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم) [النساء: 26]، وقال تبارك وتعالى: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا)[الأحزاب: 38]، وذلك من قبيل تلقّي الأُمم لهدى الله سبحانه، ونتائج أفعالها بإزاء هذا الهدى في الحياة الدنيا أو في الآخرة.
ولم يأتِ ذكر السُّنَن -بلفظها- في مجال مخلوقات الله تعالى في آفاق العالَـم الطبيعي، مثل: حركة الشمس والقمر، ومظاهر الأشياء وتغيُّرها في الفصول، وحركة الرياح، وتكوُّن السحب، ونـزول الـمطر، والبراكين والفيضانات؛ ممّا اعتاد الكُتّاب الـمُحْدثون أنْ يتحدَّثوا عنها بعبارة: “سُنَن الله أو قوانينه أو نواميسه في مخلوقاته في هذا العالَـم”.
أمّا في الحديث النبوي فقد جاء لفظ “السُّنَّة” بمعانٍ كثيرة، منها الـمعاني التي وردت في القرآن الكريم؛ أيْ طريقة الله وعادته سبحانه، ومنها السُّنَّة النبوية التي هي الـمصدر الثاني في التشريع،[1] ومنها السُّنَّة التي هي مُقابِل الفريضة الواجبة، وهي عند الـمُحدِّثين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ؛ مـمّا يُثاب فاعله، ولا يأثم تاركه.[2] ومنها عادة الأُمم أو الأجيال السابقة في عمل مُعيَّن،[3] ومنها القانون والعُرْف الدوليان في عدم قتل الرسول الذي تَبعث به أُمَّة إلى أُخرى بخصوص شأنٍ مشترك بينهما.[4]
وقد دار معظم الـمُفسِّرين في القديم والحديث على الدلالات التي حملتها هذه السياقات القرآنية؛ بمعنى عادة الله وطريقته سبحانه في التعامل مع البشر ومع الأنبياء. ولكنَّ بعض الـمُفسِّرين أخذوا يستعملون ألفاظاً ومصطلحاتٍ لمعنى “السُّنَّة” استدعتها مستجدات الاستعمال اللغوي، قد يكون أقربها إلى معنى “السُّنَّة” مصطلح “القانون”. وبينما لا نجد هذا الـمصطلح في كثير من التفاسير القديمة، مثل: “تفسير الطبري”، و”القرطبي”، و”ابن كثير”، فإنَّنا نجده في حالات قليلة عند ابن عطية في “الـمُحرَّر الوجيز”، وعند الزمخشري في “الكشّاف”، وعند أبي حيّان في “البحر الـمحيط”، ثمَّ في حالات أكثر عند فخر الدين الرازي في “مفاتيح الغيب”، ثمَّ نجده مُستعمَلاً على نطاق أوسع في التفاسير التي هي أحدث، كما هو عند ابن عاشور في “التحرير والتنوير”. وسنعرض موجزاً لطرق استعمال لفظ “القانون” عند الرازي وابن عاشور من الـمُفسِّرين؛ لتكوين فكرة عن السياقات التي يستخدم فيها كلٌّ منهما مصطلح “القانون”.
فقد استعمل الرازي مصطلح “القانون” في عدد من الـمعاني، منها القواعد اللغوية مثل قانون الاستعارة (الرازي، 1420ﻫ، ج15، ص374)، وفي معنى القوانين العقلية الحكمية الدالَّة على جواز الكرامات (الرازي، 1420ﻫ، ج21، ص436)، وطريقة القرآن الكريم في توالي الـمعاني في الآيات القرآنية (الرازي، 1420ﻫ، ج13، ص10)، وفي القاعدة التي تُحدِّد الراجح من الـمرجوح في معاني الآيات القرآنية (الرازي، 1420ﻫ، ج7، ص139)، وفي معنى القوانين الطبية، والقوانين الفلكية (الرازي، 1420ﻫ، ج18، ص436).
أمّا محمد الطاهر بن عاشور فقد استعمل مصطلح “القانون” في عدد من الـمناسبات والمعاني، منها القواعد اللغوية في نظام العربية، ومنها الـمنهج الـمُعتمَد في التفسير، ومنها قوانين الـمشاعر النفسية والعلاقات الاجتماعية، ومنها قانون الله في الهدى والضلال، والقوانين الـمنطقية الـمُعتمَدة لدى الحكماء والفلاسفة، والقوانين العقلية في الجدل والمناظرة، وقانون جزاء الله الناس على اتّباعهم شريعته، وقوانين الحُكْم في السياسة والاقتصاد، وإقامة نظام العدل.
ومع ذلك، فقد استُعمل مصطلح “القانون” بمعنى “السُّنَّة” في بيان سُنَّة الله في خَلْق الـمخلوقات، ودفْع الناس بعضهم ببعض؛ “ذلك أنَّ الله تعالى لمّا خَلَق الـموجودات التي على الأرض من أجناس وأنواع وأصناف، خَلَقها قابلة للاضمحلال، وأودع فيها سُنَناً دلَّت على أنَّ مراد الله بقاؤها إلى أَمَدٍ أراده، ولذلك نجد قانون الخَلَفيَّة مُنبَثّاً في جميع أنواع الـموجودات، فما من نوع إلّا وفي أفراده قوَّة إيجاد أمثالها؛ لتكون تلك الأمثال أخلافاً عن الأفراد عند اضمحلالها. وهذه القوَّة هي الـمُعبَّر عنها بالتناسل في الحيوان، والبذر في النبات …” (ابن عاشور، 1984م، ج18، ص35). وفي معنى سُنَّة الله سبحانه في خَلْقه الأشياء، وحكمته في مناسبة ظروفها، سمّى ابن عاشور ذلك قانوناً؛ “لأنَّ بعض الأمكنة تكون أسعد لنشأة بعض الـموجودات من بعضٍ آخرَ؛ لمناسبةٍ بين طبيعة الـمكان وطبيعة الشيء الـموجود فيه من حرارة أو برودة أو اعتدال، … فالله تعالى يوجِد الـموجودات في الأحوال الـمناسبة لها، فالحيوان والنبات كله جارٍ على هذا القانون” (ابن عاشور، 1984، ج2، ص501).
إنَّ كل ما ورد أعلاه في معاني السُّنَّة في القرآن الكريم والحديث الشريف وكتب التفسير لا يزال يُستعمَل في الكتابات الحديثة، ولكنَّ موضوع السُّنَن أصبح عِلْماً واسع الأرجاء.
وللإمام محمد عبده نصٌّ صريحٌ في تسمية السُّنَن بالقوانين والشرائع والنواميس؛ فآيات القرآن الكريم صريحة في: “أنَّ لله في الأُمم والأكوان سُنَناً لا تتبدَّل، والسُّنَن هي الطرائق الثابتة التي تجري عليها الشؤون، وعلى حسبها تكون الآثار، وهي التي تُسمّى شرائع أو نواميس، ويُعبَّر عنها بالقوانين” (عبده، 2011، ص83-84).
وقد جمع عبد الكريم زيدان في كتابه عن “السُّنَن الإلهية” ما يختصُّ من السُّنَن بالأفراد والجماعات والأُمم، وعبَّر عن سُنَّة الله بأنَّـها قانون إلهي عام، فقال: “وحيث إنَّ سُنَّة الله تعالى الـمُتعلِّقة بأفعال البشر وسلوكهم هي طريقته الـمُتَّبَعة في معاملته للبشر…، وما يترتَّب على ذلك من نتائج مُعيَّنة في الدنيا والآخرة. فهذا يعني أنَّ معنى “السُّنَّة” هو معنى “القانون العام” من حيث خضوع أفعال البشر وسلوكهم لأحكام هذه السُّنَّة التي يُمكِن تسميتها بالقانون العام” (زيدان، 1993، ص13-14). “وهذا الخضوع من الأفراد والأُمم في جميع أحوالهم لهذا القانون الرهيب يساوي بالضبط خضوع الأحداث الكونية المادِّية لهذا القانون؛ فكما أنَّ سقوط تفّاحة من شجرة هو نتيجة حتمية لأسباب مُعيَّنة أدَّت إلى هذا السقوط، فكذلك يُعتبر سقوط دولة أو هلاك أُمَّة نتيجة حتمية لأسباب مُعيَّنة أدَّت إلى هذا السقوط” (زيدان، 1993، ص23-24).
ويُمكِن التمييز بين سلوك الإنسان وسلوك الأشياء في العالَـم الطبيعي؛ ذلك أنَّ “سُنَن الله التي فطر الخليقة عليها، التي لا تتبدَّل ولا تتغيَّر، تجعلها تسير على النهج الذي تسير عليه، ولا تستطيع الطبيعة أنْ تنتهك القانون الطبيعي … أمّا الإنسان الذي تحلّى بالشجاعة وقَبِلَ حمل الأمانة، فهو قادر على طاعة الأمر الإلهي التكليفي، وعلى عصيانه” (الفاروقي، 2016، ص70-71) ولذلك، فإنَّ السُّنَن التي تختصُّ بفعل الإنسان والاجتماع البشري، منها ما يكون في الطاعة ولها سُنَنها، ومنها ما يكون في المعصية ولها سُنَنها.
ونحن لا نجد مشكلة في استخدام الألفاظ والمصطلحات في مجالات العلوم والمعارف، مثل استخدام لفظ “القانون” دلالةً على السُّنَّة، بما يُعِين على تقريب فهم الأفكار والمعاني إلى الناس، وتسهيل فهمها، إذا أسهم ذلك في خدمة الـمقاصد القرآنية في مجالاتها العامة والخاصة. وقد عبَّر ابن عاشور عن قبول هذا الاستعمال بقوله: “فلا يُلام الـمُفسِّر إذا أتى بشيء من تفاريع العلوم ممّا له خدمة للمقاصد القرآنية، وله مزيد تعلُّق بالأمور الإسلامية” (ابن عاشور، 1984، ج1، ص42- 43).
وموقع عِلْم السُّنَن يتصل اتصالاً مباشراً بالعقيدة الإسلامية أو ما يُسمّى الفِقْه الأكبر. ومن ثَمَّ، فهو يحكم حياة الإنسان في مجالاتها كلّها، وهو بذلك أقرب ما يكون إلى عِلْم العمران البشري أو عِلْم الاجتماع، وعِلْم الأنثروبولوجيا الذي هو من العلوم التي انشغل بها كثير من الـمُفكِّرين من مختلف الأُمم على مدار التاريخ، وحاولوا فيها الكشف عن القوانين والسُّنَن التي تحكم التغيُّرات التي تحصل في حياة الأُمم والشعوب، والعوامل والأسباب الكامنة خلف هذه التغيُّرات (لوبون، 2014م، ص11).[5]
إنَّ قيمة عِلْم السُّنَن هي في استشراف الـمستقبل، والسعي نحو تحقيق الأهداف الـمنشودة بوعي وثقة وبصيرة وتخطيط. والـمُهِمُّ في العِلْم بالسُّنَن الإلهية هو ما يتعلَّمه الإنسان من مُتطلَّبات تحقيق تلك الأهداف، وتسخير هذه الـمعرفة في الوصول إليها بأسبابها ووسائلها.
ويتضمَّن عِلْم السُّنَن دراسة مفهوم “السُّنَّة”، وأهميتها، وأصنافها، وبناء وعي سُنَني أو ثقافة سُنَنية، تُمكِّن الإنسان من استحضار السُّنَّة كلَّما احتاج إلى أنْ يفهم حدثاً أو ظاهرةً أو تغيُّراً، أو أنْ يقوم بعمل يحلُّ به مشكلةً أو يُحقِّق به هدفاً على الـمستوى الفردي أو على مستوى الـمجتمع والأُمَّة. ويرى عبد الكريم زيدان أنَّ الآيات القرآنية الدالَّة على السُّنَن تفوق في عددها تلك الآيات الخاصّة بالأحكام، وفي ذلك إشارة إلى أهمية الوعي بالسُّنَن من أجل التفكُّر والاتِّعاظ من جهة، ومن أجل فهم سُنَن الله تعالى في الاجتماع البشري من جهة أخرى. وتتوزَّع الآيات الدالَّة على السُّنَن في سياقات مُتنوِّعة، منها قصص الأنبياء مع أقوامهم، وأخبار الأُمم السابقة، والمواجهة الأزلية بين أهل الحقِّ وأهل الباطل، والتفكُّر في الآفاق والأنفس، ونتائج سعي البشر في الدنيا والآخرة (زيدان، 1993، ص19).
إنَّ استقصاء كتب التفسير والمعاجم في القديم والحديث، وغيرها من كتب الفِقْه والفكر والثقافة، يكشف عن تنوُّع واسع في معنى السُّنَّة، وما يُفهَم من سياقات ورودها في القرآن الكريم، فنجد من هذه الـمعاني: الطريقة، والعادة، والسيرة، والمناهج، والوقائع، والنواميس، والشرائع، والقوانين، والضوابط، والمعايير، والعهود، والأقدار، والبصائر.
وبالرغم من أنَّ السُّنَّة في معناها العام هي الطريقة الجارية التي تكون مألوفة ومعروفة؛ لاتِّصافها بالسلوك الـمضطرد الـمعتاد، فإنَّ هذا السلوك الـمضطرد الذي اعتاد صاحبه على فعله في حالات مختلفة، وبمرور الزمن، يصبح سيرة معروفة يُمكِن ملاحظتها، والاستفادة منها بالاقتداء والاتِّباع لِما فيها من خير ومصلحة، ويصبح عادة تُنبِئ بما سيأتي لاحقاً، ويصبح قانوناً يحكم السلوك، ويصبح منهجاً يتمثَّل بالتفكير السُّنَني. وبعض السُّنَن كانت شرائعَ وأحكاماً قرَّرها الله سبحانه لعباده، وهي من أقدار الله سبحانه، وهي بصائر للناس تُبصِّرهم وتهديهم إلى ما ينفعهم.
- 1. أهمية عِلْم السُّنَن في الفكر الإسلامي:
السُّنَن الإلهية التي تحكم حياة البشر، والسُّنَن الكونية التي تحكم الكون الـمادي في آفاقه الواسعة والدقيقة، كلُّها تجري بانتظام عجيب، وتقدير دقيق، وكلها تشهد بوجود الخالق سبحانه ووحدانيته، وكلها تـجري بعِلْمه سبحانه وإرادته وحكمته. ولهذا، فإنَّ لدراسة السُّنَن شأناً عظيماً بالإيمان والعقيدة بأركانها وخصائصها. وكلُّ اكتشاف جديد من انتظام سُنَن الله تعالى في الكون يُعمِّق الإيمان بقدرة الخالق العظيم، وبفضله على الناس حين يُعلِّمهم ما لم يكونوا يعلمون، عندما يسلكون أسباب النجاح في أيِّ اكتشاف.
إنَّ الوعي بالسُّنَن كما أراد الله سبحانه أنْ يُعلِّمها للإنسان هو الكفيل بانتظام حياة الإنسان، وتمكينه من القيام بحقِّ الخلافة والعمران، وإنَّ تدبُّر هذه السُّنَن بنوعيها: الكونية والاجتماعية هو ما يبني عند الإنسان رؤية للعالَـم تَتَّصِف بالتكامل والشمول؛ التكامل بين موقع الفرد والجماعة والأُمَّة في بناء الاجتماع البشري، والتكامل بين الكسب في الدنيا والجزاء في الآخرة، وإنَّ الاعتبار بهذه السُّنَن هو ما يربط فهم الإنسان للماضي والحاضر والمستقبل.
ومن ثَـمَّ، فلا ينفع في دراسة السُّنَن -ضمن سياق النهوض الحضاري- محض الاطِّلاع السطحي العابر، ولا الدراسة الـمُتعمِّقة لجمع الـمعلومات، وتصنيفها، وتحليلها، ونشرها للترقّي في الـمكاسب الشخصية والرتب العلمية. صحيحٌ أنَّ هذه الدراسة لا بُدَّ أنْ تكون دراسة علمية هادفة، لا تكتفي بتطوير عِلْم جديد كما تطوَّرت سائر العلوم في الحياة الإسلامية، مع نـموِّ الـمعرفة، ونـموِّ الحاجة إليها، بل يجب تحويل الـمعرفة بهذا العِلْم إلى سعي عمليّ لإنجاز التغيير الـمطلوب في حياة الأُمَّة، واستئناف موقعها في الوسطية والخيرية، والإسهام في ترشيد الحضارة الإنسانية وتوجيهها.
إنَّ تأكيدنا أهمية دراسة السُّنَن في سياق النهوض الحضاري للأمَّة جاء من يقيننا بأنَّ هذا النهوض يحتاج إلى توافر ثلاثة أهداف مُتكامِلة، هي: اكتشاف السُّنَن، وفهمها، وتسخيرها. ومن الـمُلاحَظ أنَّ الحديث عن السُّنَن في القرآن الكريم جاء في سياقات مُتعدِّدة، يُعِين تدبُّرها على تحقيق هذه الأهداف الـمُتكامِلة؛ فمن هذه السياقات ما يُبيِّن للناس أنَّ هذه السُّنَن هي منهج القرآن “لإعمار الكون وتحقيق الاستخلاف الـمنشود، … وهي الدليل على طريق الرشاد والهداية والفلاح في الدنيا والآخرة، وهي مصدر الـمعرفة والقوَّة والتمكُّن في الأرض، وهي دليل الانتظام والتناسق والإعجاز في الخَلْق والحركية الكونية والبشرية، ومنها أنَّـها مصدر للمعرفة بالآفاق والأنفس. ومن ثَمَّ، تحقيق الذات عن الـمعرفة والعِلْم السُّنَني الـموصِل إلى بناء الحضارة والعمران البشري الـمُتوازِن الذي أمر به الحقُّ تبارك وتعالى” (برغوث، 2007، ص13-48).
إنَّنا في سعينا لبناء عِلْم السُّنَن ونشر الثقافة السُّنَنية لا نبدأ من فراغ، ولكنَّنا نستند إلى مرجعية الوحي الإلهي الذي نشأت الأُمَّة الإسلامية على هدايته، وإلى تراث ضخم من فهم علماء الأُمَّة لهذه الـمرجعية عبر تاريخها، وكان واضحاً أنَّ نصوص الوحي وفهوم العلماء لها كانت تُلاحِظ سُنَن الله تعالى في مخلوقاته بنوعيها؛ سُنَن الله في الأشياء والأحداث والظواهر الكونية الطبيعية، وسُنَن الله في البشر وأفعالهم وأحوالهم. وكان بعض العلماء يُدرِكون الحاجة إلى “عِلْم السُّنَن”، وضرورة توظيفه في حياة الأفراد وواقع الأُمَّة، وإذا لم يتيسَّر الوصول إلى الدرجة العليا من الوعي والإدراك عند جميع الأفراد، فلا مناص من توافره لدى القادة من أهل العِلْم والسلطان؛ ذلك أنَّ هذا الوعي والإدراك قد لا يتحقَّق إلّا عند القليل، يقول ابن خلدون: “ومن الغلط الـخَفِيِّ في التاريخ الذهولُ عن تبدُّل الأحوال في الأُمم والأجيال بتبدُّل الأعصار ومرور الأيام، وهو داء دَوِيٌّ شديد الخفاء؛ إذ لا يقع إلّا بعد أحقاب متطاولة، فلا يكاد يتفطَّن له إلّا الآحاد من أهل الخليقة، وذلك أنَّ أحوال العالَـم والأُمم وعوائدهم ونِحَلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنـَّما هو اختلاف على الأيام والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول، سُنَّة الله التي قد خلت في عباده” (ابن خلدون، 2004، ج1، ص321).
وقد أطال ابن القيِّم الحديث عن علاقة النتائج بالأسباب، كما يُوضِّحها القرآن الكريم، فقال: “وقد رتَّب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة، وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشرط، والمعلول على العِلَّة، والـمُسبِّب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع.” ثم ذكر عدداً من الأمثلة التي يُرتِّب الله فيها الحُكْم الخَبري الكوني، والأمر الشرعي، على الوصف الـمناسب له، وبصيغة الشرط والجزاء، وبلام التعليل، وبأداة كي، وبباء السببية، وبالمفعول لأجله، وبلمّا، وبإنَّ، وبلَوْلا، وبلَوْ. ثمَّ قال: “وبالجُمْلة، فالقرآن من أوَّله إلى آخره صريحٌ في ترتيب الجزاء بالخير والشَّرِّ والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال، ومَنْ فَقِه هذه الـمسألة وتأمَّلها حقَّ التأمُّل انتفع بها غاية النفع” (ابن القيم، 1429ﻫ، ص31-35).
وإذا كان عِلْم السُّنَن أو فِقْه السُّنَن لم يتطوَّر بالقدر الكافي في ما سبق، فإنَّ الـمشكلة الكبرى هي في غياب الثقافة السُّنَنية، وضحالة الوعي بفِقْه السُّنَن، وضعف التفكير السُّنَني، ورُبَّما يعكس ذلك جانباً من مشكلات الأُمَّة الإسلامية، وعدم توظيف الـمُقوِّمات الأساسية للخروج من هذه الـمشكلات وَفق سُنَن الله الجارية في قيام الأُمم ونهوضها.
- 2. ماذا يعني اكتشاف السُّنَن؟:
وعد الله سبحانه وتعالى أبا البشر آدم u ألّا يتركه دون هداية تَقيه من الضلال والشقاء. قال تعالى: (قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ) [طه: 123]. وقد تواصلت رسالات الهداية بعد آدم u إلى ذُرِّيَّته حتى خُتِمت الرسالات بمحمد r. ففي القرآن -مثلاً- بيانٌ واضحٌ لبعض أشكال الهداية التي تتمثَّل في السُّنَن الإلهية، التي نطق بها القرآن صراحةً؛ ليتدبَّرها الإنسان، ويَتَّعِظ بها. وفي القرآن الكريم دعوةٌ مُلِحَّةٌ ومُتكرِّرة لاستخدام مَلَكات التعقُّل والتفكُّر والتدبُّر؛ لاكتشاف السُّنَن عن طريق السير والنظر في ملكوت الله والتفكُّر في مخلوقاته، من مثل قوله سبحانه: (أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ) [الأعراف: 185]. وقد أكْثرَ القرآنُ الكريمُ من لفت النظر إلى آيات الله تعالى في الآفاق والأنفس، وما تتضمَّنه هذه الآيات من سُنَن الكون الـمادي، والاجتماعي البشري، والبناء النفسي، من مثل قوله سبحانه: ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ) [فصلت: 53]، وقوله تعالى: ( وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) [النمل: 93]. وفي هاتين الآيتين وعدٌ من الله تعالى بأنَّه سيُري الإنسان من آياته، والسين في “سنريهم” وفي “سيريكم” هي للمستقبل القريب، ورُبَّـما يعني ذلك أنَّ الله تعالى سيُمكِّن الإنسان أنْ يكتشف من سُنَن الله تعالى وقوانينه في الخَلْق في كل وقت، كلَّما اتَّخذ الطرق والأساليب الملائمة لهذا الاكتشاف. ومن هنا، فإنَّ السعي للكشف عن السُّنَن بالسير والنظر والتعقُّل والتبصُّر لا يُعَدُّ ترفاً عقلياً وسلوكاً اختيارياً، وإنـَّما هو واجب ديني وضرورة حياتية للإنسان الـمُسلِم. وحين يكتشف العلماء سُنَّة من سُنَن انتظام وجود الأشياء أو حدوث الظواهر واطِّرادها، فإنَّ في ذلك ميداناً للتسخير والتوظيف في ما يُـحقِّق مصالح مُعيَّنة أو يدرأ مفاسد مُعيَّنة، ثمَّ إنَّه ميدان لمزيد من الاكتشاف.
ومن الأمثلة على ذلك أنَّ علماء الكيمياء اكتشفوا أنَّ العناصر الكيميائية الـمعروفة تـخضع لنظام دقيق من دَوْرِيَّة التركيب والخصائص (periodicity)؛ ما سمح لهم بوضع هذه العناصر في جدول يحوي أعمدةً لعائلات مُتشابِهة في الخواصِّ، وصفوفاً أُفقيةً تتغيَّر خواصُّها بالتدريج. واكتشف العلماء أنَّ بعض الـمواقع في الجدول يجب أنْ تكون فارغة، لعدم معرفتهم بعناصر ذوات تراكيب وخصائص تُحدِّدها تلك المواقع؛ ما دعا إلى توقُّع اكتشاف هذه العناصر. وقد اكتُشِفت بالفعل، وتبيَّن أنَّ كُلّاً منها تمتلك الخواصَّ التي يُحدِّدها موقعها في الجدول، وفي ذلك دليل على صحَّة التوقُّعات مع كل اكتشاف جديد. وقد أسهم الجدول الدوري في البحث عن سِرِّ الدورية في الخواصِّ الكيميائية والفيزيائية للعناصر، فاكتُشِف أنَّ التشابة والاختلاف في هذه الخواصِّ يكمن في البِنية الإلكترونية للعناصر، وهذه البِنية لم تكن قد اكتُشِفت من قبلُ، وأدّى اكتشاف هذه البِنية إلى اكتشاف مزيد من النظريات العلمية، مثل: ميكانيكا الكَمِّ، والنسبية، والنشاط الإشعاعي وغير ذلك (شيري، 2016، ص11).
ولا تزال الفكرة الأساسية لدورية الخواصِّ قائمة، ولا تزال تسمح باكتشافات أُخرى. ففي عام 2015م، وافق الاتِّحاد الدولي للكيمياء النظرية والتطبيقية على إقرار اكتشاف لثلاثة عناصر، أُضيفت إلى الجدول في أماكنها التي كانت مُخصَّصة لها قبل أنْ تُعرَف (شيري، 2016، ص37-39).[6]
ولكنَّ اكتشاف السُّنَن، وفهم موضوعها وخصائصها، ليس مسألة تَرَفٍ علمي، وتَرَقٍّ معرفي، وإنَّما يُمثِّل الخطوة الأساس للتمكُّن من تسخير السُّنَن في جلب الـمصالح ودرء الـمفاسد، وتوظيفها -في نهاية الـمطاف- في جهود بناء الأُمَّة ونهوضها الحضاري. وهذا يتطلَّب التعامل مع موضوع السُّنَن بوصفه حقلاً دراسياً يقع في الأهمية ضمن الـمقاصد الشرعية والفرائض الدينية. ومن ثَمَّ، تكون دراسته ضمن منظومة العِلْم والمعرفة في صورتها الـمُتكامِلة. فالنهوض الحضاري الذي نسعى إلى أنْ تُحقِّقه الأُمَّة يتطلَّب فهماً عميقاً لآيات الله تعالى في الآفاق والأنفس، ودرجةً عاليةً من الوعي بنُظُم الاجتماع البشري وقوانينه، وجهداً متواصلاً من التفاعل العمراني الاستخلافي.
وجهود اكتشاف السُّنَن لا بُدَّ أنْ تستند إلى ما بيَّنه الله سبحانه من هذه السُّنَن في نصوص صريحة، وإلى ما طلب اكتشافه من هذه السُّنَن بالسَّيْر والنظر والبحث الـمنهجي. ولا ننسى أنَّ جهود فهم السُّنَن وخصائصها وأصنافها تستند إلى مجموعة من الـمبادئ، مثل العلاقة بين الأسباب والنتائج، وأنَّ أقدار الله تعالى في الناس إنَّـما تتحقَّق بسعيهم، وأنَّ جهود تسخير السُّنَن تتحقَّق بالاعتبار والتدبُّر، ومزيد من العِلْم بخصائص الأشياء وقوانينها، وتوظيف ما هو كامن فيها من طاقات، وتوفير مُتطلَّبات التغيير من مُقوِّمات بناء الأُمم، وعوامل نـهوضها الحضاري الـمنشود.
وقد توسَّع القرآن الكريم في بيان أساليب تعرُّف السُّنَن واكتشافها والاعتبار بها. وأهمُّ هذه الأساليب هو السَّيْر في الأرض، والنظر والاعتبار، والتفكُّر في نوعين من آيات الله سبحانه، هما: الآيات التي تتحدَّث عن قصص الأنبياء وتاريخ الأُمم الـماضية وآثارها الباقية، وآيات الله في الآفاق والأنفس التي يُتوصَّل إليها بالسَّيْر والنظر والبحث والاكتشاف.
وجاء في “تفسير الـمنار” حديثٌ مُفصَّلٌ عمّا سمّاه الـمُؤلِّف “الأصول العلمية والعملية من دينية واجتماعية” لسورة الأنعام، وذكر واحداً وعشرين أصلاً، يَتَّصِل بعضها بموضوع السُّنَن، منها الأصل الرابع عشر الذي جاء في الحثِّ على دراسة عِلْم الاجتماع وسُنَن العمران عن طريق “النظر في أحوال الأُمم وعواقب الأقوام التي كذَّبت الرُّسُل، في أثناء السير في أرضها، ورؤية آثارها، وسماع أخبارها … وهذا النظر والاعتبار لا خلاف بين العلماء في وجوبه شرعاً، وكونه مطلوباً لذاته، ومقصوداً من السياحة والسَّيْر في الأرض.” وقد بيَّن الـمُؤلِّف أنَّ السير والسفر قد يكون مباحاً، أو مندوباً، أو فرضَ عينٍ، أو فرضَ كفايةٍ. وكذلك قد يكون مكروهاً أو مُحرَّماً. وكل ذلك بناءً على نِيَّة الـمسافر، ومقدار ما يتحقَّق له ولأُمَّته وبلاده من نفع أو ضرر. ثمَّ قال: “وأجمعُ الآيات لتكميل النفس بالسفر من طريق الدراية الـمستفادة بالنظر والاكتشاف والاعتبار، وطريق الرواية والتلقّي عن أهل العِلْم والبصيرة والاختبار، قوله تعالى: ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ). [الحج: 46]” (عبده ورضا، 1947، ص289-290).
وقد أوضح الله سبحانه سُنَنه في كتابه الـمسطور في صورة أحكام وتوجيهات وتشريعات، تُعِين الإنسان على تحقيق هدف الاستخلاف والعمران، وفي صورة بيان لسلوك الإنسان (فرداً، وأُمماً، وأقواماً) ونتائج هذا السلوك، وكرَّر توجيه الإنسان إلى السَّيْر في الأرض والاعتبار بهذه السُّنَن، ومن ذلك قوله سبحانه: ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ [الروم: 42]. وفي القرآن الكريم كثيرٌ من قصص الـماضين التي تكشف عن سُنَن الله تعالى في ربط النتائج بالأسباب في عالَـم البشر. فبعض هذه القصص فيها عِبْرة بنتائج الظلم والفساد، كما في قصص فرعون وعاد وثمود، وبعضٌ آخرُ فيه عِبْرة بنتائج الاستقامة على الهدي الإلهي، والاستجابة لأمر الله، والصبر على البلاء، كما في قِصَّة يوسف u.
- 3. تصنيف السُّنَن:
ثمَّة معايير مختلفة لتصنيف السُّنَن، ولكنَّنا في سياق هذا البحث سنكتفي بالإشارة إلى نوعين أساسيين يُمكِن التمييز بينهما في نصوص القرآن الكريم. أمّا النوع الأوَّل فيختصُّ بالإنسان الفرد وبالتجمُّع الإنساني في الأقوام والشعوب والأُمم، وما للوجود البشري من اختيار في فعله وحساب عليه. وهو يشمل آيات الله في الأنفس، وسُنَن التعامل بين الأفراد والشعوب والأُمم، وسُنَن أمر الله في سلوك البشر ونتائج هذا السلوك في الدنيا مع ما ينتاب هذا السلوك من أحوال أو مراحل النشأة والصعود والهبوط، وَفق الأسباب والعوامل الفاعلة في ذلك. ويغلب على هذا النوع من السُّنَن اسم السُّنَن الاجتماعية. وهي تشمل السُّنَن النفسية، وسُنَن نُظُم الإدارة، والحُكْم، والسياسة، والاقتصاد، وعلاقات الأُمم.
وأمّا النوع الثاني فيختصُّ بخَلْق الله بصورة عامَّة، ممّا تخضع له الـمخلوقات من قوانين قهرية، كما في وجود الأشياء وتركيبها وحركتها في مستوياتها الكبيرة؛ من: مَجرّاتٍ، وشمسٍ، وقمرٍ، ورياحٍ، وسحابٍ، وأرضٍ، وسماءٍ، وأنهارٍ، وبحارٍ، وحيوانٍ، ونباتٍ، بما في ذلك تبدُّل الليل والنهار، وحركة أعضاء الكائنات الحيَّة ومصيرها بالموت أو في وجودها وحركتها في مستوياتها الدقيقة، التي تتناهى في الصغر حتى مستوى الذَّرّات والخلايا، وما في تركيبها من أجزاء، وما ينتابها من حركات. وقد غلب على هذا النوع من السُّنَن اسم السُّنَن الكونية، وجرى التركيز عليها في الثقافة الـمعاصرة؛ لصلتها الـمباشرة بعلوم الأشياء والأحياء، وسلوكها وَفق قوانين مُنضبِطة.
وهكذا أصبحت القوانين الطبيعية والاجتماعية تعبيراً عن معنى السُّنَن الإلهية.
ورُبَّـما نجد تناظراً بين تصنيف السُّنَن في هاتين الفئتين، مع ما يُمكِن تمييزه في القرآن الكريم من آيات الخَلْق وآيات الأَمْر. فإذا كان ربُّنا سبحانه وتعالى هو صاحب الخَلْق والأَمْر في هذا العالَـم ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ [الأعراف: 54]، فإنَّ سُنَنه سبحانه تشمل سُنَن الكون الـمخلوق، سواء ما كان من أمر العالَـم الطبيعي من الذَّرَّة إلى الـمَجرَّة، ومن الخلية إلى الكائنات الحيوانية والنباتية، وما فيها من سُنَن الخَلْق. وكذلك تشمل سُنَنه سبحانه في الوجود البشري والاجتماع الإنساني، بما في ذلك ما يختصُّ بالنفس الإنسانية وأحوالها، وسلوك الأفراد وتعاملاتهم، وقيام الـمجتمعات والأُمم وانهيارها، مـمّا يُعَدُّ من سُنَن الأمر.
وقد أوضح الله سبحانه سُنَنه في كتابه الـمنظور، بكثير من الآيات المتلوَّة التي تلفت النظر إلى آيات الله تعالى في تقلُّب الليل والنهار، وجريان الشمس والقمر إلى أجل مُسمّى، وتكوُّن السحب وحركتها، ونـزول الـماء، وإنبات النبات، وكرَّر توجيه الإنسان إلى السَّيْر والنظر في ملكوت السماء والأرض، ومن ذلك قوله سبحانه: (أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ) [الأعراف: 185]، وقوله تعالى: (قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ) [يونس: 101]، وقوله تعالى: (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ ) [الروم: 8]. فلا قيمة للسَّيْر والنظر دون تفكُّر وتعقُّل، ودون تدبُّر واعتبار؛ فالـمُهِمُّ في السَّيْر والنظر هو إعمال منافذ الوعي والإدراك من أعين وآذن وقلوب، كلٌّ منها في وظيفتها، وفي ذلك يقول الله سبحانه: ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ) [الحج: 46].
وقد ذكر محمد قطب أمثلة على بعض السُّنَن التي يُمكِن تبيُّنها في القرآن الكريم (قطب، د.ت، ص56)،[7] في السياق الذي كان موضوع اهتمامه، وهو السُّنَن ذات الصلة بالتفسير الإسلامي للتاريخ، وتبيَّن لنا من طريقته في ذكر هذه السُّنَن أنَّ أقدار الله سبحانه في حياة البشر كلها سُنَن، فذكر – مثلاً – سُنَّة التمكين، وسُنَّة الابتلاء، وسُنَّة الإملاء، وسُنَّة الكدح، وسُنَّة التدمير. ثمَّ أشار إلى أنَّ كل سُنَّة تجري في حياة الناس، إنَّما تجري “من خلال سُنَن أُخرى في الحياة البشرية. فالواقع أنَّ السُّنَن الإلهية لا تعمل فرادى، إنَّـما تعمل مُجتمِعة، وتكون النتيجة الواقعية هي حصيلة السُّنَن العاملة كلها في آنٍ واحد أو بالأحرى، حصيلة تعامل الإنسان مع مجموع السُّنَن التي تعرَّض لها أثناء حركته في الأرض” (قطب، د.ت، ص59). ولهذا، فإنَّ اللازم في دراسة السُّنَن إعمالُ الرؤية الكلية التي تكشف عن التكامل والترابط بين السُّنَن، بما في ذلك التكامل بين أنواع السُّنَن الكونية والاجتماعية والنفسية، والتكامل بين مفردات السُّنَن في النوع الواحد منها.
وقد حَفَلَ القرآن الكريم بذكر سُنَن الله تعالى بلفظ “السُّنَن” أو بما يدلُّ عليها، في آيات تخصُّ السُّنَّة الكونية، وآيات أُخرى تخصُّ السُّنَّة الاجتماعية. وقد يأتي نوعا الآيات في سياق واحد؛ ليدلَّ ذلك على التكامل في سُنَن الله تعالى، وأنَّها تعمل معاً؛ فهي لا تعمل في الغالب فرادى، وإنَّما تعمل مُجتمِعة، لا سيما في حياة المجتمعات والشعوب (قطب، 1991، ص53)، ومن ذلك قوله تعالى: (ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60) ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ). [الحج: 60-61]. فإذا كانت سُنَّة الله أنْ ينصر مَنْ وقع عليه البغي، فإنَّ سُنَّته كذلك تقليب الليل والنهار، والقادر على الثانية قادر على الأولى.
- 4. مقاصد السُّنَن:
إنَّ أهمَّ مقصد من مقاصد السُّنَن هو الاعتبار، وقد جاءت الألفاظ القرآنية الـمُشتَقَّة من جذر “عَبَرَ” في تسعة مواقع، منها موقع يتحدَّث عن عابر السبيل؛[8] وهو الـمسافر غير الـمقيم، فهو يعبر بلداً غير بلده، وهو مسافر إلى بلده، كمَنْ يعبر من ضَفَّة النهر إلى مقصده في الضَّفَّة الأُخرى. ومنها تعبير الأحلام؛[9] أيْ تأويلها بالعبور من الـمعنى الرمزي إلى الـمعنى الحقيقي الذي هو الـمقصود، فتتحقَّق العِبْرة. أمّا الـمواقع السبعة الأُخرى فقد جاء فيها لفظ “العِبْرة” بالاسم “عبرة” أو بالفعل “فاعتبروا”. وسياقات الاعتبار هي:
أ. الاعتبار بقصص الـماضين: جاء ذلك في سورة يوسف u، مُمثَّلاً بقِصَّته كاملة التي تضمَّنت سلسلة من الحلقات، بصورة تختلف عن قِصَّة كلّ نبيٍّ مع قومه، كما كان حال قصص الأنبياء مع أقوامهم؛ إذ جاءت قِصَّة يوسف u قصةً كاملة بكل وقائعها وأحداثها المتتابعة، في سورة واحدة، وتناولت عدداً من المسائل، منها: الـمشاعر النفسية، والعلاقات الاجتماعية، وأنواع الابتلاء، والرؤى والأحلام، والموارد الاقتصادية، وحياة الـمُؤمِن تحت حُكْم غيره، والحنكة في الإدارة، ومزايا الجغرافيا، … وختم الله سبحانه السورة، بتفاصيلها وأغراضها، بالتنبيه على ضرورة أخذ العِبْرة من كل تلك القصص، والتنوية بأنَّ مَنِ اعتبر بها فهو من أُولي الألباب.[10]
ب. الاعتبار بنوعٍ آخر من قصص الماضين: هو ما يختصُّ بقدرة الله على نصْر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، وإخراج بني النضير من قصورهم الـمنيعة.[11] وفي كلتا الحالتين، فقد كان في ذلك عِبْرة لأُولي الأبصار. وقريب من هذا تأتي آيات سورة النازعات على ذكر ما كان من أمر فرعون، وكيف أخذه الله نكال الآخرة والأولى؛[12] ففي ذلك عِبْرة لمَنْ يخاف ربَّه، فلا يكون مصيره مصير فرعون الذي لم يكن يخشى أو يعتبر.
ت. الاعتبار بما سخَّره الله للإنسان من الأنعام وفوائدها: جعل الله تعالى الأنعام مُسخَّرة للناس، ومُدجَّنة لهم، وطائعة، بحيث يأخذون منها من بين فَرْث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين، ومنها يأكلون.[13]
ث. الاعتبار بالـمَشاهد الكونية: جاء في سورة النور السياقُ بذكر السحاب، والوَدْق الذي يخرج من خلاله، والبَـرَد، والبَرْق، ثمَّ تقليب الليل والنهار. وفي كل ذلك عِبْرة لأُولي الأبصار.[14]
إنَّ سُنَن الله تعالى في الـماضين من الأنبياء، والأُمم، والزعماء، كانت تأتي بعد مقاطع قصيرة أو طويلة من قصص تتناسب مع مقصدها وغرضها في الاعتبار. وكان سرد هذه القصص يتمُّ بأساليب مُتنوِّعة، وكان مقصد الاعتبار يُذكَر بأساليب مُتنوِّعة، منها لفت الانتباه إلى أنَّـها مُوجَّهة إلى أُولي الألباب، وأُولي الأبصار، وأُولي النُّهى. ومنها ما يستثير أدوات الوعي والإدراك عند الناس وتحفيزها: (لعلَّكم تعقلون)، (أفلا تبصرون)، (لقوم يتفكرون) …
وقد ورد تركيب (أُولو الألباب) في القرآن الكريم في ستة عشر موقعاً في سياق التنبيه على أربعة مقاصد، تتكامل دلالاتها في منظومة الحياة العقلية والعملية للمؤمنين، وهذه الـمقاصد هي:
أ. مقصد التذكُّر والتدبُّر: مثال ذلك قوله تعالى: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) [ص: 29].
ب. مقصد حُسْن الاتِّباع: مثال ذلك قوله تعالى: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ) [الزمر: 18].
ت. مقصد التقوى: مثال ذلك قوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ)[البقرة: 197].
ث. مقصد الاعتبار والتفكُّر في مجالين: مجال التفكُّر في آيات الله الـمنظورة من الـمخلوقات، ومثال ذلك قوله تعالى: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) [آل عمران: 190-191]. ومجال الاعتبار بقصص الـماضين، ومثال ذلك قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [يوسف: 111].
فكأنَّ الله سبحانه وتعالى يُوجِّه خطابه إلى أُولي الألباب؛ أيْ إلى أصحاب العقول الراجحة، فيسمعون (أو يقرأون) آيات الله عن الآفاق والأنفس، وعن سُنَنه الجارية في الناس كما يسمعون (أو يقرأون) قصص الـماضين، عسى أنْ يكون منهم التفكُّر والتدبُّر في قدرة الله وعظمته، فتخشع قلوبهم لذكر الله، ويتزوَّدوا بزاد التقوى، ويتحرَّوا حُسْن الاتِّباع؛ لِما في هذه الآيات من الهدى والرحمة، فيكون منهم التفكُّر والتدبُّر والاعتبار، وهو ما يقودهم -في نهاية الـمطاف- إلى ممارسة حياتهم العملية في ضوء ذلك كله.
فالاعتبار هو شأن أُولي الألباب الذين يُحقِّقون في أنفسهم وفي حياتهم هذه الـمقاصد التي تتكامل فيما بينها، لا ليكون العِلْم بها معرفة عقلية نظرية، بل ليكون منهج فهم وتفكير، وبحث واكتشاف، وتسخير وتوظيف.
وبينما جاء لفظ “العِبْرة” خطاباً لأُولي الأبصار، فقد جاء ذكر أُولي الأبصار في أربعة مواقع، كان السياق في ثلاثةٍ منها يذكر أنَّ الآيات الواردة هي عِبْرة لأُولي الأبصار. أمّا الـموقع الرابع ففيه تنويهٌ بمكانة ثلاثة أنبياء، هم: إبراهيم وابنه إسحق، ويعقوب بن إسحق، بأنَّهم أولو الأيدي؛ أي القوَّة في الدين، وأنَّهم أولو الأبصار. والأبصار هنا: جمع “بصر” بالمعنى الـمجازي، وهو النظر الفكري الـمعروف بالبصيرة؛ أي التبصُّر في مراعاة أحكام الله تعالى، وتوخّي مرضاته، كما يرى ابن عاشور (ابن عاشور، 1984، ج23، ص276).
ومع أنَّ لفظ “الاعتبار” في القرآن قد ورد بلفظه في ما يختصُّ بالتاريخ وقصص الأقدمين، فإنَّه جاء بلفظه كذلك في سياق تفاصيل ما يُجريه الله تعالى من سُنَن كونية وَفق نظام وتقدير، وتوجيه الناس إلى السَّيْر والنظر والتفكُّر والتعقُّل في آيات الله في الآفاق والظواهر والأحداث الطبيعية. ومثال ذلك ما جاء عن نـزول الـمطر، وما يسبقه، ويصاحبه، وينتج منه، وما يكون معه من تقلُّب الليل والنهار؛ ليكون في هذا التفصيل تعقُّل وتفكُّر في هذه الظواهر التي يشهدها الناس، فلا يـمرّون عليها وهم عنها غافلون، بل يأخذون العِبْرة من ذلك. ويكون الاعتبار هنا بالإيمان بقدرة الله وحكمته وعدله، ويكون أيضاً بربط الأحداث والظواهر بأسبابها ونتائجها؛ اكتشافاً، وفهماً، وتسخيراً. ومن ذلك قوله سبحانه: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43) يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ). [النور: 43-44].
وقد ارتبط معنى السُّنَّة والاعتبار بها بما مضى وخلا؛ للفت الأنظار إلى ما في التاريخ من دواعي الاعتبار والاستفادة من الوقائع والأحداث، وما كان من أسبابها، وما انتهت إليها نتائجها. فالاعتبار بالماضي يعني دراسة التاريخ، وتتبُّع أحداثه؛ لاكتشاف السُّنَن والاعتبار بها. وقد جاء لفظ “خلت” في مواقع كثيرة؛ لبيان أهمية الاعتبار بالماضي، من مثل قوله تعالى:(سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ) [غافر:85]، وقوله تعالى: (سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) [الفتح: 23]، وقوله تبارك وتعالى: (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [البقرة: 134]، وقوله سبحانه: (قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) [آل عمران: 137]، وقوله عَزَّ من قائل:( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ) [آل عمران: 144]، وقوله جَلَّ جلاله:(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ) [الرعد: 6]، وقوله سبحانه وتعالى: (قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا) [الأعراف: 38]، وقوله جَلَّ في علاه: ( إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) [الأحقاف: 17]، وقوله تعالى:(وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّه) [الأحقاف: 21]، وقوله سبحانه:(كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ) [الرعد: 30]، وقوله عَزَّ من قائل: (وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) [الحجر: 13]، وقوله تعالى: ( سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ). [الأحزاب: 38].
ويدعم معنى الـماضي كذلك أنْ نجد في القرآن الكريم استعمال فعل الـماضي مع السُنَّة. قال تعالى: (وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ) [الأنفال: 38]. وفي الـمعنى كذلك جاء استعمال الـمثل الذي مضى في قوله سبحانه:(وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ) [الرعد: 6]، وقوله تعالى: (فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) [الزخرف: 8]. إذن، فمن الواضح ارتباط معنى السُّنَّة بالماضي الذي خلا وذهب، وبقيت منه العِبْرة لمَنْ يريد أنْ يعتبر، ممّا يأتي في الزمن بعد ذلك الماضي؛ لأنَّ السُّنَّة ماضية ومستمرة في اللاحقين. والاستمرار والتكرار والعودة يَرِدُ كذلك في سياق السُّنَن. قال تعالى: (وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ) [الأنفال: 38]، وقال سبحانه: (وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا) [الإسراء: 8]، وقال تعالى: ( وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ) [الأنفال: 19]. والسُّنَّة تتكرَّر وتَطَّرِد كلَّما توافرت أسبابها وشروطها، بناءً على مُطلِق الإرادة الإلهية؛ فلا يملك أحد أنْ يجري تغيير السُّنَّة أو تبديلها. (فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا) (فاطر: 43).
أمّا الثقافة السُّنَنية التي يريد القرآن الكريم أنْ يُعلِّمها للناس فهي أنَّ ما يجري في العالَـم الطبيعي والعالَـم الاجتماعي من أحداث وتغيُّرات ووقائع، إنَّما يحدث وَفق سُنَن وقوانين وعادات تَتَّصِف بالاستمرار والاطِّراد، ولا تحدث خبط عشواء، ولا تأتي من قبيل المصادفة، وأنَّ ما حدث في الـماضي بأسبابه يحدث اليوم، وسيحدث غداً إذا توافرت أسبابه. وهذا باب من أبواب فهم ما يحدث على ساحة العالَـم اليوم، وما سيحدث مستقبلاً. فما يُمكِن توقُّعه في الـمستقبل لا يتمُّ وَفق ما يرغب فيه الإنسان ويتمنّاه. فإذا أردنا أمراً فما علينا إلّا أنْ نُهيِّئ أسبابه، ليكون وَفق السُّنَّة، وبذلك يكون الاعتبار بالسُّنَّة.
وقد نصَّ القرآن الكريم صراحةً على أنَّ توجيه الناس إلى هذه السُّنَن هو للبيان والهداية والاعتبار. قال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم) [النساء: 26]. فإذا أرادت الأُمَّة أنْ تهتدي إلى السُّبُل الـمُؤدِّية إلى الترقّي والتقدُّم والخروج من حالة الغثائية والتخلُّف والفُرقة، فهذه هي السُّنَن الـمُبيِّنة والهادية، وهي التي تُقدِّم خريطة الطريق إلى فهم الـماضي والحاضر والمستقبل.
إنَّ الثقافة السُّنَنة هي أفكار ومعلومات ومبادئ، يتأسَّس عليها سلوك عملي في مواقف الحياة؛ ومواجهة قضاياها وأسئلتها وتحدِّياتـها. ومن هذه الأفكار معرفةُ السُّنَن وفهمها وتسخيرها. ومعرفة السُّنَن تعني تمييز السُّنَّة ممّا ليس من السُّنَّة، ومعرفة خصائص السُّنَن، وأنواعها، وحدود فعلها، واكتشاف السُّنَن وتوظيفها في السلوك والعمل. وهذا يعني التفكير على أساس هذه الـمعرفة، في تحديد السلوك الـمناسب والنتائج الـمُتوقَّعة لهذا السلوك. ويكون ذلك في مجال التعامل مع جميع قضايا الحياة ومشكلاتها، وليس في مجال دون آخر، تعاملاً يُحقِّق الـمصالح، ويدرأ الـمفاسد.
وتجتمع في التفكير السُّنَني كلّ فضائل التفكير السليم وأنواعه وخصائصه؛ فالإنسان في التفكير السُّنَني يُعْمِل كل مَلَكات الوعي والإدراك؛ من: تفكُّر، وتعقُّل، وتدبُّر، وتذكُّر؛ فهو تفكير علمي استدلالي (بالاستقراء، والاستنتاج) يعتمد التحليل المنطقي أو التجربة العملية، وَفق ما يَلزم الموقف من أيٍّ منهما، وهو تفكير سببي يربط الأسباب بالنتائج، والـمُقدِّمات بالمآلات، وهو تفكير نقدي يتفحَّص ما قد يكون من الجديد الـمُسعِد أو الخَلَل الـمُقعِد.
ولكنَّ أهم خصائص التفكير السُّنَني أنَّه تفكير مستقبلي استراتيجي؛ لصلته المباشرة بالاعتبار. ومن ثَمَّ، فمفهوم “الاعتبار بالسُّنَّة” يعني فهم حالة الإنسان في واقعها، والاتجاهات التي تتحرَّك هذه الحالة فيها. لذا، فهي تكشف عمّا يُمكِن أنْ يحصل مستقبلاً. ولذلك، فإنَّ التفكير السُّنَني يُمكِّن الإنسان من معالجة السُّنَّة بسُنَّة أُخرى. فإذا كانت العوامل التي تتحكَّم في حركة الواقع تؤدّي إلى الانحدار والتقهقر والفشل والهزيمة، فيجب على مَنْ يُفكِّر سُنَنياً أنْ يأخذ بالعوامل التي تُوجِّه حركة الواقع إلى الصعود والنهوض والنصر.
هذا النوع من التفكير السُّنَني لن يقبل بـما قد يسود من خرافات مهما كَثُرَ عدد الـمُعتقِدين بـها، ولن يقبل التفكير الجبري الذي يُخطِئ في فهم قَدَر الله وإرادته، ويفرُّ أصحابه بهذا الفهم الخطأ إلى الاستكانة والعجز، ويُردِّدون مقولة: “ليس بالإمكان أبدع مـمّا كان”، ولن يقبل التفكير السُّنَني بـالتفكير الآبائي الذي اعتادت عليه أجيال سابقة من أنماط التفكير، من قبيل: (بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ) [الزخرف: 22]، ويعجز أصحابه عن التعامل مع مُحدِّدات الواقع الـمُتغيِّر ومستجداته ومُتطلَّباته.
ثانياً: في معنى الأُمَّة:
- 1. الدلالات المعيارية والعملية لمفهوم “الأُمَّة”:
جاء لفظ “الأُمَّة” في القرآن الكريم في ستة وأربعين موقعاً بصيغ الـمفرد والجمع (أُمَّة، وأُمم) والتعريف والتنكير (الأُمَم، أُمم)، والمخاطب (هذه أُمَّتكم)، والغائب (تلك أُمَّة) بعدد من الـمعاني، شاملة الإنس والجن: (كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ) [الأعراف: 38]، والدواب والطير: (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم) [الأنعام: 38]. وكلها تعني اجتماع أفراد هذه الكائنات بأعداد كبيرة للقوم كلّهم، أو لجماعة منهم، كما وردت بمعنى اجتماع مفردات الزمن: ( وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ) [هود: 8]. وجاءت بمعنى الفرد الواحد الذي يُؤتَـمُّ به: ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ [النحل: 120]، وبمعنى الـمِلَّة أو الدين: (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ) [الزخرف: 22].
وبين “الأُمَّة” بهذه الـمعاني الـمُتعدِّدة نسب وصلة بعدد من مشتقات الجذر “أَمَـمَ”، مثل الأُمِّ، والإمام، والأُمِّيِّ، والأَمِّ بمعنى القصد. أمّا الحديث عن تعدُّد الـمعاني، واتِّصال بعضها ببعض، فليس من شأن هذا البحث، وإنَّـما الذي يهمُّنا هو الأُمَّة بمعنى الجماعة من الناس. والمواقع التي ورد فيها هذا الـمعنى تشير إلى تعدُّد الأُمم في الـمكان الواحد، وإلى تتابع الأُمم في الأزمان الـمختلفة، وأنَّ هذا التعدُّد هو مشيئة الله U، وأنَّـها ظاهرة باقية، وأنَّ الله سبحانه جعل للأُمم شرائع ومناسك مختلفة، وأنَّ الناس سيأتون يوم القيامة إلى ربِّهم أُمماً مختلفةً، وأنَّهم كما كانوا في الدنيا أُمماً مختلفةً في الإيمان أو الكفر، فسوف تختلف عاقبتهم في الآخرة؛ في الجَنَّة أو في النّار.
وفي حال تخصيص مصطلح “الأُمَّة” وقَصْره على الناس، فإنَّ الأُمَّة (بضَمِّ الهمزة) اسمٌ للجماعة الذين أمْرُهم واحد، وهي مُشتَقَّة من الأَمِّ (بفتح الهمزة)، وهو القصد؛ أيْ يَؤُمّون غاية واحدة. وإنَّـما تكون الجماعة أُمَّة إذا اتَّفقوا في الموطن أو الدين أو اللغة أو في جميعها (ابن عاشور، 1984، ج2، ص298). ويُؤكِّد ابن عاشور أنَّ ما يَتَّفِق عليه الناس الذين يشملهم مفهوم “الأُمَّة” لا بُدَّ أنْ يكون “من عظائم أمور الحياة”. ونظراً إلى سياقات مُتعدِّدة يَرِدُ فيها لفظ “الأُمَّة” في القرآن الكريم؛ فإنَّ معنى الأُمَّة يَتَّضِح “في كل مقام بما تدلُّ عليه إضافتها إلى شيء من أسباب تكوينها” (ابن عاشور، 1984، ج12، ص188).
ونجد لفظ “الأُمَّة” في الأحاديث النبوية بالمعاني نفسها التي وردت في القرآن الكريم، فنجد أخباراً عن الأُمَّة التي يُبعَث فيها نبيُّها، وعن الأُمم الذي سبقت أُمَّة النبيِّ محمد r. وكذلك نجد أحاديث كثيرة يَرِدُ فيها لفظ “أُمَّتي”؛ أيْ أُمَّة محمد عليه الصلاة والسلام، لا سيَّما في سياق الحديث عن خصوصيات هذه الأُمَّة، وشأنـها وموقعها بين الأُمم الأُخرى في الدنيا والآخرة. وقد ورد في الأحاديث أيضاً أنَّ الكلاب أُمَّة من الأُمم، وأنَّ النمل أُمَّة من الأُمم. ومـمّا يلفت الانتباه أنَّ لفظ “الأُمَّة” قد ورد في صحيفة المدينة بـمعنى “الأُمَّة الدينية” التي تجمع أُمَّة المؤمنين بالإسلام، من سكّان يثرب (المدينة) من المهاجرين والأنصار، و”الأُمَّة السياسية” التي تكوَّنت من “الأُمَّة الدينية”، إضافةً إلى “مَنْ تبع بـهم، وجاهد معهم”، وإلى تسع طوائف من اليهود وردت أسماؤها تحديداً في الصحيفة، وأنَّـهم “أُمَّة مع المؤمنين”، ولكنَّ لكلٍّ دينه، ويـجمعهم كيان سياسي واحد، ولكل فئة من الفئات حقوق، وعليها واجبات من التناصر، والنفقة، والتضامن، والدفاع المشترك عن المدينة. وبـهذا جاء التمييز بين لفظ “الأُمَّة” بالمعنى الديني، ولفظ “الأُمَّة” بمعنى الكيان السياسي أو الدولة.
وكان موضوع الأُمَّة في التراث الإسلامي يَرِدُ في الدراسات الفقهية الخاصّة بقضايا الخلافة والإمامة، بالإشارة إلى حقِّ الأُمَّة، وإجماع الأُمَّة، وبيعة الأُمَّة، … وفي مجالات العلاقات النفسية والاجتماعية، بالإشارة إلى مشاعر التوادِّ والتعاطف والتراحم بين الـمؤمنين. صحيحٌ أنَّ هذين الـمعنيين لا يزالان قائمين ومُستعمَلين في الدراسات الحديثة على الـمستوى النظري، ولكنَّ الـمعالجة التي تفرض نفسها بقوَّة اليوم في ما يختصُّ بالأُمَّة، إنَّـما تتناول أسئلة الحُكْم ونُظُم السياسة في مجالاتها العملية (الداخلية، والخارجية).
والمسألة هنا ليست مسألة تطوُّر في مفهوم “الأُمَّة” وَفق تطوُّر الوعي البشري في الحاجة إلى إدارة الحُكْم وتنظيم حياة الأفراد، أو وَفْق تطوُّر الخبرة في أنـماط هذه الإدارة والتنظيم، وإنَّـما هي في طبيعة الاجتماع البشري ومُتطلَّباته؛ فالإنسان مدني بالطبع منذ وُجِد، وكان كل رسول يأتي لأُمَّته أو لقومه خاصةً، إلّا خاتمهم؛ فقد جاء للناس كافةً، وكان أغلب خطاب الله تعالى في القرآن الكريم للأُمَّة الـمؤمنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وللناس كافةً: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾. وحتى عندما يكون الخطاب: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ﴾، فهو ليس لفرد من الناس فحسب، بل هو للنوع البشري عامةً.
وعندما أخذ الفكر العلماني يمتدُّ إلى ساحة الأُمَّة الإسلامية، ووجدْنا مَنْ يُصِرُّ على أنَّ الدين علاقة شخصية بين الفرد وربِّه، وأنَّ مسائل الحياة العامة للأُمَّة والمجتمع والدولة هي مسائل “مدنية” لا علاقة لها بالدين؛ كان لا بُدَّ من إعادة الاعتبار إلى موقع الأُمَّة في دين الله، وبيان أنَّ الأُمَّة هي الأصل. فالرسول r “خلَّف وراءه عند وفاته “أُمَّة” قبل أنْ يُخلِّف إماماً، وأنَّه لو لم تكن الأُمَّة لما وُجِد مَنْ يَؤُمُّها. ومن ثمّ، فإنَّ وجود الإمام منسوبٌ أو مُشتَقٌّ، والأُمَّة أو الجماعة تصير هي الأصل … أيْ أنَّ أُمَّة القرآن هي باقية ببقاء الذكر الحكيم … أمّا اختفاء الإمام -وإنْ أضْعفَ وحَطَّ من فاعلية الأُمَّة -… إلّا أنَّه مع ذلك لا ينفي وجودها الذي يُعَدُّ هو ذاته ضماناً لتجدُّدها … فالإسلام عندما جاء بأُمَّة لم يقرنها بحتمية نظامية مُعيَّنة، ومن هنا صارت قيمة عُليا ثابتة لا تحبسها أُطُر جامدة. بل هي القادرة على إيجاد الأشكال والصياغات النظمية التي تتلاءم ومعطيات العصر” (أبو الفضل، 1996، ص23-24).
وقد خصَّص الريسوني كتاباً كاملاً لتأكيد التصوُّر الإسلامي لمكانة الأُمَّة والدولة، وأنَّ الأُمَّة هي الأصل، ومن ثَمَّ فلها الأولوية على الدولة، والدولة تابعة للأُمَّة، والخطاب الفردي تبع للخطاب الجماعي. ورأى الريسوني أنَّ “هذه الـمعاني قد تعرَّضت للضمور والاختلال، بل إلى الانقلاب والانعكاس، وهو ما أفقد الأُمَّة مكانتها وقدرتها على الريادة والعطاء والإبداع، وحوَّلها إلى مُجرَّد ركام ضخم من الأفراد الـمُتفرِّجين الـمُستهلِكين والـمُستهلَكين، بينما تضخَّمت الدولة حتى صارت هي الأصل” (الريسوني، 2012، ص11).
وقد استخدم طارق البشري مفهوم “الأُمَّة” في تحليله واقع الـمسلمين اليوم، من حيث لغة الدول، والنُّظُم السياسية، والمجتمعات والجماعات، والمذاهب، والتشكيلات الاجتماعية … وهو بهذا يعطي الأُمَّة مفهوماً تاريخياً وثقافياً وحضارياً، فيمرُّ بالتطوُّر التاريخي للأُمَّة، ويتوقَّف عند الواقع الـمعاصر الذي يراه حصيلة الوقائع والأحداث والحقائق الـمُتعلِّقة بالقرون الثلاثة الأخيرة من تاريخ الـمسلمين، ليصل -في نهاية الـمطاف- إلى القول: “نحن لسنا أمام عقيدة دينية مُجرَّدة تقتصر فقط على الإيمان بالله سبحانه وبنبيِّه عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنَّنا أيضاً أمام دولة نشأت، ونُظُم سياسية تشكَّلت، وجماعة أو جماعات سياسية تكوَّنت، وعاشت بهذا التكوين الثقافي قروناً بلغت أربعة عشر قرناً حتى الآن، تضمُّها شرعية جهوية ذات مصدر عقيدي واحد، وتفاعلت مع بيئات جغرافية ومواريث حضارية شتّى” (مصطفى، 2015، ج1، التقديم، ص12).
وقد ميَّز البشري بين مفهوم “الأُمَّة” ومفهوم “الدولة”، ورأى أنَّ هذا التمييز يحتاج إلى وقفة طويلة؛ نظراً إلى ما بين المفهومين من علاقة مُعقَّدة، لكنَّه لم يتردَّد في القول بأنَّ “الدولة” مفهوم سياسي، وأنَّ “الأُمَّة” مفهوم فكري اجتماعي (البشري، 2011، ص13). وعندما نتحدَّث عن أيِّ شأن من شؤون الأُمَّة، فإنَّه يُتوقَّع أنْ نكون على قَدْر من الوعي بمعنى “الأُمَّة” التي نتحدَّث عنها. ومن الواضح أنَّ معنى “الأُمَّة” في التفكير الإسلامي يتصل بكيان ديني يجمع الـمؤمنين بالإسلام، وهو معنى لا تلتقطه كلمة nation باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأُخرى، التي تعني غالباً -في السياق الـمعاصر- سكّان الدولة ضمن حدودها السياسية “الوطنية”. والسؤال الذي لا بُدَّ أنْ يُثار هنا هو: هل يُمكِن الجمع بين هذين الـمعنيين، فيكون حديثنا عن شؤون الأُمَّة الإسلامية، ليتناول سائر الـمؤمنين بالإسلام، بالرغم من وجودهم عملياً في كيانات سياسية مختلفة، أم أنَّ معنى “الأُمَّة الإسلامية” لا يَصْدُق إلّا عندما تجتمع في الواقع العملي في كيان سياسي واحد؟
ويتوجه السؤال هنا إلى معنى الكيان السياسي الواحد، لا سيَّما عند البحث عنه في التجربة التاريخية الإسلامية أو في تصوُّره في الواقع الـمعاصر. ومن الـمُؤكَّد أنَّ ثـمَّة أسئلة تفصيلية كثيرة تتوارد عند محاولة الإجابة عن أيٍّ من السؤالين الـمذكورين آنفاً.
ونحن في حدود هذا البحث نودُّ أنْ نتعامل مع الواقع القائم في العالَـم الذي نعيش فيه، فنرى أنَّ الأُمَّة الإسلامية اليوم أُمَّة قائمة، في حالة من حالات القيام، بالرغم من توزُّعها في كيانات سياسية مُتعدِّدة، وبالرغم مـمّا قد يكون بين هذه الكيانات من خلافات.
ونحن نبني رؤيتنا هذه على أساس الـمسؤولية التي يتحمَّلها كل فرد من أفراد هذه الأُمَّة، وللمسؤولية مجالات مُتعدِّدة. وعلى أيَّة حال كان واقع الأُمَّة، فإنَّ مسؤولية الفرد حاضرة؛ فهو مسؤول عن نفسه في علاقته بالله سبحانه، فالإنسان مخلوق لخالق كرَّمه، وفضَّله، وأنعم عليه بنعم لا تُحْصى لقاء أنْ يتحمَّل مسؤولية الخلافة في الأرض، وكل ما سيؤدّيه من مسؤوليات الخلافة بحقِّها هو عبادة. وهو مسؤول أيضاً عن جسمه ومَلَكاته التي بها يستطيع أنْ يتحمَّل الـمسؤولية، ومسؤول عمّا حوله من صلات الرحم والقربى والجوار، ومسؤول عن الـمجتمع الذي يعيش فيه، في دوائر انتمائه وامتداداتها؛ فكل ذلك واجباتٌ مفروضةٌ عليه، ومسؤولياتٌ منوطةٌ به، وهو في كل ذلك يتحمَّل أيَّة مسؤولية لِما هو تحت رعايته؛ فالفرد الرجل يكون في الأُسرة ابناً، وأخاً، وأباً، وجَدّاً، وعَمّاً، وخالاً. وكذلك الحال بالنسبة إلى الـمرأة. والفرد يُمارِس عملاً في الـمجتمع، ويكون على مستوى من مستويات الـمسؤولية في ذلك العمل؛ فهو مسؤول عمَّن دونه في الـمسؤولية، ومسؤول أمام مَنْ يرأسه في الـمسؤولية، ومسؤوليته تختلف باختلاف ما هو مسؤول عنه؛ فكل فرد راعٍ ومسؤول عن رعيَّته.[15]
- 2. مُقوِّمات الأُمَّة وأركانها:
إذا كان للإسلام أركان خمسة معروفة، فإنَّ وجود هذه الأركان لا يعني وجود بناء للإسلام؛ فالـمُهِمُّ هو البناء الذي تقوم عليه هذه الأركان. والإسلام هو بناء كامل، بُنِـي على أركان تأخذ قيمتها من وجودها في البناء، فإذا لم يُستكمَل البناء فإنَّ الأركان لا قيمة لها في حَدِّ ذاتها.
ويتجلّى بناء الإسلام في شخصية الإنسان الـمُسلِم، وفي كيان الأُمَّة الـمُسلِمة. وبالرغم من أنَّ الصلة وثيقة وضرورية بين بناء الفرد وبناء الأُمَّة، فإنَّ ثمَّة تفاصيل في مُقوِّمات بناء الفرد ومُقوِّمات بناء الأُمَّة.
إنَّ البناء في حقِّ الفرد المسلم هو بناء شخصيته الـمُتكامِلة؛ عقيدةً وعبادةً، وأخلاقاً وسلوكاً. وأيَّـما كانت الجوانب الأُخرى في بناء الإسلام مهمة، فلا يُمكِن التهوين من البناء الأخلاقي الفردي؛ إذ كم من الخير تَحقَّق في عالَـم البشر عن طريق هذا البناء الفردي. والمسألة هنا لا تقتصر على مَنِ اصطفاهم الله تعالى من الرُّسُل والأنبياء وغيرهم من الشخصيات، فاستحقوا أنْ يُؤتَـمَّ بهم، ويُسار على سُنَنهم، وإنَّ كُلّاً من التاريخ القديم والتاريخ الحديث قد عرف شخصيات مُتميِّزة عن سائر الناس، بفضل مواقفها وإنجازاتها. وفي ما يختصُّ بالقديم، نكتفي ببعض مَنْ أشار إليهم القرآن الكريم؛ فمنهم مَنْ ذكر الله شأنه دون التصريح باسمه. قال تعالى: ( وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِين) [القصص: 20]، وقال سبحانه: (وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ) [يس: 20]، وقال تعالى: ( وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّه) [غافر: 28]. ومِنْ هؤلاء الأفراد مَنْ ذكر القرآن الكريم شيئاً عنهم، بأسمائهم أو بأوصافهم، من مثل لقمان، وذي القرنين. ولا ننسى أنَّ مِنْ بين هؤلاء مَنْ كانوا سبباً في ضلال أقوامهم وهلاكهم: (وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ) [طه: 79] دون رفع الـمسؤولية عن القوم: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) [الزخرف: 54].
ومن التاريخ الحديث نتذكَّر كثيراً من الأفراد الذين كانت تتمثَّل في كلٍّ منهم شخصية الإنسان الـمُسلِم في السلوك والمعاملة. ألـم تكن الشخصية الفردية هي التعبير الوحيد عن بناء الإسلام في نظر الـملايين الذين دخلوا الإسلام في آسيا وإفريقيا لهذا السبب وحده، في مراحل مختلفة من انتشار الإسلام في العالَـم، ولا يزالون يدخلون الإسلام في سائر بلاد العالَـم حتى اليوم؟ ولهذا، فمن الـمُهِمِّ أنْ يكون بناء الفرد الـمُسلِم في شخصيته (نفساً، وعقلاً، وسلوكاً) موضع عناية في جهود الإصلاح وبناء الأُمم على الدوام.
ولكنَّ دين الإسلام ليس دين أفراد فحسب، بل هو دين أُمَّة تتكوَّن من جميع الأفراد الـمؤمنين بهذا الدين؛ إنَّه دين أُمَّة بمعنى فريد يستحق كثيراً من البيان. ويستحق أنْ يستند هذا البيان إلى الـمعنى الذي أراده الله تعالى في كتابه العزيز؛ فقد أشرْنا إلى أنَّ ذكر “الأُمَّة” في القرآن الكريم جاء ضمن مجموعة من الـمعاني، ولكنَّ هذه الـمعاني مُجتمِعة تتداخل وتتكامل فيما بينها ضمن دوائر مُتضامِنة، وضمن خصائص مُميَّزة.
ورُبَّما تكون أوسع الدوائر لمفهوم “الأُمَّة” في معنى دين الله الذي أراده للناس، وأرسل الأنبياء إليهم من أجله؛ فهو دين واحد. قال تعالى: ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ [آل عمران: 19]. والمؤمنون بهذا الدين هم أُمَّة واحدة. ففي سورة الأنبياء مثلاً بدأت الآيات الكريمة بذكر موجز للكتب التي نـزلت على موسى وهارون ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ثمَّ أخذت تذكر شيئاً عن إبراهيم ولوط وإسحق ويعقوب، ثمَّ نوح وداود وسليمان وأيوب، ثمَّ إسماعيل وإدريس وذي النون وزكريا وعيسى، ثمَّ أعقبت على ذلك كله بالقول( إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) [الأنبياء: 92]. وفي سورة المؤمنون، بدأ الله سبحانه بذكر نوح u، ثمَّ أشار إلى مَنْ جاء بعده مِنَ الرُّسُل والقرون والأُمم، وصرَّح بإرسال الرُّسُل متتابعين: (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ) [المؤمنون: 44]، ثمَّ خَصَّ موسى وهارون، ثمَّ خاطب الرُّسُل جميعاً بقوله: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ). [المؤمنون: 51-52].
وهذا هو الأصل؛ فالأنبياء جميعاً جاءوا بالدين نفسه، وأتباع هذا الدين -مِمَّنْ لم يُحرِّفوا، ولم يُبدِّلوا ما جاء به رُسُلهم- هم أُمَّة واحدة. وفي كلتا السورتين (الأنبياء، والمؤمنون)، بيَّنت الآيات الكريمة بعد ذكر الأُمَّة الواحدة أنَّ الناس اختلفوا، وتقطَّعوا أُمماً: (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ) [الأنبياء: 93]،(فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) [المؤمنون: 53]، وأنَّ مصير الناس جميعهم إلى الله يوم القيامَّة؛ لينال كلٌّ مصيرَه بالعدل الإلهي.
إذن، هذه هي الدائرة الواسعة (بل أوسع الدوائر) لمعنى الأُمَّة الواحدة؛ أُمَّة الـمؤمنين بدين الله الواحد الذي جاء به جميع رُسُل الله من الإله الواحد.
وثـمَّة معنى واسع آخر، ولكنَّه أضيق من الـمعنى السابق؛ فإذا كان محمد r هو آخر الأنبياء، وكان القرآن الكريم هو آخر الكتب الـمُنـزَّلة، فإنَّ الـمؤمنين بهذا النبيِّ هم أُمَّة واحدة، سواء أكانوا زمن الرسالة أم مِمَّنْ جاءوا بعد ذلك؛ لأنَّـهم هم الـمؤتـمنون على دين الله الواحد الذي جاء به جميع الأنبياء؛ فأبناء هذه الأُمَّة كافةً يؤمنون بجميع الأنبياء. قال تعالى: ( كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ) [البقرة: 285].
وإذا كانت أُمَّة محمد r هي أُمَّة آخر الزمان، وكانت رسالته عامةً لمَنْ أُرسِل فيهم في زمانه، ولسائر الناس مِنْ بعدهم، فإنَّ كُلّاً من الأنبياء السابقين كان يُبعَث إلى قومه خاصةً، وقد عبَّر القرآن الكريم عن كلّ قوم بلفظ “الأُمَّة”، ضمن معنى أكثر تحديداً للأُمَّة ممّا سبق بيانه. وكان من عدْل الله تعالى في التعامل مع البشر أنْ أرسل إلى كل أُمَّة رسولاً. قال تعالى:(وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ) [فاطر: 24]. وجاء اللفظ صريحاً أنَّ لكل أُمَّة رسولها. قال تعالى: ( ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ ۖ )ﱠ [المؤمنون: 44]. فالأُمَّة هنا هي القوم الذين أُرسِل إليهم رسول بعينه، ولم يُرسَل إلى غيرهم.
وإذا كان الـمسلمون أُمَّة واحدة في ما ينبغي أنْ يكون حالهم، فإنَّ في كيان الأُمَّة العام جماعاتٍ تقوم بمهام خاصّة، وكل جماعة هي أُمَّة، بـما هي مسؤولة عنه من الـمهام؛ فقد أُمِر الـمسلمون أنْ يكون من بينهم أُمَّة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن الـمنكر. قال تعالى: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [آل عمران: 104]. وبالرغم من أنَّ الأُمَّة هنا هي جماعة مخصوصة من أُمَّة الـمسلمين، فقد جاء لفظ “الأُمَّة” هنا ليعطي جميع الـمسلمين الصفة التي تقوم بها هذه الجماعة؛ فقد وجدْنا بعد هذه الآية، وقريباً منها، آيةً تصف الـمسلمين جميعاً بأنَّـهم خير أُمَّة أُخرِجت للناس. ومن وجوه الخيريَّة أنَّ أبناءها يأمرون بالمعروف، وينهون على الـمنكر، أو أنَّ من شروط خيريَّتها أنْ يكونوا كذلك. قال تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ) [آل عمران: 110]، أو أنْ تكون منهم جماعة تقوم بذلك من باب فرض الكفاية.
وقد تكون هذه الأُمَّة ذات الـمهمة الخاصة جماعة كبيرة أو صغيرة. قال تعالى: (وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) [الأعراف: 164]. فهاهنا ثلاث جماعات أو أُمم؛ الأولى: أُمَّة عصت، وارتكبت ما نهاها الله عنه. والثانية: أُمَّة لم ترتكب الـمعصية، وأخذت تَعِظ العصاة، وتنهى عن الـمنكر. والثالثة: أُمَّة لم ترتكب الـمعصية، ولكنَّها لم تنهَ عنها، فقالت الثالثة للثانية: (مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ) [الأعراف: 164].
وقد تكون الأُمَّة شخصاً واحداً له من العزيمة والمكانة ما يقوم مقام أُمَّة في الفضل والتأثير، وهو أُمَّة بما كان يُمثِّله من العزم والقوَّة في بناء عقيدة التوحيد والحركة بها في الأرض. قال سبحانه وتعالى: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّة) [النحل: 120]. وفي ذلك تنويه بالنبيِّ إبراهيم عليه السلام؛ لِـما كان له من “الفضل والفتوَّة والكمال بمنـزلة أُمَّة كاملة … (و) كان أُمَّة وحده في الدين؛ لأنَّه لم يكن في وقت بعثته مُوحِّداً لله غيرُه، فهو الذي أحيا الله به التوحيد” (ابن عاشور، 1984، ج14، ص315-316).
وتتحدَّث منى أبو الفضل عن “الفرد الجماعة” و”الفرد الأُمَّة” في الإسلام عندما تربط عقيدة الـمُسلِم، وهي التوحيد، بتوحيد الشعائر التعبُّدية لوجدان الـمُسلِم وسلوكه في ظلِّ العقيدة؛ ليكفل هذا التوحيد التوافق الداخلي التامَّ بين الفرد والجماعة، بحيث يخرج لنا “الفرد الأُمَّة”، فيُدرِك الفرد بأنَّه من الأُمَّة، ورُبَّـما يترقّى إدراكه ليكون هو ذاته الجماعة والأُمَّة (أبو الفضل، 1996، ص32).
ونحن نجد مصطلح “الأُمَّة” في القرآن الكريم عاماً، يشمل ما عرفه الجنس البشري في كل تاريخه من أُمم. وقد اقتضى عدل الله سبحانه مع البشر أنْ يُرسِل هدايته لكل هذه الأُمم، فقال تعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير) [فاطر: 24].
واستُعمِل مصطلح “القوم” لكل جماعة من البشر لها خصائصها ومُقوِّماتها؛ فقَوْمُ كل نبـيٍّ هم مَنْ أُرسِل هذا النبيُّ إليهم. قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) [إبراهيم: 4]. وقد جاءت نصوص مُحدَّدة من القرآن الكريم، لتكون آياتٍ لقوم يَتَّصِفون بخصائص مُحدَّدة: لقوم يتفكَّرون، لقوم يعقلون، لقوم يعلمون …
وقد تكرَّر لفظ “قوم” في القرآن الكريم ثلاثمئة واثنتين وثمانين مَرَّةً. وربط ابن عاشور بين مصطلح “القوم” والـمُقوِّمات التي يقوم بها كل قوم وَفق ما يُميِّزهم من خصائص يتقوَّمون بها، وتُعبِّر عمّا لديهم من قِيَم. فعندما يتوجَّه الخطاب بالآية إلى “قوم يعلمون”، فإنَّ هذا التحديد لهؤلاء القوم يعني أنَّ “من شأنهم العِلْم؛ لِـما يُؤْذِن به الـمضارع من تجدُّد العِلْم، وإنَّـما يتجدَّد لمَنْ هو ديدنه ودَأْبه؛ فإنَّ العلماء أهل العقول الراجحة هم أهل الانتفاع بالأدلة والبراهين. وذِكْرُ لفظ “قوم” إيـماءٌ إلى أنَّـه رسخ فيهم وصف العِلْم، فكان من مُقوِّمات قوميتهم … وفي هذا تعريض بأنَّ الذين لم ينتفعوا بتفصيل الآيات ليسوا من الذين يعلمون، ولا مِمَّنْ رسخ فيهم العِلْم” (ابن عاشور، 1984، ج11، ص97).
وعندما يتحدَّث القرآن الكريم عن سُنَن كونية مُعيَّنة، مثل قوله تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۖ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الرعد: 3]، فإنَّ “كل واحدة من الأمور الـمذكورة تتضمَّن آيات عظيمة يجلوها النظر الصحيح والتفكير الـمُجرَّد عن الأوهام. ولذلك أجرى صفة التفكير على لفظ “قوم”، إشارةً إلى أنَّ التفكير الـمُتكرِّر الـمُتجدِّد هو صفة راسخة فيهم، بحيث جُعِلت من مُقوِّمات قوميتهم؛ أيْ جبلتهم” (ابن عاشور، 1984، ج13، ص85). وهكذا في سائر السياقات الـمُماثِلة عن (قوم يعقلون)، و(قوم يذَّكَّرون).
وبالمقابل، فإنَّ النبيَّ يُحاجِج قومه ويجادلُـهم ويردُّ عليهم مُقترَحاتهم، ويرى أنَّ هذه الـمُقترَحات، إنَّـما هي تعبير عن الجهل الـمُتأصِّل في قومه، فيقول لهم: (وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُون) [هود: 29]. وزيادة قوله (قوماً) تدلُّ على أنَّ جهلهم صفة لازمة لهم كأنَّها من مُقوِّمات قوميتهم (ابن عاشور، 1984، ج12، ص56).
فسُنَّة الله سبحانه في وجود الأُمَّة أنْ يكون لها كيانـها الـمُوحَّد؛ الـمُوحَّد في معتقداتها وأنظمتها ومشاعرها، والـمُوحِّد لأفرادها وجماعاتها في كيان واحد، والـمُوحِّد لطاقاتها ومواردها ومُقوِّماتها بما يعطيها من القوَّة والمهابة، ويفرض احترامها وتقديرها والاستماع لِما تعرضه وتُقدِّمه. فوحدة كيان الأُمَّة، إنَّما هي ضمان قوَّتها وهيبتها ومكانتها بين الأُمم.
ومن الـمُؤسِف أنَّ أيَّ حديث عن الأُمَّة الإسلامية اليوم رُبـَّما يُنوِّه ببعض تجلِّيات الوحدة في معتقداتـها ومشاعرها، ولكنَّه يُكثِر من مظاهر الفُرقة والتجزئة والاختلاف في أنظمتها، ومن الهدر في طاقاتها ومُقوِّماتها المادِّية. ويصل الحديث عن عمق مظاهر الفُرقة إلى صعوبة تـخيُّل إمكانية اجتماعها في كيان سياسي واحد أو دولة واحدة. ورُبَّـما يجري التذكير بأنَّ انقسام الأُمَّة إلى عدد من الكيانات السياسية كان ظاهرة معروفة في تاريخ الأُمَّة الإسلامية في معظم مراحل هذا التاريخ، ولكنَّ ذلك لم يـمنع من استمرار كثير من مظاهر الوحدة، التي كان لها تمثُّلات مُتعدِّدة، منها: حرية حركة أبناء الأُمَّة عبر الأقطار للإقامة والعمل والتجارة والعِلْم، ممّا لا يتوافر اليوم بين الكيانات التي تتوزَّع عليها الأُمَّة الإسلامية.
وقد تطوَّرت الخبرة البشرية اليوم في بناء الكيانات؛ لتمييز أشكال الترابط بين الناس في كل كيان، ما بين وحدة، واتِّحاد، وتكامل، وتنسيق … وكثير من الـمجموعات البشرية الـمُتعدِّدة والمختلفة في الدين واللغة والعِرْق قد بَنَتْ فيما بينها كياناً واحداً يُوفِّر لجميع هذه المجموعات كثيراً من الـمصالح، ويُحقِّق لها من عناصر القوَّة السياسية والعسكرية والاقتصادية ما لا يتحقَّق لأيّةِ مجموعة مُنفرِدة منها. ونحن نرى كيف أنَّ الولايات الـمتحدة الأمريكية كانت مثالاً على حشد إمكانيات سكّانها الذين جاءوا من كل أطراف الأرض؛ لبناء هذا الكيان الذي أصبح أقوى دولة وأغناها في العالَـم. ومثل ذلك في دولة الهند التي يجتمع فيها نحو ألف وأربعمئة مليون نسمة، يتوزَّعون على ديانات ولغات وأعراق مختلفة، وتجمعهم دولة واحدة، ومثلها في وحدة الدولة وتعدُّد الأديان واللغات والأعراق دولةُ الصين التي يبلغ عدد سكّانها نحو ألف وخمسمئة مليون نسمة. أمّا بالنسبة إلى الاتِّحاد الأوروبي، فبعد قرون مُتعاقِبة من الحروب الطاحنة بين دول أوروبا، اتَّفقت هذه الدول على تكوين هذا الاتِّحاد الذي حقَّق لكل دولة من الـمصالح ما لم يكن بالإمكان أنْ يتحقَّق لكلٍّ منها مُنفرِدة.
وبالـمُقابِل، فإنَّ الأُمَّة الإسلامية أكبر في عدد أبنائها، وفي مُقوِّماتها المادِّية والمعنوية من أيٍّ من هذه الكيانات، ومع ذلك فقد فشلت في تحقيق الحَدِّ الأدنى من مظاهر الوحدة، أو الاتِّحاد أو التنسيق أو التكامل أو التعاون … في تبادل الـمصالح والمنافع. والأكثر إيلاماً لنفوس الـمؤمنين ليس عدم قيام الوحدة أو الاتِّحاد، وإنَّـما فشل محاولات التعاون والتكامل بين دول الجوار، في حين يستمر النجاح في جهود التجزئة والانقسام في عدد من الحالات.
وفي ظلِّ هذا التنوُّع في دلالات لفظ “الأُمَّة” في القرآن الكريم، من العموم والخصوص والسعة والتحديد، فلا بُدَّ أنْ نُؤكِّد أهمية القِيَم في مفهوم “الأُمَّة”. فالذي يجمع أفراد الأُمَّة ليس أنَّـهم من قوم واحد أو أنَّهم يعيشون في مجتمع واحد؛ إذ لم يكن أفراد قوم موسى -مثلاً- على الحالة نفسها من القِيَم. فكل فئة من قومه تجمعها منظومة من القِيَم؛ ما يعني وجود أُمَّة خاصة قال الله سبحانه عنها: (وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون) [الأعراف: 159]. وهذا يعني أيضاً أنَّ ثـمَّة أُمَّةً أو أُمماً أُخرى من قوم موسى ليست من الذين يهدون بالحق، وبه يعدلون؛ فقد سبق هذه الآية قوله تعالى: (اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِين) [الأعراف: 148]. فوجود أُمَّة من الذين يهدون بالحق، وبه يعدلون من قوم موسى، تخصيصٌ لظاهر الآية التي تشير إلى أنَّ قوم موسى اتَّخذوا عجلاً؛ و”قُصِد به الاحتراس لئلّا يُتوهَّم أنَّ ذلك قد عمله قوم موسى كلهم، وللتنبيه على دفع هذا التوهُّم، قدَّم “ومن قوم موسى” على مُتعلِّقه” (ابن عاشور، 1984، ج9، ص142).
وحين تأمَّل طه عبد الرحمن هذه الآية، فإنَّه ميَّز مفهوم “المجتمع” من مفهوم “الأُمَّة”؛ فالمجتمع هو اجتماع مجموعة أفراد يسلكون سبيل الاشتراك في سَدِّ الحاجات وأداء الخدمات، وهذا الاجتماع يقوم على “العمل التعاوني” الذي يَلزم “التعاون بين الأفراد الـمختلفين أو بين الـمجتمعات الـمختلفة”. والتعاون قد يكون على البِرِّ والتقوى، وقد يكون على الإثم والعدوان. “أمّا الأُمَّة فهي الـمجتمع منظوراً إليه من جهة القِيَم التي يدعو إليها، والتي تُؤهِّله لأنْ يُبلِّغها إلى الأُمم الأُخرى؛ سعياً وراء الارتقاء بالإنسان.” وما يمارسه الأفراد في الأُمَّة، وما تمارسه الأُمَّة مع غيرها يكون على أساس “العمل التعارفي”؛ أيْ عمل المعروف؛ إذ حقيقة التعارف هو أنَّه التعاون على المعروف، وترْك التعاون على المنكر (طه عبد الرحمن، 2005، ص20-21).
فالقِيَم هي التي تجمع الأُمَّة، والـمجتمع الواحد (أو القوم الواحد أو القُطْر الواحد) قد يكون فيه عدد من الأُمم المختلفة في التزاماتها القِيَمية.
* دكتوراه في التربية العلمية وفلسفة العلوم، تربوي وأستاذ جامعي أردني، مستشار في المعهد العالمي للفكر الإسلامي. البريد الإلكتروني: [email protected]
ملكاوي، فتحي حسن (2023). سُنَن قيام الأُمم، مجلة “الفكر الإسلامي المعاصر”، مجلد 29، العدد 105، 55-128. DOI: 10.35632/citj.v29i105.7721
كافة الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 2023 ©
الهوامش:
[1] مثال ذلك حديث: “تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّه” (مالك ابن أنس، 1412ﻫ، ح1874).
[2] مثال ذلك حديث: الرمل بالبيت وأنَّها سُنَّة، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: “إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ r رَمَلَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالـمَرْوَةِ، وَهِيَ سُنَّةٌ”، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا” (مسلم، 1998، كتاب: الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة، ص500).
[3] مثال ذلك حديث الأضاحي، وأنَّها سُنَّة أبيكم إبراهيم، كما جاء في “السُّنَن الكبرى” للبيهقي، عن زيد بن أرقم، أنَّهم قالوا لرسول الله r: ما هذه الأضاحي؟ قال: “سُنَّة أبيكم إبراهيم u”، قالوا: ما لنا فيها من الأجر؟ قال: “بكل قطرة حسنة” (البيهقي، 1994، ج9، ص261).
[4] مثال ذلك حديث: قالَ عبد اللهِ، حيثُ قُتِلَ ابنُ النَّوَّاحةِ: إنَّ هذا وابنَ أُثالٍ، كانا أَتَيا النَّبيَّ r، رسولَينِ لمُسَيلِمةَ الكذَّابِ، فقالَ لهُما رسولُ اللهِ r: “أتَشهَدانِ أنَّي رسولُ اللهِ؟”، قالا: نشهَدُ أنَّ مُسَيلِمةَ رسولُ اللهِ، فقال: “لو كنتُ قاتلاً رسولاً، لضرَبتُ أعْناقَكما”، قال: فجَرَتْ سُنَّةً ألَّا يُقتَلَ الرَّسولُ” (ابن حنبل، 2001، ج6، ص240).
[5] من هؤلاء العلماء على سبيل الـمثال الـمُؤرِّخُ الفرنسي غوستاف لوبون، الذي ألَّف كتاباً في هذا المجال، واختار مُترجِم الكتاب لفظ “السُّنَن” ليكون في عنوان الكتاب، بوصفه أكثر تعبيراً عن موضوعه. والكتاب نُشِر أوَّل مَرَّة بالفرنسية عام 1894م، وتُرجِم إلى العربية أوَّل مَرَّة عام 1913م، ثمَّ ترجمه عادل زعيتر مَرَّةً أُخرى، ونُشِر عام 1950م. وموضوع الكتاب كما يقول الـمُؤلِّف في مقدمته: “غايته تعيين بعض السُّنَن النفسية لتطوُّر الأُمم … وتدلُّ تلك السُّنَن على أنَّ عدداً قليلاً من العوامل النفسية الثابتة يُسيطِر على حياة الأُمم، فضلاً عن سيطرة بعض الـمُؤثِّرات التي هي وليدة تقدُّم الحضارة. ويُرى من خلال الزمان والمكان تأثيرُ تلك السُّنَن في كل زمان ومكان، وكان لتلك السُّنَن الأثر البالغ في قيام أعظم الدول، وسقوط هذه الدول” (لوبون، 2014، ص11).
[6] انظر قرار الاتحاد الدولي للكيمياء النظرية والتطبيقية في:
– http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-35220823.
[7] لم يكن محمد قطب بصدد ذكر قائمة تضمُّ السُّنَن؛ فهذا موضوع تركه للدراسات الـمُتخصِّصة.
[8] قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) [النساء: ٤٣].
[9] قوله تعالى: (وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ) [يوسف: ٤٣].
[10] قوله تعالى:(لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [يوسف: 111].
[11] قوله تعالى: ( قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ) [آل عمران: 13]، وقوله سبحانه: (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)[الحشر: 2].
[12] قوله تعالى:(اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (17) فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ (19) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ (20) فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ (22) فَحَشَرَ فَنَادَىٰ (23) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ (24) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ (25) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى) [النازعات: 17-26].
[13] قوله تعالى: (إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ) [النحل: 66]، وقوله تعالى: (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) [المؤمنون: 21].
[14] قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43) يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ) [النور: 43- 44].
[15] عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله r قال: “كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالـمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ- وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ” (البخاري، 1998، كتاب: الاستقراض، باب: العبد راعٍ في مال سيِّده ولا يعمل إلّا بإذنه، حديث رقم2409، ص451)، و(مسلم، 1998، كتاب: الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، حديث رقم1829، ص763).

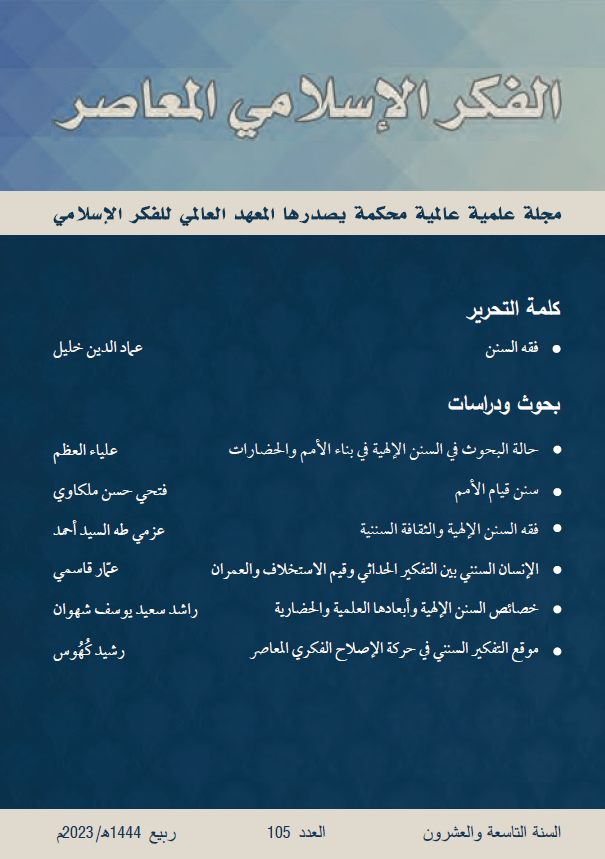



Some genuinely interesting details you have written.Aided me a lot, just what I was looking for : D.