بقلم أ.د. أحمد حسن فرحات(*)
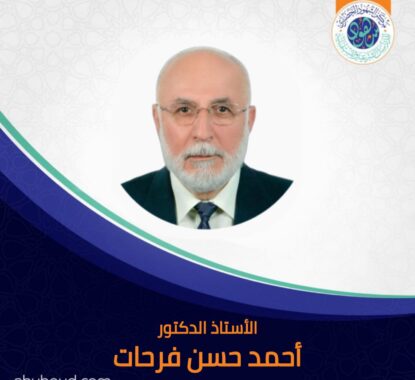
تدافع السنن.. وتنازع الأقدار:
من خلال ما سبق يمكننا القول بأنَّ الحياة البشرية تخضع لسنن كثيرة، وهذه السنن تعتمد في تحققها ونفاذها على عمل الإنسان طبقاً للسُنَّة العامة التي وردت في قوله تعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11].
وكذلك السنن الكونية الكثيرة تتأثر بتدخل الإنسان سلباً أو إيجاباً، مما يظن معه في كثير من الأحيان أن السنن ربما تعدلت أو تخلَّفت، لعدم ترتب النتائج على الآثار.
والحقيقة أن السنن التي تحكم الحياة البشرية أو الحياة الطبيعية: أوسع بكثير مما نظن، وأكثر من أن يحيط بها الإنسان، ومن ثم فكلما تقدم الإنسان في اكتشافه لأسرار الحياة البشرية والكونية، كلما أدرك جديداً من هذه السنن، وغدا أقدر على تفسير الحوادث والوقائع، والاستفادة منها.
إن خضوع الحياة البشرية والكونية لهذه السنن الكثيرة التي تتعذر على الحصر، والتي تتحدى جهود البشر في اكتشافها والإحاطة بها، تتزاحم في عملها، وتتدافع طبقاً لعمل الإنسان الذي يخضع أيضاً لعوامل ودوافع مختلفة، تؤثر فيه قوة وضعفاً، وتقدماً وتخلفاً.
ومن ثم يتحقق من هذه السنن ما تكون له الغلبة على غيره، بناء على العامل والدافع الذي يتغلب في عمل الإنسان. كذلك تكون الأقدار الإلهية في حالة تنازع طبقاً لتدافع السنن، ثم يتحقق القدر المترتب على السُنَّة الغالبة، وهكذا فالسنن جارية لا تتخلف، وإنما يتغلب بعضها على بعض بحسب القوة والضعف، ويمكن أن نلاحظ ذلك في كثير مما يجري حولنا من مشاهد وأحداث:
– من المعلوم أن قانون الجاذبية الأرضية يستلزم أن ينجذب إلى الأرض كل ما يقع في نطاق هذه الجاذبية. ولكننا نرى أن الطيور والطائرات وأمثالها لا تنجذب إلى الأرض، وذلك لأنها تخضع لقانون آخر هو قانون الطيران. وهكذا قانون الطيران لم يلغ قانون الجاذبية، وإنما تغلَّب عليه، وإذا ما حدث خَلَل في الطائر، أو الطائرة أضعف هذا القانون أمام قانون الجاذبية، فإننا نرى الطائر والطائرة يهوديان إلى الأرض لتغلب قانون الجاذبية.
– من سنن الإيمان أن ينتصر المسلمون على المشركين، وذلك لما قدمنا من أن الإيمان يرفع طاقة المؤمنين إلى ضعف طاقة الإنسان غير المسلم في الحد الأدنى، ومع ذلك فلتحقيق هذه السُنَّة لابدَّ من مراعاة شروطها ومقتضياتها والالتزام بالتوجيهات الصادرة إلى المؤمنين.
ويمكن أن نلاحظ في معركة واحدة تحقق هذه السُنَّة حينما توافرت الشروط، والتزم المسلمون بالتوجيهات، وذلك ما حدث في معركة أحد حيث انتصر المسلمون في أول هذه المعركة طبقاً لوعد الله تعالى بنصر المؤمنين، وقد حكاه القرآن الكريم بقوله:
﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ -آل عمران: 152-.
غير أن مخالفة المسلمين الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنازعهم فيما بينهم جعل هذه السُنَّة لا تتحقق لفوات الشروط، وهذه الشروط منصوص عليها في مثل قوله تعالى:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ٤٥ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾[الأنفال:45-46].
وهكذا نرى التدافع بين سنن الإيمان وسنن الإنسان، وكيف تغلبت سُنَّة الإيمان أولاً بتحقق شروطها. ومن ثم كان القدر نصرَ المؤمنين.
ثم كيف دُفعت سُنَّةُ الإيمان، بسُنَّة الإنسان حينما ضعفت سُنَّةُ الإيمان، بمخالفة الرماة، فكان القدر: ما أصاب المؤمنين، من القرح والمصيبة.
– ومن الأمثلة الواضحة- في تدافع السنن وتنازع الأقدار-:
ما جاء في الحديث الشريف الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
” كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً. فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله، فكمَّل به مائة.
ثم سأل عن أعلم أهل الأرض: فدَّل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة، فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة.
انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نَصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب.
فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله.
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط.
فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال:
قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى، فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة.
قال قتادة، فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره” ([1]).
وفي رواية البخاري.. فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحي الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه القرب بشبر، فغفر له) ([2]).
ويتضح من هذا الحديث الشريف التدافع بين سنتين: “سُنَّة التوبة” و” سُنَّة ارتهان الإنسان بعمله” والتنازع بين قَدَريْن: استحقاق العذاب، واستحقاق المغفرة. فملائكة العذاب تريد أن تقبضه، لأنه لم يعمل خيراً قط طبقاً لسُنَّة الله:
﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ -الطور: 21- ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ -المدثر:38- ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ -النجم: 39-
وملائكة الرحمة ترى أنه جاء تائباً، والتوبة تجب ما قبلها، طبقاً لسُنَّة الله سبحانه المتمثلة في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: 25].
فلقد غلبت سُنَّة التوبة سُنَّة العقوبة، ودفع قَدَرُ الذنب بقَدَر التوبة، لأن رحمة الله تسبق غضبه” ([3]).
وهذا يفسر لنا إيحاءه إلى هذه أن تقربي، وإيحاءه إلى هذه أن تباعدي، حتى وجد أقرب بشبر إلى الأرض التي هو متجه إليها، فغفر له.
ومثل هذا دفْعُ قدَر المرض بقدَر التداوي، ودفع قدَرِ الإساءة بقَدَرِ الإحسان. وهذا كله يدل على دفع القدَر الذي قد وقع واستقر، بقَدر آخر يرفعه ويزيله.
– أما القدر الذي انعقدت أسبابه – ولما يقع – فإنه يدفع بأسباب أخرى من القدر تقابله فيمتنع وقوعه: كدفع العدو بقتال، ودفع الحر، والبرد، ونحوه. ومنه ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه:
” لا ينفع حذر من قدر، والدعاء ينفع ما لم ينزل القضاء، وأن البلاء والدعاء ليلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان إلى يوم القيامة” ([4]).
وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها:
(لا ينفع حذر من قدر، والدعاء ينفع – أحسبه قال – ما لم ينزل القدر، وإن الدعاء ليلقى البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة) ([5]).
وفي هذا الحديث دلالة على تنازع الأقدار قبل وقوعها، وأن ذلك سُنَّة جارية إلى يوم القيامة، وأن سُنَّة الدعاء تدفع سُنَّة البلاء، ويغلب قدر الدعاء قدر البلاء. وذلك لأن ما جعل الله الدعاء سبباً له، فهو بمنزلة ما جعل العمل الصالح سبباً له؛ ولهذا أمر الناس بالدعاء، والاستعانة بالله، وغير ذلك من الأسباب.
ومن قال أنا لا أدعو ولا أسال اتكالاً على القدر، كان مخطئاً لأن الله تعالى جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته، وهداه ونصره ورزقه. وإذا قُدِّرَ للعبد خير يناله بالدعاء، لم يحصل بدون الدعاء…) ([6]).
وهكذا تتدافع السنن وتتنازع الأقدار، وتكون النتائج للسنن الأقوى التي يترتب عليها القدر الغالِب، وبمثل هذا الفهم احتج عمر رضي الله عنه على أبي عبيدة رضي الله عنه حينما قرّر عمر عدم الدخول إلى بلاد الشام أثناء وجود الطاعون، حيث قال له أبو عبيدة: أتفر يا عمر من قضاء الله، وقدره؟ فقال عمر: نعم أفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره.
ويرى ابن القيم أن لا نجاة من الغرق في بحر القدر إلا بركوب سفينة الأمر، وحينئذ تكون وظيفة هذا الراكب مصادمة أمواج القدر ومعارضتها بعضها ببعض، وإلا هلك، فيرد القدَرَ بالقَدَرِ. وهذا سلوك أرباب العزائم من العارفين، وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة: عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى:
” الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعاً للقدرـ لا من يكون مستسلماً للقدر”.
ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض، فكيف في معادهم؟ والله تعالى أمر أن تدفع السيئة – وهي من قدره – بالحسنة – وهي من قدره. وكذلك الجوع من قدره، وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع، مع قدرته على دفعه بقدر الأكل، حتى مات كان عاصياً.
وكذلك البرد، والحر، والعطش، كلها من أقداره. وأمر بدفعها بأقدار تضادها. والدافع والمدفوع والدفع من قدره.
وقد أفصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح، إذ قالوا: ” يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتُقىً نتقي بها. هل ترد من قدر الله شيئاً. قال هي من قدر الله.
وفي الحديث الآخر: ” إن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السماء والأرض” وإذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله، أ فيحل للمسلمين الاستسلام للقدر، وترك دفعه بقدر مثله، وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره؟
وكذلك المعصية، إذا قدرت عليك، وفعلتها بالقدر، فادفع موجبها بالتوبة النصوح. وهي من القدر ([7]). فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام، وترك الحركة والحيلة، فإنه عجز. والله تعالى يلوم على العجز. فإذا غلب العبد وضاقت به الحيل، ولم يبق له مجال، فهنالك الاستسلام للقدر ([8])).
وهكذا نرى أن فكرة تدافع السنن. وتنارع الأقدار، تحل لنا كثيراً من الإشكالات المحيطة بقضية “سُنَّة الله” وقدره، كما تكشف لنا سبب تخلف السُنَّة في بعض الأحيان، نتيجة دفعها بسُنَّة أقوى منها. وأنَّ على المسلم ألا يقف مكتوف اليدين تجاه السنن، وإنما عليه أن يغالبها ويدفع بعضها ببعض.
وكما تتدافع السنن، كذلك تتنازع الأقدار المترتبة عليها، وكما تكون نتيجة التدافع للسُنَّة الغالبة، كذلك تكون نتيجة التنازع للقدر الغالب.
خاتمة تلخص البحث
ومن كل ما سبق يمكن أن نقول:
إن “سُنَّة الله” – كما وردت في القرأن الكريم – هي طريق عامة يجري بها أمره في عباده. – وهي طريق العدل والرحمة – وقد تكون شرعية كما تكون كونية تاريخية.
وإنَّ “سُنَّة الله” الشرعية: تتمثل في فروع الشرائع المختلفة الصور، المتحدة القصد، والهادفة إلى تطهير النفس وترشيحها للوصول إلى ثواب الله تعالى وجواره.
وقد وردت بهذا المعنى في آيتين فقط في كتاب الله تعالى.
وإن “سُنَّة الله” الكونية – في استعمال القرآن – تكاد تكون موقوفة الاستعمال على سنن التاريخ، المبنية على سنن الاجتماع. ذلك أن التاريخ هو حصيلة التجارب الإنسانية الطويلة، ومختبر الباحثين والمحللين، الساعين دائماً لاستفادة الدروس والعبر، واكتشاف السنن التي تحكم سير الأمم في تطورها. وإن هذا الاكتشاف يمكن أن يوظف لتوجيه الأحداث الحاضرة والمستقبلية فيوفر على الإنسان كثيراً من الجهود التي يمكن أن تضيع سدى. – وقد وردت “سُنَّة الله” بهذا المعنى، في أكثر الآيات القرآنية.
– ومن سنن التاريخ التي حظيت بعناية خاصَّة “سنن الأنبياء” والمتابعين لهم من أهل الإيمان، ذلك أن فترات الأنبياء التاريخية: تمثل الذرى والقمم التي جعلها الله مثلاً أعلى، تتطلع البشرية للوصول إليه.
ومن “سُنَّة الله” في أنبيائه ورسله: أن يعرضهم لا ستفز از أقوامهم فيحاولون قتلهم، ولكنهم لا يلبثون بعد المحاولة إلا قليلاً، حتى يأخذهم سبحانه أخذ عزيز مقتدر.
ومن السنن التاريخية التي تكرر ورودها في القرآن:
“سُنَّة الله في إهلاك المكذبين” وقد قص الله علينا قصصهم لنعتبر بها، ولما في الاعتبار بها من حاجتنا إليه، ومصلحتنا. وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول – وكانا مشتركين في المقتضي للحكم – فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل – فرعون ومن قبله – لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بما لا نشبهه قط.
ومن السنن التاريخية التي تكرر ورودها في القرآن:
“سُنَّة الله في نصر أوليائه على أعدائه”، وهي شاملة لأعدائه من المشركين، وأهل الكتاب، والمنافقين.
ولقد اقترنت “سُنَّة الله” – الكونية، والتاريخية – بما يفيد ثباتها من مثل قوله: ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ -فاطر: 43-
علماً بأن صيغة “سُنَّة الله” لم تستعمل في القرآن إلا في مجال الاجتماع والتاريخ، غير أن بعض الكتاب توسعوا في مفهوم “سُنَّة الله” لتشمل قوانين الكون وطبائع الخلق. ومن ثم فقد جعلوا هذه القوانين والطبائع مشمولة بالثبات، وعدم التبديل والتحويل، الواردين خاصَّة مع صيغة “سُنَّة الله”.
ويرى العلامة عبد الحميد الفراهي الهندي: أنَّ أول من استعمل صيغة “سُنَّة الله”- بالمعنى الشامل لطبائع الخلق كلها-هم أصحاب رسائل “إخوان الصفا” ثم تابعهم على ذلك ولي الدين الدهلوي صاحب كتاب “حجة الله البالغة”.
كما يذكر ابن تيمية أن السهروردي المقتول ذهب إلى أن العالم لا يتغير.. بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله، وأنه احتج على ذلك بالآيات السابقة التي تنص على أن “سُنَّة الله” غير قابلة التغيير والتبديل.
وقد علل الفراهي ما ذهب إليه القائلون بأن طبائع الخلق من “سُنَّة الله” وأنها ثابتة بعدة ظنون. فقد ظنوا أن التبديل في الخلق محال لقوله تعالى:
﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: 30]. وظنوا أن قوله ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾: كقوله: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 62]
وظنوا أن طبائع الخلق كلها تدخل تحت “سُنَّة الله”، وظنوا أن طبائع الخلق ثابتة، لمَّا علموا من التجربة أن الأشياء لا تتحول عن آثارها، وقد رد الفراهي هذه الظنون واحدة واحدة – كما سبق شرحه وبيانه –
وأما ابن تيمية فقد عرض لاحتجاج السهروردي المقتول وأمثاله من المتفلسفة بآيات السنن على صحة ما ذهبوا إليه من اعتبار العادات الطبيعية من سنن الله الثابتة، وأبطل مزاعمهم، واعتبر احتجاجهم بالقران نوعاً من تحريف الكلم عن مواضعه، وأن القرآن يصرح بنقيض مذهبهم في جميع المواضع.
أما علماؤنا المحدثون والمعاصرون فقد مال معظمهم إلى تعميم صيغة “سُنَّة الله” بحيث تكون شاملة لسنن التاريخ والاجتماع، وقوانين الكون.
كما إنهم قالوا بثبات السنن، وترتب النتائج على الأسباب، غير أن تعبيرهم عن هذه الحقيقة لم يكن متساوياً، بل إن بعضهم كانت له تحفظاته التي تشير إلى ملاحظات خاصَّة، أو استثناءات. ومن ثم نرى أنه من المناسب الإشارة إلى شيء من هذه التحفظات حسبما وردت في أقوالهم.
-من القائلين بتوسيع مفهوم السنن الإلهية وشمولها وثباتها دون تحفظات محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى وذلك في تفسيره “المنار” حيث يكثر من ذكر السنن، دون تفريق بين سنن الاجتماع والتاريخ، أو قوانين الكون وطبائع الخلق.
أما سيد قطب رحمه الله تعالى: فإنه وإن كان يستعمل صيغة “سُنَّة الله” بالمعنى الشامل. فإنه يتحفظ على آلية السنن وحتميتها، بما يتناسب مع طلاقة المشيئة الإلهية، حيث يقول:
” فليست هناك جبرية آلية في الخلق والإنشاء، ولا في الحركة والحدث، والنواميس التي يراها الناس مطردة في الكون – بوجه عام – ليست قوانين آلية أنشأها الله وسلطها لتعمل بذاتها آلية وحتمية، ولكنها تطرد على الجملة، لأن قدر الله في شأنها يطرد في غير جبرية آلية فيها، وفي غير حتمية – على الله سبحانه – في اطرادها. إنما هي مشيئته وحكمته بهذا. فيجري قدره بما يشاء، وهكذا تقع المعجزات الخارقة لما يسمي بالقوانين الطبيعية”.
أما الأستاذ محمد قطب رحمه الله تعالى فإنه يفرق في التسمية بين نوعين من السنن الإلهية، وهي التي تحكم الحياة البشرية، والكونية- وهي القوانين الطبيعية التي تحكم المادة- وأن الانتظام والانضباط موجود في كلا النوعين بمرتبة واحدة. لكنه يرى أن القوانين الكونية قد يخرقها الله تعالى لحكمة يريدها- وكأنه بذلك يريد تفسير الخوارق والمعجزات-.
أما السنن الإلهية التي تحكم الحياة البشرية فقد ثبَّتها الله، ومن ثم فلا تخضع لهذا الاستثناء. كذلك يرى الأستاذ محمد قطب رحمه الله تعالى أن هناك سنناً جارية مطردة خاصَّة بالمؤمنين، وسنناً جارية خاصَّة بالكافرين، ولكنها أقل في مساحتها من السنن العامة، التي تجري على الجنس البشري بمؤمنيه وكافريه.
غير أن السُنَّة الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول هي سنن التاريخ والاجتماع، ومنها “سُنَّة الله” في نصر أوليائه، وخذلان أعدائه.
وهذه الحقيقة بالنسبة لهذه السُنَّة: موضع اتفاق وإجماع عند من تكلموا في هذا الموضوع- من المتقدمين، والمتأخرين-.
أما سنن الكون وطبائع الخلق: فإن الذين جعلوها مشمولة بـ “سُنَّة الله” التي لا تتبدل ولا تتحول- كسُنَّة التاريخ والاجتماع- فقد قالوا بلزومها وثباتها
لا نضو ا ئها تحت اللازم الثابت. غير أن بعضهم اضطر إلى تقييد ذلك بطلاقة المشيئة الإلهية ليفسر الاستثناء الذي يخرق السنن الكونية كالمعجزات، وربما اضطر البعض الآخر إلى التعسف في التأويل، أو إنكار المعجزات ليستقيم له ما ذهب إليه من اللزوم. وربما يرى آخرون أن التغيير والتبديل الخارق للسُنَّة دليل على أن السُنَّة لم تتحقق لفقد شرط، أو وجود مانع، ومن ثم فلم تكن سُنَّة لفوات الشرط، أو وجود المانع، كما أن هناك من يرى أن مثل هذه السنن تفيد العموم ولا تفيد اللزوم.
ومما يساعد على فهم “سُنَّة الله”- الاجتماعية والتاريخية- والتي يكون الإنسان عاملاً إيجابياً فيها: ملاحظة الفرق بين الإنسان الفطري كما خلقه الله، والإنسان المسلم المنضبط بشريعة الله، والذي تخضعه العقيدة الإسلامية إلى عملية شرطية من شأنها الحد من طغيان الغرائز وتنظيمها.
وفي هذه الحالة يتحرر المسلم جزئياً من القانون الطبيعي، ويتجه بالفائض من قوة الغرائز المنضبطة تجاه القيم الخلقية والمثل العليا، والتي تجعل لحياة المسلم هدفاً ومعنى، تهون في سبيله التضحيات، ويغدو المسلم بفضلها قوة تتجاوز المألوف من قوة الإنسان الطبيعي، وقد شرحنا هذه الفكرة فيما تقدم تحت عنوان “سنن الإنسان.. وسنن الإيمان”.
كذلك لابدَّ من الانتباه إلى أن الحياة البشرية تخضع لسنن كثيرة، وهذه السنن تتحقق وتنفذ من خلال عمل الإنسان طبقا للسُنَّة الإلهية العامَّة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ -الرعد: 11.
كما أن هذه السنن تتزاحم في عملها، وتتدافع طبقاً لعمل الإنسان، الذي يخضع أيضاً لعوامل ودوافع مختلفة. ومن ثم يتحقق من هذه السنن ما تكون له الغلبة على غيره، بناء على العامل والدافع الذي يتغلب في عمل الإنسان، كذلك تكون الأقدار في حال تنازع، طبقاً لتدافع السنن. ثم يتحقق القدر المترتب على السُنَّة الغالبة.
وهكذا فالسنن جارية لا تتخلف، وإنما يتغلب بعضها على بعض بحسب القوة والضعف، وقد شرحنا هذه الفكرة فيما سبق تحت عنوان ” تدافع السنن وتنازع الأقدار”.
وعلى الرغم من كل ما قيل في شأن السنن الكونية من لزوم أو عموم، فلابدَّ لنا من العمل على أساسها، ولا ينبغي لنا إهمالها بحجة عدم حتميتها وبخاصَّة إذا علمنا أن المعجزات التي تخرق السنن الكونية كانت استثناء في حياة الناس لإثبات النبوات، وأن النبوات قد انتهت بمجيء خاتم النبيين، مما يجعل مثل هذا الاستثناء غير وارد حاضراً ومستقبلاً، كما أن إهمال هذه السنن لن يؤدي إلا إلى فوضى وعدم استقرار. وإذا كان الإسلام يوجب العمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية فمن باب أولى أن يوجبه في السنن الكونية التي قلنا بأنها تفيد العموم ولا تفيد اللزوم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
(*)أستاذ التفسير وعلوم القرآن في عدد من الجامعات، وهذا المقال استكمال لدراسة طويلة نوالي نشرها في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى.
الهوامش:
(1) مسلم: 4/2118 كتاب التوبة: حديث 45.
(2) البخاري: 512- كتاب أحاديث الأنبياء- حديث رقم 3470 – وانظر مسند أحمد: 3/72.
(3) الحديث في البخاري كتاب التوحيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتاباً عنده: (غلبت وقال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش) وكذلك رواه مسلم في التوبة 14-16 وابن ماجه في الزهد، 35، وأحمد في المسند 2/242، وتكرر سبع مرات.
(4) مجمع الزوائد: 7/209، وكشف الأستار 3/29، وقال الهيثمي رواه البزار وفيه إبراهيم بن خيثم وهو متروك.
(5) مجمع الزوائد: 7/209، وكشف الأستار: 3/30، وفيه زكريا بن منظر وثقه أحمد ابن صالح المصري وضعفه الجمهور، ومما يجعل مثل هذا الحديث مقبولاً أن ما جاء به لا يمكن أن يكون للرأي فيه مجال
(6) الفتاوى 8/69-70 مع قليل من التصرف.




